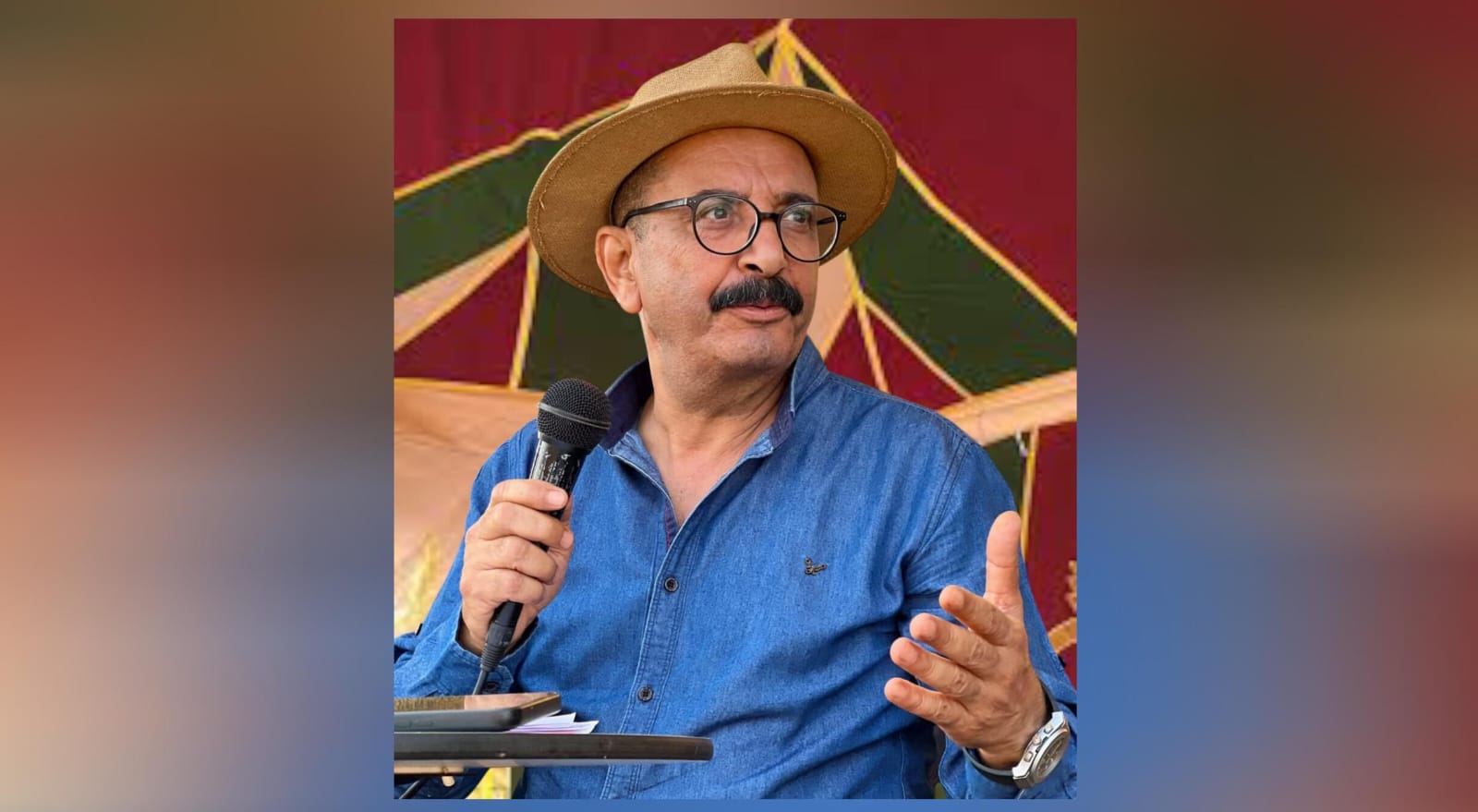تحتلّ "طنجة الدولية" مكانة مركزية وفريدة في المتخيل الثقافي المغربي والمتوسطي، حيث تُستدعى غالباً بوصفها لحظة ازدهار استثنائية، وفضاءً كونيّاً شكّل مختبراً قانونياً دولياً فريداً ومنبراً للحريات الفردية والأدبية التي سبقت زمنها ومحيطها. غير أن هذا التمثّل، الذي يتغذّى على خطاب نوستالجي متأخر، يميل إلى التركيز على البنية الفوقية للمدينة، ويغفل، عن وعي أو دون وعي، الشروط التاريخية والاقتصادية القاسية التي أنتجت هذا الواقع، كما يتجاهل كلفته الاجتماعية الباهظة على الساكنة المحلية.
تنطلق هذه المقالة من أطروحة مفادها أن طنجة الدولية، رغم جاذبيتها الكونية، لم تكن مشروع حداثة مندمجة أو نهضة حضرية شاملة، بل كانت نتاج اقتصاد تابع سبق في وجوده القانون الدولي وأنتج عملية محو اجتماعي ممنهجة؛ شملت المِلكية الصغيرة وأنماط العيش التقليدية والبنية الحِرفية العريقة، وأفضت في نهاية المطاف إلى صناعة بروليتاريا جديدة لم تكن معروفة في النسيج الاجتماعي للمدينة. ولإثبات هذه الأطروحة، دون السقوط في قراءة أحادية الجانب، نعتمد على تقاطع مصدرين متكاملين: التحليل السوسيولوجي المعاصر الذي قدّمه إدوارد ميشو بلير في كتابه المرجعي "طنجة ومنطقتها" (ترجمة رشيد العفاقي - عثمان بن شقرون- 2021) بوصفه رصداً من الخارج، والصحافة الوطنية والطنجية المغربية ممثّلة في كتابات عبد الرحمن اليوسفي ومحمد المهدي الزيدي ومحمد قاسم الدكالي (في جريدتي منبر الشعب والشعب اللتين صدرتا في طنجة من 1949 إلى 1953)بوصفها وعياً داخلياً مقاوماً لخطاب الازدهار المضل آنذاك.
ولكي تتضح جذور هذا المسار، لا بد من العودة إلى المرحلة السابقة على التدويل الرسمي، حيث بدأت ملامح الاختلال تتشكل بهدوء. قبل ترسيم النظام الدولي رسميًا باتفاقية 1923، كانت طنجة مدينة مغربية ذات وضع خاص نابع من موقعها الاستراتيجي عند بوابة مضيق جبل طارق، موقع جعلها منذ القرن التاسع عشر مجالًا لتقاطعات دبلوماسية وتجارية كثيفة. إلا أن هذا الانفتاح لم يكن يعني اندماجًا في اقتصاد رأسمالي صناعي بالمعنى الحديث، فقد كان النسيج الاقتصادي المحلي قائمًا على التجارة المتوسطية المحدودة والحِرف التقليدية والملكية الصغيرة الموزّعة بذكاء بين المدينة للسكن والتجارة وضواحيها للفلاحة المعيشية، بما يوفّر حدًا أدنى من الاستقرار الاجتماعي والأمان المادي.
وكان هذا النمط من العيش، وإن اتسم بالتواضع مقارنة بالبذخ الأوروبي اللاحق، يضمن استقلالًا ماديًا نسبيًا للأهالي، حيث كان العمل مرتبطًا بالملكية الخاصة أو الحرفة المتوارثة وليس بسوق العمل المأجور الخالص، وكان المواطن الطنجي "سيد وقته"، يعيش في ظل نظام "الستر" الذي يحميه من تقلبات الأسواق العالمية العابرة للحدود. إلا أن هذا التوازن الهش لم يصمد طويلاً أمام التحولات الجيوسياسية التي أعادت رسم موقع طنجة ووظيفتها. وقد شكّل مؤتمر مدريد سنة 1880 نقطة البداية الحقيقية لتدويل طنجة الفعلي، إذ أرسى إطار الامتيازات القنصلية ووسع نطاق الحماية الأجنبية، مما مهد الطريق للهيمنة الأوروبية على مفاصل الاقتصاد المحلي. إلا أن الانعطافة الحاسمة تجلت في مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906؛ فهذا المؤتمر لم يكتفِ بتنظيم التنافس الاستعماري، بل وضع الأسس المؤسساتية لما سيُعرف لاحقاً بالنظام الدولي، من خلال إنشاء البنك المخزني والشرطة الدولية والتحكم في الموارد الجمركية. لقد حوّل عام 1906 طنجة من مجرد ساحة للتفاوض إلى جهاز إداري عابر للحدود قلص تدريجياً سلطة المخزن المحلي لصالح القوى الأجنبية. وهكذا جاءت اتفاقية 1923 لتكون مجرد تقنين نهائي لوضع مؤسساتي واقتصادي كان قد اكتملت معالمه في الممارسة منذ مطلع القرن، مؤكدة أن طنجة كانت تعيش تدويلاً قسرياً قبل أن يصبح ذلك نصاً قانونياً رسمياً.
وفي هذا السياق التاريخي المأزوم يصبح التحليل السوسيولوجي المعاصر شاهدًا كاشفاً لا مجرد توصيف أكاديمي، ففي سنة 1921 نشر إدوارد ميشو بلير توصيفًا بالغ الدقة والحِدّة، حيث يضع إصبعه على جرح التبعية المطلقة التي سقط فيها المجتمع الطنجي، إذ يؤكد بصريح العبارة:
" تعتمد حياة الأهالي الاقتصادية اليوم في طنجة -بشكل كُلِّي تقريبا- على النشاط الكبير للحركة الاقتصادية الأوروبية. يمكننا أن نؤكد، بصريح العبارة، أنه لم تعد توجد في طنجة حياة اقتصادية حَصْرًا للأهالي. في الواقع، جميع الأعمال وجميع الصناعات بين أيدي الأوروبيين واليهود، في حين أن الأهالي المسلمين لا يلعبون فيها إلا دَوْرَ التّبعية."
وهو ما لا يصوّر مجرد خلل عابر بل يحيل إلى نظام بنيوي، حيث لا يشكّل النشاط المحلي محرّكًا ذاتيًا للتنمية، بل وظيفة هامشية ضمن منظومة موجّهة بالكامل من الخارج. ومع أن هذا التوزيع الطبقي يظهر كبنية صلبة احتكر فيها الوافدون مراكز التمويل، إلا أن الواقع السوسيولوجي كان أكثر تعقيداً؛ فقد عرفت طنجة فئات من الأعيان والتجار المسلمين الذين استطاعوا المناورة داخل النظام الدولي وتحقيق مكاسب معتبرة، كما لم يخلُ المجتمع الوافد من بروليتاريا أوروبية عانت هي الأخرى في قاع الهرم. غير أن هذا التداخل لا ينفي الحقيقة البنيوية الكبرى، وهي أن الازدهار لم يكن مشروعاً تشاركياً، بل كان هندسة قانونية وسياسية استندت إلى نظام الحمايات، مما خلق سوق عمل هرمية قوضت وهم التعايش الاقتصادي الذي تروج له النوستالجيا. وهذا الأمر يؤكد أن النظام الدولي لم يكن انقسامًا عرقيًا بسيطًا، بل ترتيبًا اقتصادياً هرمياً أعاد توزيع السلطة وفق منطق الحماية والامتياز لا وفق منطق الكفاءة أو المواطنة.
ويتكثف أثر هذه التحولات في المجال العقاري والاجتماعي، إذ يصبح العقار قلب عملية المحو الاجتماعي. ونقصد بالمحو هنا ليس الإبادة المادية، بل تفكيك شروط الاستقلال الاقتصادي وتحويل الفاعل المحلي إلى عنصر وظيفي داخل منظومة خارجية. فقد أدت المضاربات المرتبطة ببريق التدويل إلى تراجع الملكية الصغيرة واختفائها تدريجيًا. فالعقار هنا لا يمثل مجرد أصل اقتصادي، بل يمثل ذاكرة اجتماعية وفضاءً للسيادة اليومية؛ وحين يُنتزع، لا تُفقد الملكية فحسب، بل تُفقد القدرة على اختيار نمط العيش. وهنا يرصد ميشو بلير هذا التحول التراجيدي لنمط العيش:
" كان بإمكان كثير من الناس في طنجة قديما أن يعيشوا عن طريق امتلاك منزل صغير في المدينة، مع بستان في الضواحي وبضعة فدادين صالحة للزراعة في البادية القريبة. لقد كانوا بلا شك يحيون عيشة متواضعة، إلا أنهم مهما يكن الأمر كانوا يَحْيَوْن. هذا النمط من العيش لم يعد ممكنا... إن الارتفاع الكبير لقيمة العقارات حملت الملاك الصغار على بيع عقاراتهم التي كانت في ملكيتهم فعليا بعض الوقت... لقد نتج عن هاته البيوعات المطردة رفاهٌ مؤقّت، تلاه عوز كامل وإجبارية العمل من أجل العيش."
وعندما ابتلع السوق هذه الملكيات والمضاربة، أصبح العقار فخًا استُبدل فيه الاستقرار بالسيولة النقدية العابرة التي سرعان ما استُهلكت، تاركةً الأهالي بلا أرض ولا مال. ومن هذا التحول تنبثق النتيجة الاجتماعية الأشد قسوة، إذ يصف بلير تشكل طبقة عاملة مسحوقة لم تكن موجودة من قبل:
"لقد أدى التغلغل الأوربي في طنجة إلى خلق بروليتاريا لم تكن موجودة من قبل. بلا شك كان يوجد بها الأغنياء والفقراء، على شكل أرستقراطية وعمال، لكن هؤلاء العمال كانوا منظمين في تعاونيات، عليهم واجبات كما كانت لهم امتيازاتهم، فكانوا بمثابة بورجوازيين. اليوم... فإنّ القسم الأعظم من الساكنة كان عليه أن يضع نفسه رهن خدمة الأوروبيين."
ولم تتوقف الهيمنة عند الاقتصاد وحده، بل امتدت إلى المجال الرمزي والمعرفي؛ فقد سيطرت مدارس البعثات الأوروبية على المشهد التعليمي، كما ونوعا، منذ نهاية القرن التاسع عشر، وكانت معظمها موجّهة للأجانب أو لأبناء النخبة المرتبطة بالإدارة الدولية، وأدى هذا النظام إلى نتائج كارثية على النسيج الاجتماعي، إذ أنتج فوارق طبقية حادة. فالأهالي المسلمون الذين لم تتح لهم فرصة الالتحاق بهذه المدارس وجدوا أنفسهم عاجزين عن المنافسة في سوق العمل الحديثة التي خلقتها "الدولية"، بينما حصل خريجو البعثات على امتيازات واضحة.
ولم تكن هذه المدارس لتنقل المعرفة الأكاديمية فحسب بل رسّخت مركزية أوروبية في اللغة والفكر والإدارة، مما وسّع الفجوة بين النخبة المتفرنجة وبين عامة الساكنة التي ظلت متمسكة بهويتها التقليدية، وساهم التعليم بذلك في تحويل المغربي إلى موظف تابع في الماكينة الأوروبية، بدل تكوين طبقة وسطى وطنية قادرة على الدفاع عن مصالحها الاقتصادية المستقلة. وفي مواجهة هذه الهيمنة الأجنبية، لعب الوطنيون دورًا حاسمًا في تأسيس تعليم مغربي مستقل، فأنشأوا المدارس القرآنية والعربية التي ركزت على المعرفة الوطنية والهوية الثقافية، وحرصوا على تطوير برامج تعليمية تمكّن الأهالي من استعادة القدرة على المنافسة في سوق العمل الحديث، وجعلت من التعليم أداة للحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية والوعي الوطني.
لم يتوقف أثر اليقظة التي أحدثها التعليم الوطني عند حدود بناء الذات، بل سرعان ما تحول إلى قوة دفع سياسية وإعلامية قادرة على اشتباكٍ مباشر مع بنية النظام الدولي. ففي الوقت الذي كان فيه هذا النظام يحاول إعادة إنتاج نفسه وتجميل واجهته، برزت الصحافة الوطنية في طنجة كجبهة للمقاومة المدنية التي لم تكتفِ برصد المعاناة، بل انتقلت لتتبع مجمل قضايا النظام الدولي بوعي قانوني وميداني حاد. ويتجلى ذلك بوضوح في اهتمام الصحافة بمواكبة الجدل الدائر آنذاك حول التعديلات المرتبطة بنظام طنجة، ومراقبة مناقشات المجلس التشريعي ونشر مداولاته للرأي العام، في محاولة لكسر احتكار الإدارة الدولية للقرار.
وفي هذا السياق النضالي، خاضت الصحافة معركة مزدوجة؛ فمن جهة دافعت عن حق المغرب في التمثيلية داخل المحكمة المختلطة عبر مقالات الأستاذ عبد الرحيم اليوسفي حول الإصلاح القضائي (العددين 117 و118 من صحيفة الشعب) وافتتاحيات محمد قاسم الدكالي. ومن جهة أخرى، برز محمد المهدي الزيدي كصحفي مختص في الشأن المحلي، حيث مارس دوراً رقابياً محرجا عبر عموده الصحفي الذي تتبع فيه بدقة جرد إنجازات الإدارة الدولية لصالح الأهالي في شتى المجالات. لقد كانت كتابات محمد المهدي الزيدي تضع الإدارة الدولية أمام زيف ادعاءاتها التنموية، وتكشف الفجوة بين الوعود والواقع الميداني، لدرجة أن الإدارة كانت تُضطر مراراً للخروج ببيانات حقيقة للدفاع عن نفسها أمام الرأي العام. لقد نجحت هذه المبادرات مجتمعة في تحويل الصحافة إلى أداة للمقاومة الفكرية والاجتماعية، استطاعت ببراعة أن تربط بين مخرجات التعليم الوطني وبين تحول المجتمع المغربي نحو مقاومة التبعية وفضح آليات الاستلاب الدولية.
من هنا، تتقاطع هذه الزوايا المختلفة لتفكيك الأسطورة ذاتها؛ إذ يلتقي التشخيص السوسيولوجي البنيوي مع الرصد الصحفي للآثار اليومية والمقاومة القانونية للنخبة الوطنية، ليقدّم هذا التقاطع قراءة مزدوجة تُسقط أسطورة طنجة الدولية وتكشف عن وجهها الاستلابي. وما ينتهي إليه كل ذلك هو استعادة الذاكرة الجمعية من تحت بريق الدولية؛ فتظهر طنجة لا كتجربة حداثة مندمجة أو نموذجاً مثالياً للتعايش، بل كـمختبر مبكر لهيمنة اقتصادية أنتجت ازدهاراً خارجياً براقاً مقابل محو اجتماعي داخلي صامت. إن هذا البريق قام في جوهره على أنقاض نمط عيش أصيل، وكلفة اجتماعية باهظة تمثلت في تجريد الملاك والحرفيين الأحرار من استقلاليتهم وتحويلهم إلى بروليتاريا تابعة في مدينة لم تعد تشبههم، وهو ما يؤكد في النهاية أن استعادة التعليم الوطني والوعي الإعلامي كانا الأداة الوحيدة لاستعادة السيادة المعرفية والاجتماعية في مواجهة ماكينة المحو الدولية. فطنجة الدولية لم تكن وعداً بالحداثة بقدر ما كانت تمرينًا مبكرًا على تحويل المدينة إلى واجهة براقة تخفي اقتصادًا غير متكافئ، وهي تجربة تكشف أن الازدهار حين لا ينبع من الداخل يتحول إلى قشرة لامعة فوق بنية هشّة.