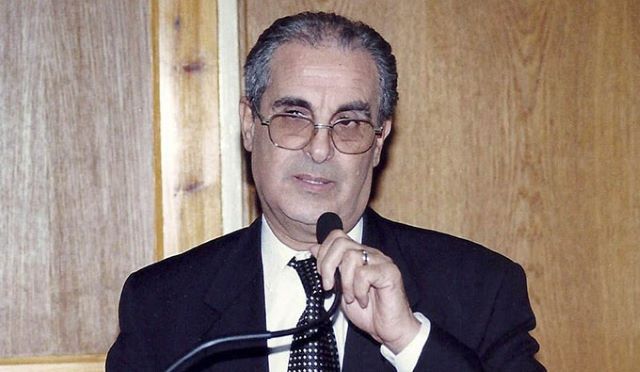وصفت الأستاذة فتيحة الطالبي المحامية بهيئة طنجة قرار رئيس الحكومة تأجيل إحالة مشروع قانون تنظيم المهنة (66-23) إلى البرلمان حتى "بلوغ توافق" مع جمعية هيئات المحامين، بأنه يثير إشكالا دستوريا عميقا، فبعد مصادقة المجلس الحكومي (الفصل 92 من دستور 2011)، يصبح المشروع ملزما للإيداع في البرلمان، دون إمكانية تعليقه خارج المسطرة الدستورية الواضحة.
لم يكن صمت رئيس الحكومة طوال أسابيع الاحتقان المهني موقفا عابرا يمكن تصنيفه ضمن الحياد المؤسسي، بل بدا أقرب إلى تراجع محسوب أمام تصاعد حراك مهني اتسم بالانضباط والصلابة. ففي الوقت الذي كانت فيه المحاماة المغربية تخوض إحدى أكثر لحظات تماسكها التاريخي قوة وتنظيما، موحدة الصف، واضحة المطلب، وحازمة في الدفاع عن استقلالها وكرامتها التشريعية، غابت رئاسة الحكومة عن واجهة النقاش، تاركة الأزمة تتفاعل دون مبادرة سياسية واضحة.
حراكنا لم يكن مطلبا فئويا ضيقا، بل كان تعبيرا عن وعي مهني عميق بأن استقلال المحاماة جزء لا يتجزأ من سيادة الدولة في إرساء عدالة متوازنة ومستقلة. لقد دافع المحامون عن سيادتهم المهنية باعتبارها امتدادا لسيادة الدولة المغربية في تحقيق عدالة حقيقية، لا تخضع لاختلال تشريعي ولا لارتجال مؤسساتي.
ثم فجأة، وفي توقيت يحمل دلالات سياسية واضحة، خرج أخيرا رئيس الحكومة بتاريخ 11 فبراير 2026 بإعلان تأجيل إحالة مشروع قانون تنظيم المهنة إلى البرلمان إلى حين “بلوغ توافق” مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب. تفاعل بدا وكأنه محاولة لاحتواء ضغط مهني متصاعد فرض منطقه بقوة التنظيم ووحدة الموقف. غير أن هذا الإعلان، وإن بدا في ظاهره تهدئة سياسية، يطرح في عمقه إشكالا دستوريا دقيقا يتعلق بحدود السلطة التقديرية للحكومة بعد استكمال مرحلة التداول والمصادقة داخل المجلس الحكومي.
فبمجرد المصادقة على مشروع قانون طبقًا للفصل 92 من الدستور، يخرج المشروع من دائرة النقاش الحكومي إلى المسار التشريعي الإلزامي، ويغدو جاهزا للإيداع لدى مكتب مجلس النواب. هذه المرحلة لا تعد خيارا سياسيا قابلا للتعليق، ولا تخضع لسلطة تقديرية مفتوحة تسمح بتجميد المشروع بداعي البحث عن توافق لاحق، ما لم يتم سحبه رسميا وفق مسطرة واضحة عبر الأمانة العامة للحكومة، ثم إعادة عرضه في صيغة معدلة على مجلس حكومي جديد.
الدستور لم ينص على آلية تتيح تعليق مشروع قانون تمت المصادقة عليه، ولم يمنح للحكومة صلاحية إبقائه في وضع معلق خارج المسار الإجرائي المحدد. ومن ثم، فإن أي التزام بالسعي إلى توافق، مهما كانت وجاهته السياسية، يظل في جوهره التزاما ذا طبيعة سياسية أو أخلاقية لا ينتج أثرا قانونيا إلا إذا تم تجسيده داخل القنوات الدستورية الواجبة الاتباع.
وتزداد الصورة حساسية في ظل غياب بلاغ رسمي مفصل أو وثيقة مؤطرة تحدد مضمون التفاهمات المعلن عنها، ونطاقها، وضماناتها. فالمؤسسات في دولة القانون لا تدار بالتصريحات، بل بالمحاضر والقرارات المؤطرة قانونا.
كما يستحضر الجسم المهني تصريح وزير العدل خلال الجلسة الوطنية للتمرين ببوسكورة، حين أكد أنه لن يدرج مسودة المشروع ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي إلا بعد بلوغ توافق مع جمعية هيئات المحامين. غير أن عرض المشروع دون تحقق هذا التوافق أفرز أزمة ثقة حقيقية، وأعاد إلى الواجهة إشكالية الالتزام السياسي حين ينفصل عن ضماناته الإجرائية.
إن جوهر الإشكال اليوم لا ينحصر في مبدأ التشاور، بل في مسألتين جوهريتين: أولهما إعادة بناء الثقة بين السلطة التنفيذية و مهنة المحاماة بعد تجربة أضعفت منسوب الاطمئنان إلى التعهدات غير المؤطرة؛ وثانيهما تحديد الحدود الدقيقة للسلطة التقديرية للحكومة بعد استكمال المصادقة، بما ينسجم مع مبدأ سمو الدستور وربط المسؤولية بالمشروعية.
فالدولة الدستورية لا تدار بردود الفعل ولا بمنطق امتصاص الضغط، وإنما باحترام المساطر وتقييد السلطة بالنص. الشرعية لا تُستمد من الإعلان السياسي، بل من الانضباط الصارم لقواعد الدستور. وعندما تحترم هذه القواعد، تستقر المؤسسات؛ وعندما تؤجل خارج إطارها، يبدأ الجدل حول حدود المشروعية.