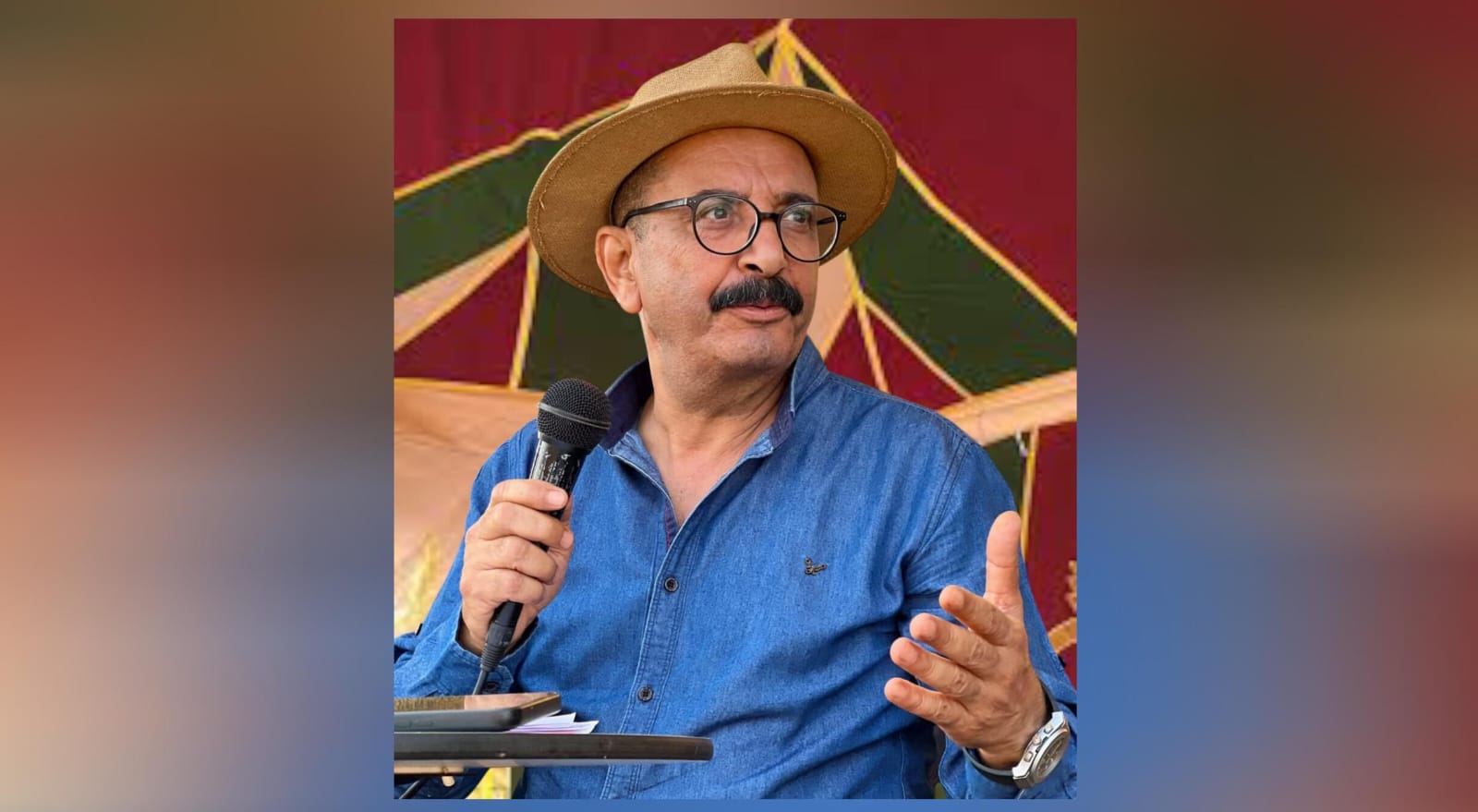أن تكون يسارياً اليوم يعني القطيعة مع الأساليب التي وُظِّفت في مراحل سابقة، وإعادة معارضة التراتبية الطبقية التي يحاول النظام العالمي الجديد فرضها، معارضة واعية بالأدوار الجديدة لليسار وتموقعه التاريخي إلى جانب المهمشين والمنبوذين والمحشورين في أسفل هذه التراتبية. وعي طبقي يفترض انخراطاً عضوياً في معارك الفئات التي يقصيها هذا النظام نحو الهامش الاجتماعي والاقتصادي.
أن تكون يسارياً اليوم، يعني أنك ماركسي يعيد إحياء الماركسية بوصفها وصفة نقدية ومشروع انقاد تاريخي للبؤساء المستغلين المطحونين وليست عقيدة جامدة، ان تستثمر كفاءتك النضالية وكفاءة رفاقك في تغيير تراتبية العالم، في مرحلة تاريخية أصبحت فيها الرأسمالية طورا متقدما من أطوار تطور أنماط الإنتاج. ومن هنا يبرز السؤال الجوهري: كيف يمكن للمناضل/المقاول/ الفاعل الماركسي أن يقود المرحلة المقبلة والمأمولة لتكسير تراتبية العالم القديم؟
اليساري اليوم يُنظر إليه بوصفه أمل البشرية في الخروج من نظام التراتبية الطبقية والاستغلال والحرمان الاجتماعي والتفقير الممنهج، كما يُنتظر منه أن يكون واجهة أخلاقية وطهرانية في مواجهة تسليع الإنسان والعلاقات الاجتماعية والثقافية والسياسية. وهو مدعو إلى التفكير مع الطبقات المطحونة من مهمشين وعاطلين وعمال يشتغلون في شروط لا إنسانية، في بناء علاقات إنسانية بديلة، تتجاوز منطق الاستغلال، كأطروحة انتقالية تسبق نضوج شروط الدولة الاشتراكية.
وفي الآن نفسه، يظل اليساري مطالباً بالدفاع عن حقوق الطبقة الوسطى وإدماجها في مشروع الكفاح البروليتاري، باعتبارها فاعلاً اجتماعياً بات هو الآخر يدفع كلفة الرأسمالية المتوحشة. فدور اليساري في هذه المرحلة يختلف جذرياً عن دور السياسي الرأسمالي الذي ينشغل بإعادة إنتاج الثقة المؤقتة، وتأجيل الحاجة إلى التغيير الجذري، وضبط حركية السكان بين فضاءات العمل والاستهلاك، وتشجيع الاستغراق في الفرجة التلفزيونية وثقافة الادخار الفردي.
في هذه المرحلة، ينظر الرأسمال إلى اليساري كمقاول أفكار وقيم، يُراد توظيفه في ضبط العيش المشترك وتدجين المجتمع سياسياً. غير أن نظرة اليسار إلى الرأسمال ما تزال قائمة على ثلاث مسلمات: أولاً، اعتباره مرحلة تاريخية ضرورية في تطور أنماط الإنتاج، تستدعي الحضور النقدي والرقابي لليساريين حتى لا تنزلق إلى أقصى درجات التوحش والاستنزاف. ثانياً، كونه مرحلة لا بد من تجاوزها نحو نظام يضع حداً للاستغلال والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، ويؤطر سيادة الطبقة العاملة في تدبير فائض القيمة. ثالثاً، ضرورة استفادة المجتمع الاشتراكي المأمول من دروس التجارب الاشتراكية السابقة التي لم يُكتب لها الاستمرار.
وعليه، فإن الصراع اليساري مع الرأسمال اليوم يقتضي رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تراهن على العيوب البنيوية لهذا النظام، والمتمثلة في تركيزه المفرط على مراكمة فائض القيمة لفائدة الطبقة المالكة، وتعميق استغلال غير المالكين، واستنزاف البيئة. فالرأسمالية لن تسقط تلقائياً بفعل تناقضاتها، بل تحتاج إلى فعل سوسيولوجي منظم وإرادة جماهيرية واعية، تُترجم عبر الاحتجاج والمشاركة الديمقراطية في دعم قوى سياسية تحمل مشروعاً تدبيرياً يحد من بشاعة هذا النظام.
المشروع التدبيري الذي يُفترض أن يحمله المناضل اليساري اليوم ويدافع عنه، يتمثل في سنّ قوانين وإجراءات تضمن العدالة الاجتماعية والمساواة، من خلال إعادة توجيه فائض القيمة نحو صناديق التماسك الاجتماعي، وبرامج ابتكارية تكثف الإنتاج مع ضمان استدامة العنصر البشري وحماية البيئة. ولا يمر هذا المسار عبر اشتراكية التأميم، بل عبر تقوية الأدوار الرقابية والتأطيرية للدولة، وإرساء نظام ضريبي عادل يحد من الاستهلاك الترفي، من خلال فرض ضرائب على الثروة والرفاهية، وضرائب تعويضية عن فقدان العمل الناتج عن الروبوتيزم والمكننة.
كما يتمثل دور اليساري اليوم في إجبار النظام الرأسمالي على التراجع عن موجة تسليع الخدمات الأساسية، عبر تعميق النقاش حول مفهوم هذه الخدمات وضمان حق الولوج إليها للجميع. ويتعلق الأمر بالمرافق العمومية الضرورية للعيش المشترك، كالتنشئة الاجتماعية، والتكوين، والصحة، والماء، والغذاء، والأمن. وهو ما يستدعي وضع معايير علمية تفصل بين الخدمات غير القابلة للتسليع وخدمات السوق الخاضعة لمنطق الربح.
من طبيعة الحال، فإن ضمان هذه الخدمات يفترض وجود مقاول عمومي يتكفل بالحد الأدنى من الخدمة وتطويرها، وابتداع آليات تمويل مستدامة، عبر إحداث أجهزة مالية مخصصة للخدمة الشاملة. ومن هنا يتضح أن المناضل اليساري مطالب، أكثر من أي وقت مضى، بتعميق تفكيره والحفاظ على يقظته، من أجل البقاء إلى جانب الطبقات المستضعفة والطبقة الوسطى معاً، وتقديم تصور اقتصادي متكامل يخدمها، قوامه اقتصاد اجتماعي تضامني يشجع الإنتاج التعاوني لفائدة صغار الفلاحين والمهنيين والحرفيين، ويدعم الأسواق البديلة للمنتوج التعاوني.
إن التشخيص الملموس للواقع، وإعداد رؤية مستقبلية قابلة للتحقق، يستدعيان العودة إلى الجذور التاريخية لليسار منذ 1789، حين اختار نواب معارضو الملكية المطلقة الجلوس يسار رئيس الجمعية الوطنية، رافعين شعارات الحرية والإخاء والمساواة، ومؤسسين لاحقاً للعلمانية وحماية البيئة. وقبل ذلك المرجعية اللينينية لتحقيق الرؤية الماركسية، كما لا يمكن إغفال مقولة جون جوريس الشهيرة التي شبّه فيها ظهور الاشتراكية بوحي ديني كبير جاء لإنقاذ الطبقات المقهورة.
ورغم إجماع اليسار على الاشتراكية كأفق تحرري، ظل الخلاف قائماً حول سبل الوصول إليها، بين من راهن على الثورة ودكتاتورية البروليتاريا، ومن اختار الإصلاح الديمقراطي واحترام الحريات. وهو خلاف بلغ ذروته في مؤتمر تور سنة 1920، حيث انقسم اليسار بين تيار ثوري متأثر بالثورة الروسية، وتيار ديمقراطي واصل نضاله إلى أن بلغ السلطة سنة 1981، قبل أن يواجه الطرفان معاً صدمة انهيار النموذج السوفياتي وتداعياته.
اليوم، يعيش اليسار مرحلة قطيعة وإعادة بناء، في ظل عجزه عن تقديم نموذج بديل متماسك للدولة الاشتراكية. غير أن هذه القطيعة لا تعني التحول إلى مجرد فاعل إصلاحي يلهث وراء البقاء السياسي، بل تقتضي الحفاظ على استقلالية اليسار كفضاء للنقاش والتأطير، والعمل الجماهيري الواعي لمواجهة التوجيهات الرأسمالية المتوحشة.
إن القطيعة المطلوبة اليوم هي تجديد المشروع اليساري، انطلاقاً من الإرث النظري لماركس وإنجلز وجوريس ولينين، مع وضع الإنسان في صلب هذا المشروع، وتحريره من كل أشكال الاستغلال والتمييز. كما تقتضي الوفاء للقيم اليسارية التي تجعل من اليساري قدوة أخلاقية ومثقفاً عضوياً منخرطاً في قضايا عصره، يجمع بين الاستقلال الفكري والالتزام التنظيمي.
وأخيراً، فإن تبني الواقعية النقدية، والاستفادة من أخطاء اشتراكية التأميم، والانفتاح على تجارب جديدة، يفتح أفقاً لاشتراكية إنسانية عادلة، قادرة على التفاعل مع تحديات العولمة والتحرير الاقتصادي، في أفق عالمي يأخذ بعين الاعتبار تجارب أمريكا اللاتينية وإفريقيا، ويعيد طرح السؤال الاشتراكي بوصفه أفقاً لتحرير الإنسانية جمعاء