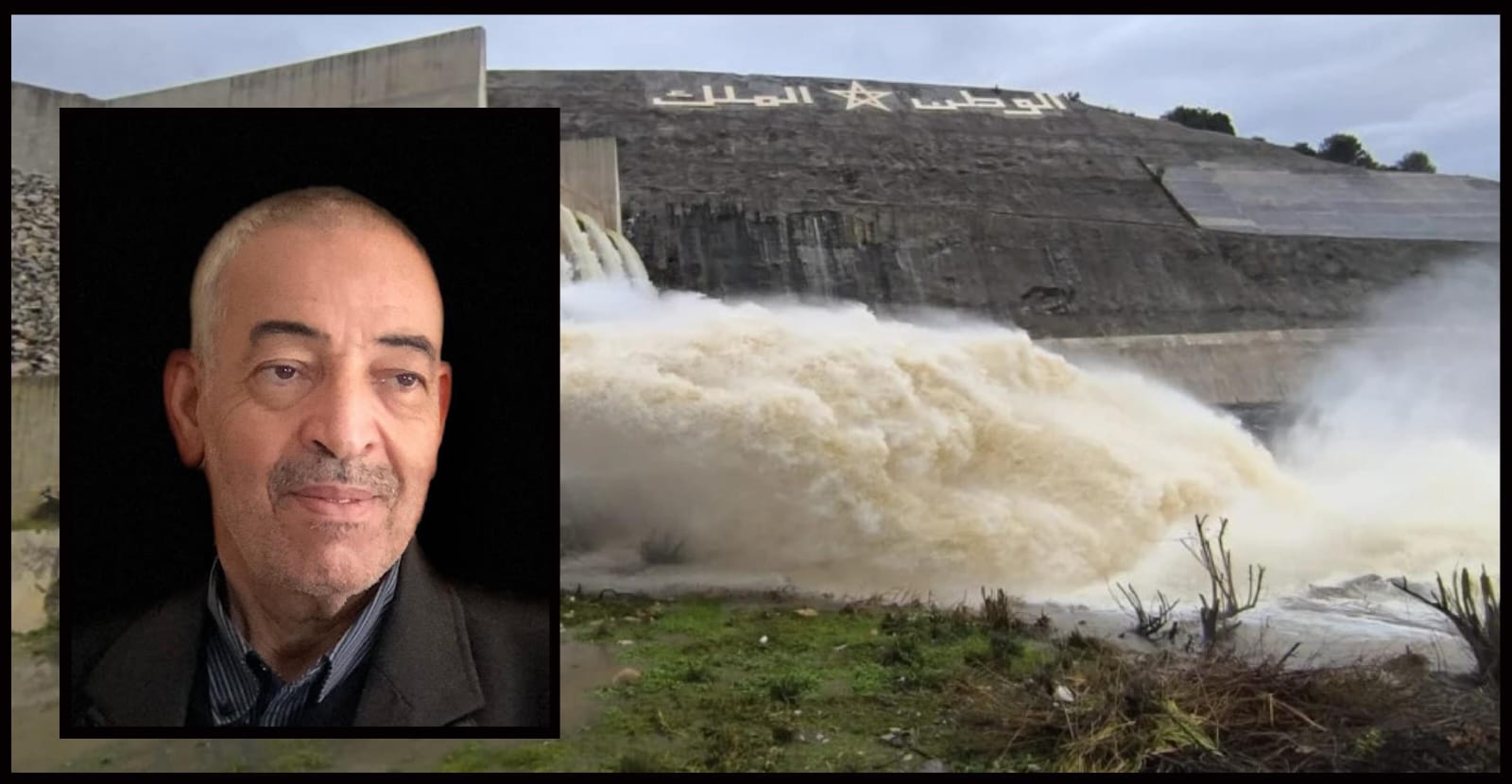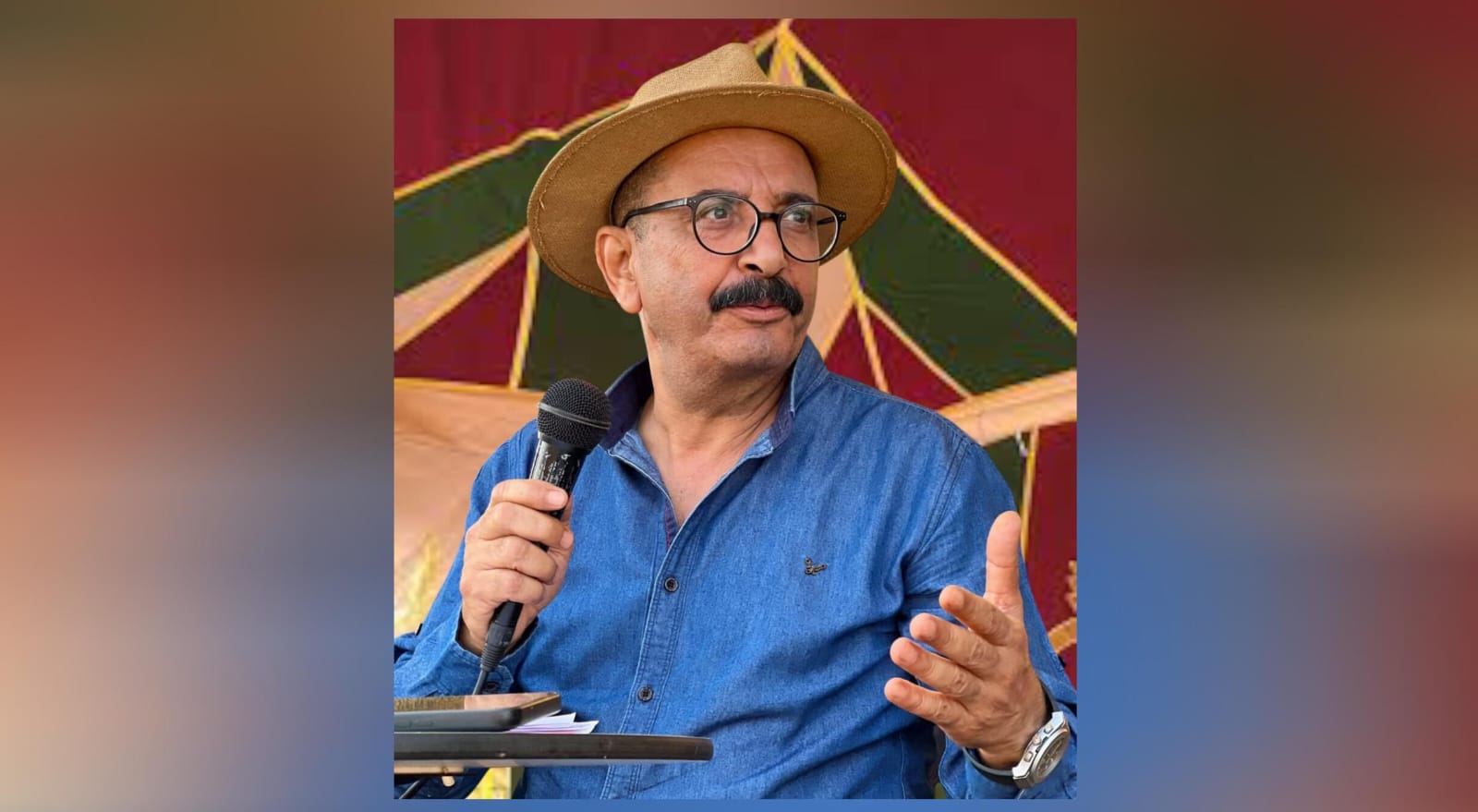يرى عبد الرحمان الحرادجي، أستاذ الجغرافيا بجامعة محمد الأول بوجدة – سابقا، أن أطرافا ما أخطأت في تقدير الوضع بدقة بحوض اللوكوس مما أدى إلى عدم اتخاذ القرارات الناجعة لتجنيب المدينة الكارثة أو تخفيفها على الأقل، مشيرا بأن تدبير الفيضان ليس بالأمر الهين، إذ يقتضي السهر على التوازن بين حماية السكان والمنشآت من الأضرار وبين المحافظة على الماء من الهدر بتخزينه وعدم صرفه نحو البحر، داعيا الى الابتعاد عن المواقع المنخفضة على مستوى الاستيطان.
ماهي الأسباب التي أدت الى تجاهل مخاطر واد اللوكوس من طرف السلطات العمومية التي تعرف أن مدينة القصر الكبير تقع في منخفض سهلي معرض للفيضانات ومع ذلك لم يتم اتخاذ الإجراءات الحمائية؟
ربما من الصعب الحديث عن التجاهل، وأعتقد أن الأمر يتعلق بسوء تقدير مخاطر الفيضان وضعف تدبيرها. هناك دراسات، بل هناك المعيش وهناك أرشيف تاريخي هام يسرد وقائع فيضانات بالمنطقة، تعد بعدة عشرات المرات وإن بدرجات متفاوتة من حيث الحدة والخطورة والأضرار. وسوء التقدير سيبقى مستمرا ما دامت هناك تصورات غير مكتملة عن ظاهرة الفيضانات. فالاهتمام ينصب عادة على المناخ وأحوال الطقس بقياس غزارة الأمطار وقوة صبيب وادي اللوكوس الذي يخترق المنطقة، والبناء في المنخفضات وفي السهول المعرضة للغمر. وهناك من يضيف تأويلات تربط الكارثة بالتعرية النشيطة في حوض الوادي بعالية المدينة والتي توفر واردات من الحمولة الصلبة تخنق المجرى... لكن ثمة عامل رئيس قلما يتم الانتباه إليه وهو الطبيعة التضاريسية للمكان «الشكل والمرفودينامية». فمدينة القصر الكبير تقع عند مخرج وادي اللوكوس من منطقة شديدة التضرس بتلالها المجزأة بتكويناتها الصخرية ضعيفة النفاذية، إلى سهل فيضي شديد الانبساط، بل شبه مستو بارتفاعات تقل عن 20 متر على مستوى سطح البحر الذي يبعد بحوالي 30 كيلومترا، مما يمنح للجريان المائي انحدارا أقل بكثير من درجة واحدة، بل أقل من نصف درجة، مما يعطل قوة الجاذبية ويبطئ عملها في التصريف. صحيح أن هناك سد وادي المخازن يقع قريبا في عالية المدينة، لكن هناك بعض الأحواض المجاورة له لا تصب فيه، يمكنها أن توفر واردات مائية كبيرة للسهل تحت الأمطار الوابلية أو الغزيرة باستمرار هطولها لفترة زمنية طويلة. فالمشكل يكمن في سرعة وصول الواردات من تلال كتيمة وشديدة الانحدار وصعوبة تصريفها نحو البحر من سهل بانحدار شبه منعدم. النتيجة تكون حتما هي ارتفاع منسوب الماء في المجرى الاعتيادي ليفيض ويغمر المجرى الاستثنائي والذي يسمى أيضا مجرى الفيضان وهو ليس سوى السهل. وهنا لابد من الإشارة إلى أن العبارات المتداولة من قبيل «خرجت المياه من مجاريها» و«تحولت الشوارع إلى أنهار»... تعابير غير صحيحة، بل تحمل في طياتها مغالطات. لم يسبق لواد أن خرج من مجراه، إذ الحقيقة هي أنه يفيض عند الضرورة من مجراه الاعتيادي الذي لا يستوعب صبيبه المرتفع ليحتل ماؤه مجراه الاستثنائي. أما تحول الشوارع إلى مجارٍ، فالعكس هو الصحيح، إذ كانت في الأصل مجارٍ مائية احتلها الإنسان وحولها إلى شوارع وغيرها من المرافق والبناءات والحدائق... فعندما تزورك المياه الجارية في مكان ما فاعلم أنها تحمل إليك رسالة تقول: "ارحل، فالمكان ليس لك...". فكم من مجار هامدة تستفيق من حين لآخر لتذكرنا بـ "وعائها العقاري".
وفيما يخص اتخاذ الإجراءات الحمائية، يصعب اتهام السلطات العمومية بعدم اتخاذها، إذ يبدو أن أطرافا ما أخطأت في تقدير الوضع بدقة ولم تتخذ القرارات الناجعة لتجنيب المدينة الكارثة أو تخفيفها على الأقل. ونحن نعلم أن بلدنا يتوفر على كفاءات وخبرات ودرايات ومصالح إدارية وتقنية تسهر على سلامة المواطنين والمنشآت، لكن بالرغم من ذلك تحدث كوارث بعضها طبيعي وبعضها ناتج عن التقصير. ولا نحتاج هنا إلى التذكير بحدوث هذه الكوارث حتى في أرقى دول العالم وأقواها من حيث الإمكانيات على مستوى الوسائل والتدخل والتدبير. وأساس النجاعة هو فهم الوضع قبل اتخاذ القرارات.
ما هو المطلوب لحماية حوض اللوكوس من الفيضانات وهل يمكن القول إن سد وادي المخازن لم يعد يؤدي الوظيفة المنوطة به أم يعود الأمر الى عدم إدارة المخاطر بشكل جيد؟
سد وادي المخازن يؤدي الوظائف التي أنشئ من أجلها، وهي توفير مياه السقي للسافلة «سهل اللوكوس» وتوفير ماء الشرب للمدن والمراكز المجاورة والبعيدة، بالإضافة إلى تدبير مخاطر الفيضان. وتدبير الفيضان ليس بالأمر الهين، إذ يقتضي السهر على التوازن بين حماية السافلة بسكانها ومنشآتها من الأضرار وبين المحافظة على الماء من الهدر بتخزينها وعدم صرفها نحو البحر. لكن الواردات المائية قد تفوق الطاقة الاستيعابية لحقينة السد (773 مليون متر مكعب) كما حدث مؤخرا إثر هطول أمطار وفيرة، ربما كان الهاجس هو الاحتفاظ بها ونحن تحت صدمة عدة سنين من الجفاف الحاد، مخافة ألا نكون قد خرجنا منه بعد. لكن تقديرات الرصد الجوي تشير إلى استمرار الموسم المطير، مما يجعلها أصلا بمثابة إنذار مبكر بضرورة تفريغ جزئي كبير للمخزون، حماية للسد نفسه من قوة ضغط الواردات على الحقينة الممتلئة من ناحية، وحماية للسافلة من صبيب اضطراري محتمل يفوق القابلية للتحمل من ناحية أخرى. فهذه الحسابات لا يمكن أن تغيب عن المسؤولين، لكن بعض التقديرات قد تفشل إما بعدم اتخاذ الإجراءات الضرورة أو فقط بعدم أجرأتها في الوقت المناسب وبالوتيرة المناسبة. وهكذا أضيف صبيب التفريغ إلى صبيب المجاري المجاورة، دون أن ننسى الأمطار التي تهاطلت على السهل نفسه.
فإدارة المخاطر حقل معرفي تتداخل وتتكامل فيه علوم مختلفة، من أجل تدبير سليم قدر الإمكان. لكن في بعض الأحيان تغيب بعض التخصصات والمعارف أو يتم تغييبها أو تعوض بخبرات زائفة، فيفتقر العمل إلى النجاعة. فالطقس والمناخ اللذان يشكلان مصدر الواردات المائية المسببة للفيضانات يشوب المعارف المتداولة بشأنهما الكثير من اللغط.
ما موقع المناخ فيما حدث ويحدث من فيضانات استثنائية، سيما بعد جفاف استفحل لعدة سنوات؟
موقع المناخ أساسي بالنسبة للفيضانات، ليس بالضرورة من حيث رطوبتُه، وإنما من حيث نظام التساقطات. فبلادنا تتدرج فيها النطاقات المناخية من النطاق الصحراوي «مفرط القحولة» جنوب جبال الأطلس، إلى النطاق شبه الرطب «رطوبة ملحوظة، لكن مع وجود فصل جاف يسِمُه العجز المائي» في الكتل التضاريسية المرتفعة مع وجود «جزر» من النطاق الرطب في أجزائها العليا، ولاسيما في الأطلس المتوسط والأطلس الكبير والريف، مرورا بالنطاقين القاحل وشبه القاحل.
ومناخ المغرب تتصارع فيه مؤثرات من صنفين متجاورين وهما المناخ شبه المداري «المتوسطي عموما» والمناخ المداري «الصحراوي عموما». وهنا ينبغي تسجيل هيمنة طابع القحولة على مناخ بلدنا، وقوامها العجز المائي المستديم أو الموسمي، مع سمة أساسية وهي عدم الانتظام. وتتجسد هذه السمة في التغايرية الطبيعية للمناخ «وليس التغير المناخي» تعبر عنها التقلبات في الحرارة وفي التساقطات، على المدى القصير «الفصلي» كما على المديين المتوسط والطويل «سنوات وعقود، بل وقرون».
عشنا فترات جفاف ولعل أبرزها لجيلنا هي الفترة الحالية التي امتدت لحوالي سبع سنوات كسرها الموسم الحالي بأمطاره الغزيرة وثلوجه الوفيرة ورياحه القوية وبرودته الشديدة ولفترة ليست قصيرة، كما عاش آباؤنا وأجدادنا فترات تقلبات مماثلة. والذي ينبغي التنبيه إليه مما يروج في ساحة التأويلات و«الخبرات» هو تطاول العديد من الأصوات على هذا الحقل المعرفي للإدلاء بتصريحات تكون أحيانا مجانبة للصواب. فكثير من النشطاء والكتاب والصحفيين والسياسيين وغيرهم، يتحولون إلى «خبراء» ليفسروا الظواهر المتطرفة بتغير المناخ والاحتباس الحراري وغازات الدفيئة المنبعثة من الأنشطة البشرية وعلى رأسها ثنائي أكسيد الكربون والميثان... ونسمع عن هذه الظواهر الاستثنائية بأنها غير مسبوقة، وما إلى ذلك من الاجتهادات غير المبنية لا على فهم صحيح ولا على برهنة ولا على دراية تخصصية.
فعبارة «غير مسبوق» لا تصح في المناخ، إذ المناخ الذي نعيش فيه ليست بدايته هي عصر الثورة الصناعية، وإنما يمتد بجذوره قرونا، بل بضعة آلاف من السنين حدثت خلالها كل الظواهر التي نعيشها، وبدون انبعاثات للغازات الدفيئة وبدون ثورة صناعية ولا وقود أحفوري. أما التغير المناخي «بتزايد غازات الاحتباس الحراري» فلا يستطيع تفسير ظاهرة وتفسير نقيضها في آن واحد «جفاف\فيضانات؛ احترار\تبريد». الغازات الدفيئة المنبعثة من الأنشطة البشرية تزايدت عمليا نسبة تركزها في الجو بما قدره النصف (50 %) منذ الثورة الصناعية، لكن «معدل» حرارة الغلاف الجوي للكرة الأرضية لم يرتفع سوى بحوالي درجة مئوية واحد أو ما يزيد عنها قليلا. فهذا الاحترار لا تفسره الانبعاثات وحدها، كما أنه لم يتعدّ عتبة التغايرية الطبيعية.
ما يحدث من غزارة في التساقطات نتجت عنها فيضانات في القصر الكبير وغيرها من المدن والقرى ينبه إلى الاستيطان في المواضع غير الملائمة، مما يستدعي مراجعة عطوبية الأماكن في مواجهة العوارض الطقسية الاستثنائية «التي هي جزء من المناخ». وينبغي استيعاب طبيعة هذه الظوهر بأنها احتمالية عشوائية، تحدث بلا قاعدة ولا انتظام، مثلها مثل الجفاف الذي يأتي كذلك بلا انتظام ولا تنبؤ، له بداية ونهاية، وليس محطة من محطات يوصل إليها التغير المناخي في خطابات تهويلية.
كما نسمع كثيرا عن الجفاف بأنه «أصبح ظاهرة بنيوية» وهذه رؤية مجانبة للصواب، لسبب بسيط وهو أنه كان دائما كذلك. ونجد في أرشيف البيئات القديمة ما يدل على حدوث تقلبات مماثلة بتأثير العوامل الطبيعية، والتي تعتبر المحرك الرئيس لدينامية المناخ.
ما هو المطلوب لضمان عدم تكرار ما وقع أو على الأقل التقليل من حدته في حالة وقوعه مرة أخرى؟
المطلوب في هذا الشأن هو الابتعاد عن المواضع المنخفضة على مستوى الاستيطان، علما بأن السهل كانت تنتشر فيه المستنقعات إلى عهد قريب قبل بناء السد عام 1979، واحتواء مجرى النهر قدر الإمكان وتشييد المزيد من السدود والسدود التلية في كل الأحواض التي تتوفر على مواضع ملائمة، إضافة إلى تجويد مبادرة الربط بين الأحواض المائية لتشتغل ليس فقط في حالات الندرة وإنما أيضا لتدبير الوفرة تجنبا للهدر المائي نحو البحر وتفاديا للضغط على السدود وعلى سافلاتها.