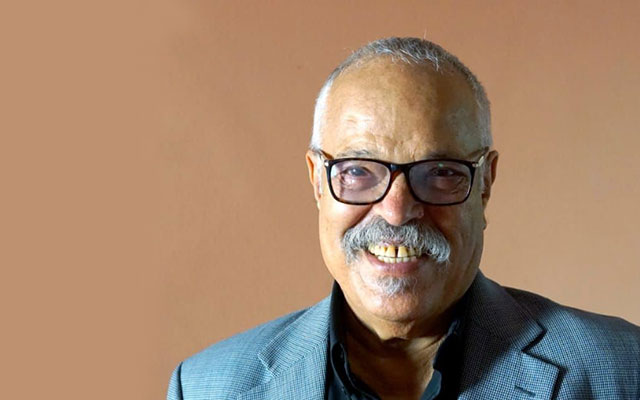هذا العنوان عبارة كان مارتن هايدغر افتتح بها أحد دروسه عن أرسطو مجملا كل ما يمكن أن يقال عن شخص المعلم الأول وعن حياته تقديما لفلسفته، كي يتفرغ للخوض فيها هي نفسها.
نعلم أن العبارة غدت عند البعض، فيما بعد، شعارا لمنهج تأريخ الفلسفة، وتعبيرا عن اتجاه في ذلك التأريخ يقتصر على الاهتمام بالنص، من غير محاولة لإلقاء الأضواء عليه باللجوء إلى حياة الفيلسوف والاسترشاد بوقائعها، والبيئة التي نشأ في حضنها.
ما زلت أذكر أننا، عندما كنا في مستوى الدراسة في الثانوي، كنا، قبل قراءة قصيدة، أو دراسة نص، نبدأ الدرس بعبارة "ترجمة الشاعر" أو "أعمال الكاتب وحياته". كما أذكر وقتها سلسلة كتب كانت تأتينا باللغة الفرنسية تحت عنوان "حياة المفكر وأعماله". كان المنهج السائد وقتها، سواء دراسة أو تدريسا، يعتبر أن دراسة المؤلف لا بد وأن تتقدمها معرفة حياة صاحبه، وكذا خصائص البيئة التي نشأ في حضنها، وقد كان أساتذتنا غالبا ما يتوقفون عند عرض حياة الشاعر والحديث عن بيئته، أكثر مما كانوا يتوقفون عند القصيدة ذاتها، هذا إن لم يستغنوا عن ذلك التوقف بالمرة.
نحن نعلم أن هذا المنهج عمّر طويلا، وترسخ عند أغلب الدارسين ونقاد الأدب ومؤرخي الفلسفة. وقد كان يجد أساسه في "نظرية الإشراط" والتسليم بأن النص يتحدد بخارجه لأنه "ابن بيئته"، ولأن كل مولد يدين لحياة صاحبه ومكان ميلاده والبيئة التي ترعرع فيها، وأن معرفة هذه البيئة هي الكفيلة بأن "تفسر" ما يتولد في حضنها.
منذ ظهور المد البنيوي، وسيادة "النزعة النصية" التي كانت ترفع شعار: "النص ولا شيء غير النص"، ومنذ ذيوع فكرة "موت المؤلف"، لم يعد الاهتمام ينصب أساسا على حياة صاحب الأعمال لفهم أعماله وتفسيرها. وقد خاض مؤرخو الأفكار جدالات واسعة فيما يتعلق بهذه المسألة التي اشتهرت بقضية "النشأة والبنية" (Genèse et structure) حيث تواجه من يقولون بضرورة الانفتاح على التطور التاريخي عند دراسة الأفكار وتحليل النصوص، ومن ينادون بالتوقف عند بنيتها، والعلاقات الداخلية التي تربط أجزاءها.
وهكذا فقد اعترض بعضهم على ما ذهب إليه هايدغر، فارتأى أننا، حتى إن سلمنا بأن عبارته قد تصدق على أرسطو، فإننا سنجد صعوبة كبرى في تطبيقها على فلاسفة آخرين ممن كانت حياتهم الشخصية جزءا لا يتجزأ من فلسفتهم، أمثال نيتشه وكيركيغورد وباسكال وسبينوزا وروسو. بل إننا لا نستطيع أن نتبناها حتى فيما يخص هايدغر نفسه. فمن المعروف أن جل الدارسين لفلسفته ما فتئوا يولون عنايتهم لحياة الفيلسوف الألماني، فلا يكتفون بالحديث عن خلوته في "الغابة السوداء"، بل يطرحون الأسئلة تلو الأخرى عن علاقته بالنازية، ويتوقفون بشيء من التطويل عند خطابه بمناسبة تنصيبه عميدا للجامعة. ولعل هذا يصدق على كثير من الفلاسفة غيره: فهل يمكننا أن نتحدث عن غارودي ولوفيفر وسارتر وميرلوبونتي وألتوسير من غير أن نأخذ بعين الاعتبار علاقتهم بالحزب الشيوعي الفرنسي؟ وهل يمكننا أن نتحدث عن المدرسة النقدية الجديدة في ألمانيا من غير أن نولي اهتماما للفترة الزمنية التي ظهرت فيها؟ وهل بالإمكان التعرض لشيوخ الفلاسفة الألمان دون ربطهم بأحداث الثورة الفرنسية؟ وهل نستطيع أن نفهم ميلاد الاتجاه الوضعي، قديمه ومحدثه، من غير ربطه بتطور العلوم وازدهار المنطق الرياضي؟
قبل محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة، لا بد أن نميز بين أوجه عدة لربط حياة الفيلسوف بأعماله: فقد يقتصر الأمر على ذكر وقائع حياته، لكننا قد نذهب أبعد من ذلك فنتساءل عما ترتب عن فلسفته من نظام عيش، فنحاول الوقوف عند وقع هاته على تلك. إلا أننا قد نذهب أبعد من هذا وذاك، فنسعى لمتابعة تداخل الحياة مع الإنتاج.
هذا المسعى الأخير هو ما تفرضه علينا فلسفة نيتشه على سبيل المثال، حيث نتبين أن الفيلسوف ذاته لا يعمل في النهاية إلا على رفع وقائع حياته إلى مستوى المفهوم. وهكذا نلفى أنفسنا، ونحن نقرأ فلسفته، نتعرف في الوقت ذاته على دقائق حياته، ونتابع تقلبات إحساساته ومشاعره، وتطور حالته الصحية، وكذا العلاقات الحميمة التي شدته إلى أصدقائه وأقاربه، بل حتى إلى كتبه وتنقلاته ومأكله، وما عرفته تلك العلائق من توتر ومد وجزر.
ورغم ذلك، فربما لا يكون الأمر متيسرا عندما تكون حياة الفيلسوف من الرتابة ومن "الحياد" بحيث لا نرى لها أثرا مباشرا على أعماله. لعل ذلك هو ما طبع الفلسفة عندما غدا الفيلسوف أستاذا جامعيا، مثلما تكرس الأمر في التقليد الألماني، ثم الفرنسي فيما بعد. هنا ربما تغدو عبارة هايدغر "أرسطو، فيلسوف ولد ومات" مفتاحا كافيا لدراسة فلسفة أي فيلسوف من هذا القبيل.
فقليلون هم من يولون حياة كانط أهمية كبرى عندما يتحدثون عن فلسفته، وغالبا ما يقتصرون على بعض الخصائص العامة التي ميزتها، مثلَ كونه لم يغادر مدينة كونيسبرغ إلا يوم اندلعت الثورة الفرنسية ليتسقط أخبارها، وكونه لم يكن يطيق تناول وجبة غذائه منفردا، أو كونه أخضع حياته لنظام صارم جعلت جيران سكناه يدققون ساعاتهم وقت خروجه لجولاته المشهورة في ما سيطلق عليه فيما بعد "ممر الفيلسوف". ربما يصح الحديث عن تعميم هذا على معظم الفلاسفة-الأساتذة مثل هيغل، وفيكتور ديلبوس وإيتيان جيلسون وجون فال، وف. غولدشميت، وي. هابرماس وجون ديوي وفرديناند آلكيي، وبول ريكور و..
ورغم ذلك فإن تشعب حياة القرن الماضي، وتعقد المنظومة التعليمية وتشابكها مع مناحي غيرها، بل تورطها في القضايا الاجتماعية والسياسية والنقابية، وحتى الاقتصادية، كل هذا جعل الفيلسوف-الأستاذ يجد نفسه منخرطا في قضايا تتجاوز حياته الجامعية، كما يجد أن عليه أن يعمل ويفكر و"يتفلسف" خارج أسوار الجامعة، وبعيدا عن الدرس الأكاديمي.
هنا برز بعد جديد صار من اللازم أخذه بعين الاعتبار عند دراسة فلسفة الفيلسوف، وهو لا يتعلق هذه المرة ببعد حياته الشخصية، وإنما ببعد حياته "مع". هنا أصبحت قضايا الفلسفة ترتبط، مباشرة أو بشكل غير مباشر، بحياة الفيلسوف داخل المدينة، فوجد الفيلسوف نفسه معنيا بقضايا السياسة بأوسع معنى للكلمة، لا سياسة الفلسفة وسياسة المعرفة فحسب، وإنما سياسة المدينة، والسياسة بصفة عامة.
لم يعد بإمكاننا، والحالة هذه، أن نكتفي بالقول، تمهيدا لدراسة فلسفة فيلسوف، "إنه ولد ومات"، وإنما سرعان ما نلفى أنفسنا نتحدث عن "مواقفه" (Situations) (سارتر) و"الأوضاع" (Positions) (دريدا) التي اتخذها إزاء قضايا تعطي حياته بعدا يتجاوزها كحياة شخصية، لتقذف بها داخل "التاريخ"، وتجعلها جزءا لا يتجزأ من أعماله.
وعلى هذا النحو، لا يكفينا ونحن ندرس، على سبيل المثال، فيلسوفا مثل موريس ميرلوبونتي، أن نتغافل عن علاقته بالحزب الشيوعي، وتقربه منه أو ابتعاده عنه. والأمر أشد وضوحا فيما يتعلق ببرتراند راسل أو بسارتر، الذي امتدت حياته لترتبط بحرب الجزائر، بل بحرب فيتنام وقضايا القرن السابق بصفة أعم. والأمر يصدق أيضا على المحدثين من الفلاسفة الذين ارتبط فكرهم بـأحداث مايو/أيار 1968 أو بتطور الأحوال في إيران كما وقع لفوكو، أو متابعة بعض القضايا الكبرى كما وقع لدولوز مع القضية الفلسطينية.
لم تعد الحياة المعاصرة إذن تفهم من "حياة" الفيلسوف وقائعَ ارتبطت بما هو شخصي، وإنما صارت الكلمة تؤخذ في معناها الواسع الذي لا يرى فرقا بين الخصوصي والعمومي، بين الذاتي والموضوعي، بين الفردي والتاريخي، بين "البنية والتاريخ".
عن مجلة:" المجلة "