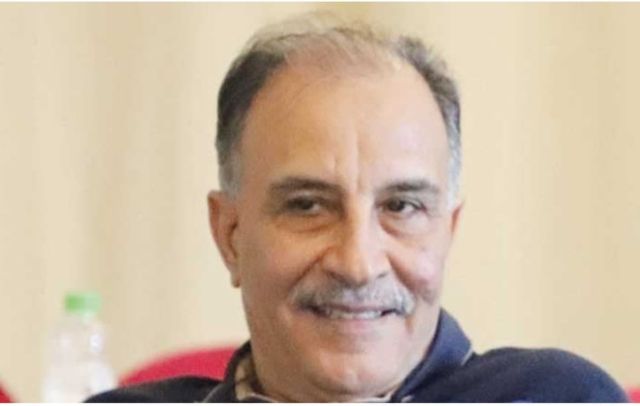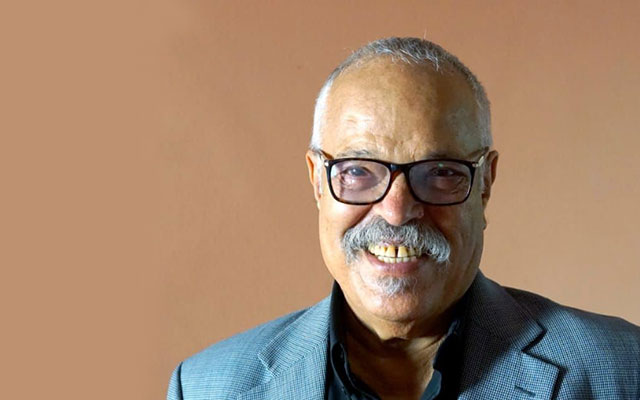أحدثت وسائل التواصل الإجتماعي تحولا عميقا في علاقتنا بالمعرفة. فسهولة الوصول إلى المعلومة لم تؤد بالضرورة إلى تعميق الفهم، بل أسهمت في انتشار ما يمكن تسميته وهم المعرفة(Illusion du savoir)، حيث يختلط الإطلاع السريع بالمعرفة الراسخة، ويُستبدل التعلم المنهجي بالاستهلاك السريع للمحتوى، وهو ما نبه إليه عدد من باحثي علم الاجتماع المعرفي والإعلام الرقمي.
في هذا السياق للوهم المعرفي، برزت فئة من الأفراد ذوي تكوين معرفي محدود، غير أن كثافة أو كثرة حضورهم الرقمي منحتهم ثقة مفرطة في آرائهم. وتنسجم هذه الظاهرة مع ما وصفه ديفيد دونينغ وجاستن كروغر بتأثير Dunning–Kruger، حيث يميل الأفراد الأقل كفاءة إلى المبالغة في تقدير معارفهم، لافتقارهم أصلًا إلى الأدوات التي تمكنهم من تقييم حدود فهمهم.
إن ما نشهده اليوم هو أن المنصّات الرقمية أصبحت تساهم بشكل أساسي في إعادة تشكيل المعرفة عبر تفكيكها إلى شذرات منفصلة تُقدم في شكل عناوين جذابة، ومقاطع قصيرة، واقتباسات مبتورة عن سياقها. بحيث أن هذا النمط من العرض لا يسمح بتتبع منطق الفكرة ولا بفهم شروطها وحدودها، بل يقدم نتائج جاهزة دون مسارها، وخلاصات دون مقدماتها. ومع تكرار هذا الأسلوب، يعتاد المتلقي على استهلاك المعرفة كما يستهلك المحتوى الترفيهي، دون جهد تحليلي أو مساءلة نقدية.
والخطير في الأمر، أن هذا التفكيك المستمر للمعلومة يُضعف القدرة على التركيز العميق، ويعيد برمجة الذهن على نمط انتباهي متقطع، يجعل التفكير الطويل والمتسلسل أمرًا شاقًا. فالعقل الذي يتغذى على الشذرات يفقد تدريجيًا القدرة على الربط، وعلى إدراك التعقيد، ويصبح ميالا إلى الأحكام السريعة واليقينيات المبسطة.
والمشكل الاأكبر هو أن آثار هذا النمط لا تقف عند حدود الفرد، بل تمتد إلى المجال المعرفي العام، حيث تتحول القضايا المركبة إلى آراء مختزلة، وتُختزل الإشكالات الفكرية في ثنائيات حادة: مع أو ضد، صحيح أو باطل، معنا أو علينا. وهنا لا يعود النقاش قائما على بناء الحجج، بل على تداول شذرات جاهزة يسهل تكرارها وتوظيفها، دون فهم خلفياتها النظرية أو التاريخية.
كما أن تقديم المعرفة في شكل شذرات يُفقدها بعدها التراكمي، إذ تُفصل الأفكار عن مسار تطورها، وعن النقاشات التي أحاطت بها، وعن الاعتراضات التي وُجهت إليها. وبهذا، لا يتعلم المتلقي كيف تُبنى المعرفة، بل فقط كيف تُستهلك. وهذا يتماشى مع ما أكده وشدد عليه الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي إدغار موران على أن المعرفة الحقيقية لا تقوم على التجميع، بل على الربط والفهم، وهو ما يتعذر في ظل هذا التفكيك المفرط.
ويزداد الأمر تعقيدا حين تلعب الخوارزميات دورًا حاسمًا في توجيه ما نراه ونستهلكه من محتوى، فهي لا تعمل على توسيع أفق المعرفة، بل على تعظيم التفاعل، من خلال تقديم مضامين منسجمة مع اهتمامات المستخدم وقناعاته السابقة. وبهذا، لا يواجه الفرد أفكارًا تُربك تصوّراته أو تدفعه إلى المراجعة، بل يُحاط تدريجيًا بمحتوى يؤكد ما يعتقده، فينشأ ما يُعرف بـ فقاعات الترشيح les bulles de filtrage، حيث يُعزل المستخدم داخل دائرة معرفية مغلقة وتصبح الأفكار ذاتها تتكرر بصيغ مختلفة، وتتعزز القناعات لا لكونها صحيحة أو مُبرهَنة، بل لأنها مألوفة ومتداولة. ومع الوقت، يتحول التكرار إلى بديل عن الدليل، ويُنتج إحساسًا زائفًا بالإجماع. وهنا يتشكل ما يُسمّى بـ صدى الغرف les chambres d'écho، حيث لا يسمع الفرد سوى صوته وصدى من يشبهه، بينما تُقصى الأصوات المخالفة أو تُصنف بوصفها شاذة أو معادية. وبهدا تتمكن هذه الآليات من حجب التنوع المعرفي ، وشل القدرة على التفكير النقدي، إذ يصبح العقل أقل استعدادًا للتشكيك وأكثر ميلًا للتصديق. وبهذا، تتحول الخوارزميات من أدوات تنظيم للمحتوى إلى آليات لإعادة إنتاج القناعات.
والأخطر أن هذه الدينامية لا تقتصر على الآراء البسيطة، بل تمتد إلى القضايا السياسية والدينية والأخلاقية وكل المجالات، حيث يُعاد إنتاج اليقين داخل فضاءات مغلقة، ويُضفى على الرأي الشخصي طابع الحقيقة المطلقة. وفي ظل هذا الوضع، لا يعود الخلاف مصدرًا للإثراء، بل يُنظر إليه كتهديد للهوية والانتماء.
هكذا، تسهم الخوارزميات في خلق وعي مُجزّأ، واثق من نفسه، لكنه فقير من حيث الانفتاح والمراجعة. وهو وعي يتغذى على التوافق لا على السؤال، وعلى الطمأنينة لا على الشك المنهجي، مما يعمّق وهم المعرفة ويُضعف شروط الحوار العقلاني في الفضاء العمومي.
هذا التحوّل أدى إلى تآكل سلطة المرجع العلمي، وإلى خلط متزايد بين الرأي والمعرفة. ويُذكّرنا هذا الوضع بتحليل يورغن هابرماس حول الفضاء العمومي، حين حذّر من انزلاق النقاش العمومي من الحوار العقلاني القائم على الحُجج، إلى تواصل تشهيري تحكمه العاطفة والتأثير، لا البرهان. والخطير أن آثار هذا التحول لا تقتصر آثاره على المجال المعرفي، بل تمتد إلى البنية الاجتماعية ذاتها، عبر إضعاف الثقة في كل ماهو علمي ، وتكريس النسبية السطحية، وتحويل الجهل إلى “رأي يُحترم”. بحيث، تفقد المعايير والمناهج صلابتها ومصداقيتها، ويصبح كل شيء قابلًا للتداول دون تثبيت أو مساءلة.
إن مواجهة هذا الواقع لا تكون بالإقصاء أو التعالي، بل بإعادة الإعتبار للتواضع المعرفي، وتعزيز التربية الإعلامية، وترسيخ التمييز بين الرأي والمعرفة، وبين الحضور الرقمي والشرعية العلمية. فالمعرفة، كما يؤكد إدغار موران، ليست تجميعًا للمعلومات، بل قدرة على الربط، والنقد، وفهم التعقيد.
وكخلاصة يمكننا القول أن الأزمة لا تكمن في وسائل التواصل الاجتماعي ذاتها، بل في تحويلها من أدوات لنقل المعرفة إلى بدائل عنها. وحين يُستغنى عن المنهج، ويُختزل الفكر في مقاطع عابرة، يصبح الجهل أكثر ثقة، والمعرفة أكثر هشاشة في المجال العام، وهو تحدٍّ ثقافي ومعرفي يستدعي يقظة جماعية.