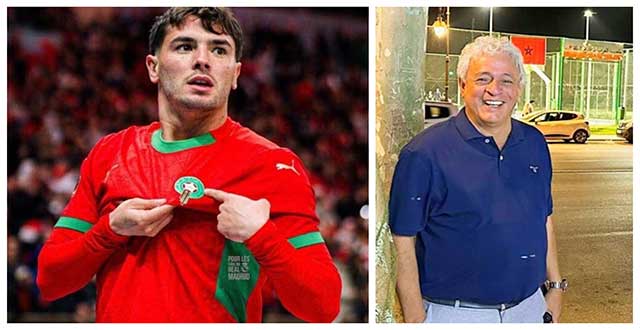أعادت نهاية كأس إفريقيا للأمم طرح سؤال مؤجل في التجربة الدستورية المغربية حول مكانة الأمن داخل الهندسة العامة للسلطة التقليدية والممتزجة بروتوشات حداثية كما يعرف الجميع. وأسئلة أخرى حول الطبيعة القانونية لرجل الأمن في السياسات العمومية وحدود خضوعه للرقابة الديمقراطية، وكذا مدى تحول السياسة الأمنية من وظيفة تنفيذية إلى سياسة عمومية مستقلة بذاتها. لقد أظهرت الوقائع المرتبطة بتدبير التظاهرة الكروية الأخيرة وما صاحبها من مظاهر عنف جماهيري، أن الدولة أصبحت تمتلك قدرة تقنية وتنظيمية عالية في مجال الضبط الأمني، وإن بقيت في المقابل تعاني من صعوبات واضحة في استيعاب السلوك الجماعي بوصفه ظاهرة اجتماعية وسياسية لا تختزل في أفعال إجرامية فردية. هذا التباين بين النجاعة الإجرائية وعدم القدرة على توصيف التشخيص الملائم، أصبح يستدعي من الباحثين في الموضوع إعادة قراءة موقع الأمن داخل النظام الدستوري من زاوية الشرعية والحكامة والموقع الدستوري.
دستور 2011 يقر بمركزية الأمن ضمن وظائف الدولة بصيغة عامة وفضفاضة. فالملك، وفق الفصل الثاني والأربعين، هو ضامن استقلال البلاد وحسن سير المؤسسات الدستورية، وهو أيضا بموجب الفصل الرابع والخمسين، رئيس المجلس الأعلى للأمن المكلف بتدبير القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الداخلي والخارجي. رغم أن هذا المجلس لم يظهر إلى حيز الوجود بعد، كمؤسسة قائمة تمارس اختصاصاتها في إطار واضح ومحور للتنسيق المؤسساتي حول الخيارات الأمنية الكبرى.
نعم الأمن هو مجال سيادي يدار خارج منطق السياسة العمومية كما حددها الدستور في الفصول المتعلقة باختصاصات الحكومة والبرلمان لأنه يعبر عن استمرارية الدولة خارج الفترات الانتخابية.
كما أن الحكومة وبموجب الفصل السابع والأربعين، مسؤولة سياسيا أمام البرلمان، فهل تمتد هذه المسؤولية إلى المجال الأمني أم أن السياسة الأمنية هي مجال تقني محاط بالسرية يعفي الحكومة من المساءلة عنها.
الفصل الحادي والسبعون من الدستور الذي يحدد مجالات تدخل القانون لا يتضمن تحديدا صريحا للسياسة الأمنية، ما قد يفسر تطور التشريع الأمني بمنطق الاستثناء والضرورة وباستقلال عن أي تخطيط حكومي ومساءلة برلمانية. البرلمان في نهاية المطاف، يجد نفسه عاجزا عن ممارسة رقابة جوهرية على الخيارات الأمنية، سواء من حيث الوسائل المستعملة أو من حيث آثارها على الحقوق والحريات.
ويمكن أن نسوق الكثير من الأمثلة في هذا السياق لاسيما المرتبطة بالتحول الذي عرفته المنظومة الأمنية المغربية خلال العقدين الأخيرين والتي انتقلت فيها الدولة من نموذج أمني تقليدي قائم على الوساطة البشرية (الشيخ والمقدم والمخبر الميداني) والمعلومة المحلية، إلى نموذج حديث يعتمد على المراقبة الرقمية، وربط البيانات، واستعمال التكنولوجيا المتقدمة في التتبع والتصنيف. هذا التحول عزز قدرة الأجهزة على الرصد بعد وقوع الأحداث، وعلى تحديد المسؤوليات الفردية بسرعة وفعالية، لكنه في المقابل عمق الفجوة بين الأمن والمجتمع، لأن المراقبة الرقمية، بطبيعتها تشتغل خارج إطار رقابي واضح، وتخلق سلطات فعلية غير خاضعة للمساءلة البرلمانية أو القضائية.
السياسة الأمنية أوكلت في ظل هذا النسق إلى رجالات الظل في الدولة ويتعلق الأمر بفاعلين غير منتخبين يساهمون بحكم مواقعهم وخبرتهم في صياغة التوجهات الأمنية الكبرى، حضور قد نجده حتى في بعض الدول الديمقراطية لكن في نسق سياسي مختلف بحكم قوة الأحزاب في هذه البلدان وحضور وساطة برلمانية فاعلة، والمكانة المميزة للوساطات المدنية الحقوقية والنقابية في تأطير نقاش عمومي مواكب ومندمج ومراقب لأي انفلات تدبيري حول السياسات الأمنية.
في فرنسا مثلا، ورغم الطابع الصارم للسياسة الأمنية، فقد تم ابتكار آليات دستورية وقانونية لمراقبة العمل الاستخباراتي على شكل لجان برلمانية دائمة وهيئات مستقلة لمراقبة تقنيات المراقبة ما سمح بتحويل الإخفاقات الأمنية إلى موضوع نقاش سياسي ومؤسساتي. أما في الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم التوسع الكبير في صلاحيات الأجهزة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، فقد ظل الأمن خاضعا لرقابة الكونغرس والقضاء والإعلام، بما في ذلك من خلال لجان استخبارات متخصصة ومحاكم مختصة في مراقبة شرعية المراقبة. هذه الآليات لم تمنع وقوع أزمات أمنية كبرى، لكنها حدت من تحول الأمن إلى سلطة غير قابلة للمساءلة.
الإشكال في الحالة المغربية لا يكمن في ضعف الأجهزة أو محدودية إمكانياتها، ولكن، وعلى وجه الخصوص، في غياب إطار مؤسساتي واضح يدمج الأمن في منطق السياسة العمومية الخاضعة للتخطيط والتقييم والمساءلة. فاستمرار التعامل مع الأمن باعتباره مجالا سياديا مغلقا يجعل الأجهزة الأمنية في مواجهة مباشرة مع مظاهر الغضب الجماعي دون سند سياسي أو مؤسساتي كاف.
قد نكون سعداء في النهاية بدروس "الكان" لأنها مكنت الدولة من وضع يدها على أغلب المخربين من جماهير البلدان المشاركة سواء في المطارات أو في المعابر الحدودية بفعل منظومة مراقبة تقنية عالية لكنها لم تكشف لنا عن مستقبل الرجل الأول في النظام الأمني في علاقته برجال الظل وهل تسعى الدولة لاستبداله بروبوت أو منصة رقمية وفقط ومآل شبكات الأنوية الأمنية التي أنشأها في مجموع التراب الوطني والتي أصبحت تعمل باستقلالية عن أي إطار مؤسساتي بحكم تغلغلها مع الشبكات المحلية وتداخل مصالحها مع مصالح الفساد وباروناته.
الأمن هو سياسة عمومية قبل كل شيء، وكلما تقدمت الدولة في اعتماد الوصفات العصرية والتكنولوجية لتطويره كلما تأكد لها عدم رجحان المقاربات المزاجية التقليدية التي حكمته منذ عقود، لأن الفلسفة الأمنية في التكنولوجيا الحديثة تقوم على الشفافية وقوة المؤسسات وهو الحائط المسدود الذي بلغه رجال الظل في الدولة العميقة، لكنهم ما زالوا يصرون على مناطحته كل يوم بسيزيفية بلهاء.
منير الطاهري، باحث في علوم التدبير والحكامة العمومية