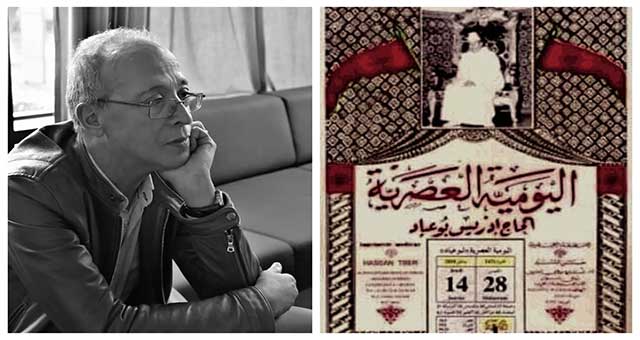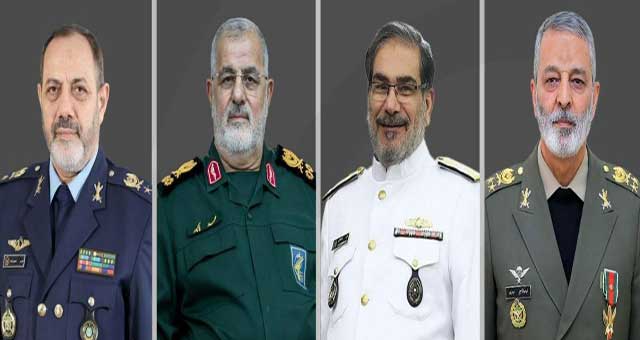انتهت كأس إفريقيا، وفاز المنتخب السنغالي بالكأس. هنيئًا له، وهنيئًا للشعب السنغالي الذي سيستقبل لاعبيه بالفرح، وسيخرج إلى الشوارع للاحتفال. وهو فرح مفهوم ومشروع، بل ومحتاج إليه. فالمجتمعات لا تعيش بالسياسة وحدها، ولا بالأرقام الجافة، بل تحتاج إلى لحظات فرح جماعي تخفف وطأة اليومي القاسي. والسنغال، مثل كثير من دول إفريقيا، تعيش أوضاعًا اقتصادية واجتماعية صعبة: دين عمومي مرتفع، بلغ 130 في المئة من الناتج الداخلي الخام نسب فقر مقلقة، 18 فيي المئة يعيشون باقل من ثلاثة دولار في اليوم وبنية تحتية هشة في مجالات متعددة. لذلك، فإن هذا التتويج، مهما كانت خلفياته الرياضية، يبقى مناسبة إنسانية صادقة لفرح شعب أنهكته التحولات الاقتصادية والاجتماعية. ولا أحد يجادل في حقه في ذلك.
أما خسارة المنتخب المغربي، فهي مسألة أخرى. لماذا خسر؟ كيف خسر؟ وأين كانت الاختلالات؟ هذه أسئلة مشروعة، لكن مكانها الطبيعي هو التحليل التقني البارد، ومسؤوليتها تقع على عاتق الطاقم الفني وأهل الاختصاص، القادرين على تفكيك الأداء، وتحديد الأخطاء، وترتيب المسؤوليات بعيدًا عن الانفعال والتجريح. هذا نقاش ضروري، لكنه ليس جوهر ما يستحق التوقف عنده اليوم.
ما يهمني هنا أعمق من نتيجة مباراة. لأن ما رافق هذه الدورة، قبل انطلاقها وخلالها، لا يمكن اعتباره مجرد توتر رياضي عابر. فالمجهود الذي بذله المغرب في الاستعداد لكأس إفريقيا لم يكن مجهودًا عاديا أو ظرفيًا، بل كان استثنائيًا بكل المقاييس: ملاعب بمعايير عالمية، بنية تحتية حديثة، موارد بشرية مؤهلة، تنظيم محكم، فنادق، نقل، لوجستيك، وأمن. صحيح أن المغرب كان يستعد في الوقت نفسه لاستحقاقات كبرى، وفي مقدمتها كأس العالم، واستفادت كأس إفريقيا من هذا التراكم، لكن هذا لا ينتقص من قيمة ما تحقق، بل يؤكد وجود رؤية واستمرارية في العمل، لا ارتجال فيها ولا صدفة.
وعلى المستوى الرياضي الصرف، فإن النتائج خلال السنوات الأخيرة تتحدث عن نفسها: مشاركة تاريخية في كأس العالم، تتويجات في فئات الشباب، والنساء وألقاب قارية وعربية، وحضور ثابت في الواجهة. هذا المسار لم يكن وليد الحظ، بل نتيجة استثمار طويل في البنية، وفي التكوين، وفي الحكامة الرياضية. ومع ذلك، وبدل أن يُقابل هذا المسار بشيء من الاعتراف أو التقدير، وجد المغرب نفسه هدفًا لحملة تشكيك ممنهجة، قبل البطولة وخلالها، من أطراف عربية وإفريقية على حد سواء.
فإذا كان السلوك الجزائري، في كثير من محطاته، لا يحتاج إلى تفسير معقد، لأنه يدخل في منطق عداء سياسي مرضي معلن ومزمن، فإن ما يصعب فهمه حقًا هو انخراط أطراف أخرى في هذا التحرش الرمزي. هنا، نحن فعلًا في حاجة إلى علماء السياسة والاجتماع، لا إلى محللي المباريات. لأن السؤال لم يعد: ماذا وقع في اللقاء النهائي؟ بل: لماذا يثير نجاح المغرب كل هذا القلق؟
هل يكتشف بعضهم، حين يقارن نفسه بما ينجزه المغرب، حجم الفجوة بين الخطاب والواقع، وبين الطموح والإمكان؟ هل يتحول نجاح الآخر إلى مرآة قاسية تُظهر فشل الذات؟ أم أننا أمام أزمة ثقة عميقة في المؤسسات الداخلية، حيث يصبح كل شيء مشكوكً فيه، لأن التجربة المحلية علمت الناس أن الفساد هو القاعدة، لا الاستثناء؟ حين تكون المؤسسات ضعيفة، يصبح من الصعب تصديق وجود تنظيم نزيه، أو تحكيم عادل، أو بلد قادر على إدارة تظاهرة كبرى دون تلاعب.
وهل للأمر علاقة أيضًا بعلاقة متوترة مع كل ما هو ديمقراطي؟ فالديمقراطية ليست فقط صناديق اقتراع، بل ثقافة وسلوك وتربية على احترام القواعد وقبول الاختلاف. في غياب هذه الثقافة، يصبح الشك هو الموقف الافتراضي: الشك في الحكم، الشك في الحارس، الشك في الملاعب، الشك في الفنادق، الشك في البلد المنظم. كأن النجاح نفسه لا يمكن أن يكون طبيعيًا، بل لا بد أن يكون مشوبًا بشبهة ما.
ما حدث في هذه الدورة يذكّرنا بأن كرة القدم، في السياق الإفريقي، لم تتحرر بعد من أثقال السياسة، ولا من عقد النقص، ولا من هشاشة الدولة الوطنية في عدد من بلدان القارة. فهي، بدل أن تكون فضاءً للفرح والتنافس الشريف، تتحول أحيانًا إلى مسرح لتصريف الإحباطات الجماعية، وإسقاط الفشل الداخلي على “الآخر” الذي تجرأ ونجح.
ومع ذلك، لا مصلحة للمغرب في الانجرار إلى خطاب المظلومية أو الردّ الانفعالي. فالعلاقة مع إفريقيا لا تُبنى بالخصومة الدائمة، ولا بمنطق التفوق، بل بفهم عميق لتعقيدات القارة وتنوعها. إفريقيا ليست كتلة واحدة: فيها من يفرح لنجاح المغرب، وفيها من ينافسه، وفيها من يضايقه صعوده. الحكمة هي أن يواصل المغرب مساره بهدوء وثقة، وأن يحمي معنى نجاحه، لا أن يعتذر عنه أو يتنكر له.
انتهى الكان، وطار الكأس إلى دكار، وبقي السؤال الأهم مفتوحًا: كيف يمكن لنجاح إفريقي أن يتحول إلى مصدر توتر داخل إفريقيا نفسها؟ هذا سؤال لا يجيب عنه لاعب ولا مدرب، بل يجيب عنه الفكر، والسياسة، وقدرتنا الجماعية على قبول أن ينجح أحدنا… دون أن نشكك فيه.



 .
.