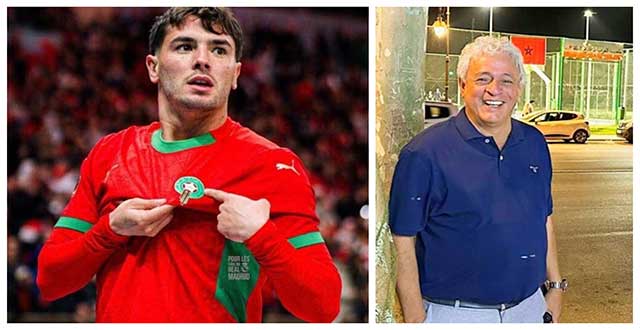الكرة، تلك "الجلدة العامرة بالبرد "والدفء، بالمغامرة والمرح، لعبة ساحرة تحمل لنا كل الأوصاف والنعوت التي نطلقها عليها. صحيح أن اللاعب حين يكون وسط الميدان يعيش كل لحظة بتركيز وإثارة، لكن حتى المتفرج يشعر بمتعة لا مثيل لها، خاصة إذا كان اللعب نظيفا. أما إذا اتسخت المباريات، فتتقد الأحقاد وتخرج من قمقمها، لنصبح أناسا آخرين.
أتذكر أيام الطفولة والمراهقة ومابعدهما، كيف كانت كرة القدم سببا في اكتسابنا معارف وصداقات جديدة، ليس في المدن فحسب، بل حتى في البوادي. كنا نسافر من سطات إلى أولاد سعيد في فصل الصيف، حيث كانت تجتمع كل فئة عمرية بمفردها، بينما كان ما يسمّى "بلعزارة ديال الدوار" أي الشباب الذين لم يتزوجوا بعد، يجتمعون لوحدهم. كان احترامهم واجبا، ولا يمكن للكثيرين من الأطفال والمراهقين مخالطتهم بسهولة، لكن هذه" الجلدة "كانت تكسر كل الحواجز.
أتذكر حكاية لن تمحى من ذاكرتي، كان ذلك في أحد فصول الصيف، حين "جات الصابة"، أي كان العام جيدا فلاحيا. كانت هناك "أرض فيها البصلة"، وبعد بيعها أصبحت عارية. اتفق الجميع في دوار اطواسة بأولاد سعيد على شراء كرة "ميكازا"، وكلفوا أحد الشباب بالذهاب إلى سطات لشرائها. وعندما عاد، كان الجميع فرحين كأنهم يعيشون يوم عيد.
المساحة التي لعب فيها هؤلاء اللاعبون كانت أوسع من كل الملاعب، وكنت محظوظا للعب معهم رغم صغر سني. الأغلبية لعبوا حفاة، فالتربة المعروفة بـ"التيرس" أو "الشكلاط" كانت تشجع على ذلك. لم يكن أبناء الدوار يلعبون ضد بعضهم مباشرة، حتى لايكون أي ميز بينهم وبين أبناء الدواوير الأخرى، بل كانت تتم العملية عبر "التعازيلة"، حيث يتباعد عميدا الفريقين المفترضان ثم يحاولان الالتقاء مجددا، ومن تأتي قدمه في الأخير فوق قدم غريمه يبدأ باختيار اللاعبين لتشكيل فريقه.
بعد هذه العملية، التي تتم في هرج ومرج وفرح، يبدأ الماتش، خاصة مع وجود كرة جديدة من نوع "ميكازا". أتذكر مشهد ولد "امحمد" وهو يرفع الكرة بين يديه في السماء، محاولا تنفيذ "السونتر"، وقد نجح برفعها عاليا باستخدام قدمه اليمنى الحافية، بينما يترقب اللاعبون أين ستسقط. لكن، للأسف، حين سقطت، اكتشف الجميع أنها" تفشات" بعد أن اخترق ظفر الإصبع الأكبر من رجل اللاعب جلد الكرة، ولم تعد صالحة للعب.
في أيام عطلة فصلي الربيع والصيف، كنا نحن الأقران من كل الدواوير نلعب بكرة "ميكا ديال ستين ريال" طبعا الريال هنا عملة مغربية ولاعلاقة له بريال مدريد، في أحسن الأحوال، ب "بيلوطا". لقد كانت هناك مواهب كثيرة من المراهقين، وللأسف لم يتم تبنيها، ولو تم ذلك لكانوا بلا شك نجوما في سماء كرة القدم المغربية. كنا نلعب ببراءة ودون حقد أو غل، بغض النظر عن النتيجة، وكانت الروح الرياضية سائدة، رغم أننا لم نعرف هذا المصطلح بعد؛ فكانت ردات فعلنا فطرية، وما زال الجميع ممن عاشوا هذه التجربة يتذكرون هذا الأمر.
تجربة أخرى عشتها في مدينتي سطات، كيف أن فرقة كرة القدم التي كنت أنتمي إليها، فرقة "دالاس" من حي سيدي عبد الكريم، أنقذت أعضاءها بفضل هذه اللعبة من كل الموبقات وهدبت سلوكنا. ما زلت أتذكر ملعب "الحمري" قرب إعدادية مولى عبد الله، والجمهور من الشباب والأطفال وحتى الشيوخ، يتابعنا بحب ويصفق على أي تسديدة أو تمريرة فنية أو هدف. كان الجمهور مغرما بـ"الرقايقية" الذين يتفنون في المرواغات والاستعراضات، وكان الإقبال على مبارياتنا يزداد خاصة في شهر رمضان.
أتذكر ذات رمضان، حين أقيمت بطولة على مستوى أحياء مدينة سطات، وفريقي الذي كنت أرتدي فيه القميص رقم 2 تأهل بعد الفوز على العديد من الفرق، ليواجه في المباراة النهائية، فريقا قويا انضم إليه نجوم من النهضة السطاتية مثل خالد رغيب وسعيد الركبي وغيرهم. لعبنا نحن الهاوون ندا للند، رغم أن أغلبنا كان يرتدي "صنطالات ميكا خضراء"، مقابل لاعبين بأحذيتهم الرياضية وبمهاراتهم وبنياتهم الجسمانية. أما أنا، فكنت أرتدي حذاء "باتريك" الذي كان صديقي محمد الصوفي يستعيره أحيانا للعب مع النهضة السطاتية وأيضا صديقي حسن الحلاقي الذي كان هو الآخر في جونيور النهيضة.
الكرة وسعت علاقاتنا، وحتى أولئك الذين كنا في خصام معهم، كانت ساحة الميدان مناسبة لإعادة المياه إلى مجاريها. هكذا هي الرياضة، نبل وأخلاق وقيم وتسامح.
لكن، ونحن نتابع بطولة كأس إفريقيا، ظننا أن الروح نفسها ستحكم اللاعبين والمدربين، خاصة أنهم محترفون. للأسف، رأينا ما رأينا. استحضرت ذكرياتنا القديمة وتساءلت، ما الذي بدل النفوس؟ هل هو المال؟ لا أعتقد، فالمحترفون اليوم جميعهم "ملايرية". هل الحسد؟ أظن أن نفوسهم أرقى من ذلك، مروضة ضد هذه الفيروسات. هل هي معادن الناس؟ ربما.
أخشى أن يتحول اللاعب المحترف، الذي يراقص الكرة والخصوم ببراعة، إلى أداة طيعة يراقصها السياسي، يوظفها خارج روح اللعبة، لتلميع صورته أو لإرسال رسائل لا شأن للرياضة بها. وهنا تكمن خطورة تحول الملاعب إلى مسرح لأهواء أخرى، تفقد الكرة دفئها وتفقد النفوس صفاءها.
والسؤال المطروح بعدما رأينا ما رأيناه، هل نصبح مثل هذه" الجلدة" المملوءة بالريح، بلا دفء، بلا روح، بلا طهارة؟ أم ستظل الرياضة، كما عهدناها أيام الطفولة والمراهقة، ملاذا للمتعة، للحب، وللقيم التي تجعل من الكرة فعلا لعبة و مدرسة للحياة؟