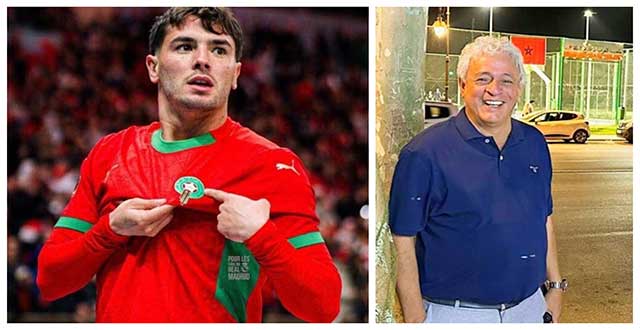لم يعد الهاتف الذكي مجرد أداة للاتصال أو وسيلة للتعلم والترفيه، بل تحوّل إلى عنصر مركزي في تفاصيل الحياة اليومية داخل كل بيت. ولعل أكثر من يعيش مرارة هذا التحول هم الآباء، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة يومية مع أبنائهم: رغبة في حماية براءتهم ونقاء عقولهم، مقابل ضغط اجتماعي لا يرحم. طفل يرى صديقه في المدرسة يحمل أحدث هاتف، فيعود إلى البيت متسائلا: لماذا أُحرَم مما يملكه الآخرون؟
هنا لا تتعلق معاناة الأبوين برفض الهاتف في حد ذاته، بل بما أصبح يمثله في حياة الطفل. فقد تحوّل الجهاز إلى علامة للقبول بين الأقران، وأداة يقيس بها الطفل مكانته داخل محيطه. وعندما يُستبعد من يومه، لا يشعر فقط بفقدان وسيلة ترفيه، بل بإحساس خفي بالإقصاء، وكأن انتماءه للجماعة أصبح مشروطا بما يملك، لا بما هو عليه.
لم تعد القضية مرتبطة بجهاز بعينه، بل بفراغ تربوي يتسع كلما غابت الرؤية المشتركة، وتأخّر القرار الجماعي. فالسؤال لم يعد: هل الهاتف مفيد أم ضار؟ بل: من يملك زمام توجيهه؟ ومن يتحمل مسؤولية وضع حدوده في حياة الأطفال؟
الجميع يعرف الخطر، والجميع يتحدث عنه، لكن الجميع صامت عند لحظة القرار. المدرسة تشتكي من ضعف التركيز وتشتت الذهن. الأسر تعبّر عن قلقها من الساعات الطويلة أمام الشاشات. الأطباء يحذّرون من آثار الإدمان الرقمي على الدماغ والسلوك. ومع ذلك، تبقى الأسر وحدها في مواجهة يومية غير متكافئة، في معركة لا صوت لها، لأن المجتمع بأكمله يدفع في الاتجاه المعاكس. فالغياب الحقيقي هنا ليس غياب الوعي بالمشكلة، بل غياب الاتفاق على مواجهتها، وترك كل أسرة تخوض المعركة وحدها.
الحقيقة أن الهواتف لم تُفرض علينا بقوة قاهرة، بل جاءت نتيجة استسلام جماعي. استسلمنا لإيقاعها السريع قبل أن نفكّر في كيفية توجيهها أو وضع حدود لاستخدامها. تركنا أبناءنا يكبرون وسط طوفان من الصور والمقاطع، دون أن نسأل كيف سيؤثّر ذلك في وعيهم، أو يوجّه أحلامهم وتصوراتهم عن الذات والعالم. وهكذا وجد الجيل الصغير نفسه في مواجهة عالم أوسع من طاقته، عالم لم نمهّد له الطريق، ولم نعلّمه كيف يتعامل معه.
وربما حان الوقت للتفكير بجدّية: المطلوب ليس حماية الأطفال كأفراد فقط، بل التحرّك كمجتمع يضع أطرًا واضحة وحدودًا ذكية لهذه الظاهرة. فالمبادرة يمكن أن تبدأ من المدرسة، حين تقرّر منع الهواتف داخل فضاءاتها، حماية للمتعلمين من المقارنات الجارحة، وحفاظا على تركيزهم. عندها لا يعود الطفل المحروم من الهاتف استثناءً، بل يصبح الجميع في الوضع نفسه، دون شعور بالنقص أو الإقصاء.
وفي البيت، يمكن للأبوين الاتفاق على تأجيل اقتناء الهاتف إلى عمر أنضج، مع شرح الأسباب للطفل بصدق وهدوء، لا بقرارات غامضة أو أوامر صارمة. وفي الوقت ذاته، لا بد من ملء هذا الفراغ بأنشطة بديلة تمنح شعورا بالانتماء والبهجة: من الرياضة والهوايات، إلى الحوار اليومي، والمشاركة في مسؤوليات صغيرة تبني الشخصية وتغذّي الثقة بالنفس.
أما على مستوى الدولة، فيمكن سنّ سياسات واضحة كما فعلت بعض الدول التي حدّت من استخدام الهواتف في المدارس، أو نظمت زمن التعرض للشاشات بالنسبة للأطفال. كما يمكن إطلاق حملات توعوية وطنية تعيد الاعتبار لفكرة أن الهاتف وسيلة، لا وسام شرف ولا معيارا للانتماء.
حين تتكامل هذه المبادرات: قرار واعٍ من الأسرة، وإطار صارم من المدرسة، وسياسات داعمة من الدولة، يمكن أن يتغيّر المسار. فالهواتف لن تختفي من حياتنا، لكن الفرق كبير بين أن نكون نحن من يمسك بزمامها، أو أن نتركها تسوق أبناءنا حيث لا رجعة. ويبقى أن الخطوات الصغيرة، حين تتحوّل إلى وعي جماعي، يمكنها أن توقف النزيف، وتمنح أبناءنا فرصة أن يدخلوا إلى العالم الرقمي وهم أقوى، لا وهم أسرى.