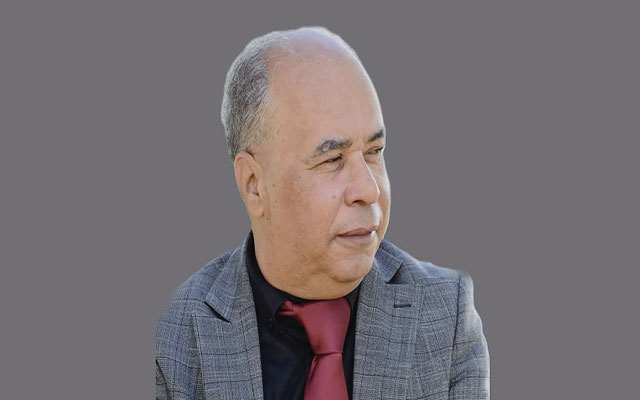في ذكرى رحيل عبد القادر البدوي (1934 – 2022)، نستحضر مسيرة هذا الرائد المسرحي الذي ساهم في تجديد المسرح المغربي وإغنائه على مدى نصف قرن، إذ انطلق البدوي من طنجة وأبدع عبر المئات من الأعمال التلفزيونية والمسرحية ضمن فرقة “مسرح البدوي”، التي أسسها مع شقيقه عبد الرزاق البدوي، وامتدت هذه التجربة بين عامي 1965 و1995، قبل أن تشهد انقسام الأخوين بسبب الخلافات، ما دفع إلى تأسيس فرقة “مسرح البدوي 65” عام 1997.
وحافظ عبد القادر البدوي رغم ذلك على بصمته المغربية، ونجح في إدخال تجربته ضمن المناهج الأكاديمية في الجامعات المغربية والعربية، ورحيله يغيّب المسرح العمالي عن المشهد الثقافي المغربي بعدما ازدهر لسنوات طويلة، حينما شكل هذا النوع المسرحي منبرا لصوت العمال ومواهبهم، لكنه تراجع تدريجيا، في حين اتجهت الأجيال الجديدة إلى أشكال تعبيرية مختلفة، لكن يظل المسرح العمالي فصلا مهمًا في تاريخ الفن المغربي.
المسرح العمالي
بدأ المسرح العمالي في المغرب في عام 1952 خلال فترة الاستعمار، مع الراحل عبدالقادر البدوي، الذي كان حينها شابا عاملا في شركة التبغ، فأطلق أول فرقة مسرحية عمالية تحت اسم “فرقة أشبال العمال”، حيث كان يؤلف ويخرج ويمثل ضمن الفرقة التي ضمت مجموعة من العمال، وقدمت الفرقة عروضا موجهة لجماهير الطبقة العاملة، وسرعان ما اكتسبت شعبية واسعة، لتستقطب جمهورا من مختلف الطبقات والانتماءات. وشهدت أوائل الستينات بروز فرق مسرحية أخرى تحت قيادة عبدالقادر البدوي، ركزت على قضايا الطبقة العاملة.
وسعت إلى تنمية وعيها وتعزيز دورها في المجتمع، ومن أبرزها “فرقة المسرح البدوي”، وتزامنت هذه المرحلة مع تحولات اجتماعية وسياسية كبرى في المغرب بعد الاستقلال، وهذا أدى إلى ظهور فرق مسرحية متعددة في مدن مثل وجدة والدار البيضاء والرباط وفاس، وتناولت هذه الفرق في أعمالها قضايا العمل والإنتاج والحقوق العمالية، وساعدت في نشر الوعي بين العمال وتعزيز دورهم في دفع عجلة الإنتاج، عبر عروض مسرحية تحمل رسائل توعوية وترفيهية.
وقدم عبدالقادر البدوي مسرحية “يد الشر” في عام 1960، التي شكلت نقطة تحول في مسيرته المسرحية، إذ دمج المؤلف في هذه المسرحية عناصر من أعماله السابقة مثل “العامل المطرود” و”كفاح العمال” و”المظلومون”، ليصوغ عملا يحمل أبعادا أعمق، واختار أن يجعل من إحدى شخصيات الطبقة العاملة وزيرا ينقلب على رفاقه ليصبح “يد الشر” التي تضرب حقوق العمال ومصالحهم، ومع تطور الأحداث يكتشف هذا الوزير وصوليته وانتهازيته.
وتوزعت الأدوار البارزة في “يد الشر” بين عبدالقادر البدوي ومصطفى تومي ومحمد الحبشي والشعيبية العدراوي ونعيمة المشرقي ومحمد الخلفي، وعرضت المسرحية لأول مرة في المسرح الملكي بالدار البيضاء، وتابعها الطيب الصديقي الذي اعتبره البدوي ذا توجه فرانكفوني ومعاكس للهوية الوطنية، واستطاع الصديقي بعد العرض استقطاب مجموعة من أبرز الممثلين المشاركين في المسرحية، مثل نعيمة المشرقي والشعيبية العدراوي ومحمد الخلفي ومحمد الحبشي ومحمد ناجي، وهذا شكّل ضربة قاسية لمسرحية “يد الشر”، وأدى إلى توقفها بعد هذا الرحيل الجماعي.
ودخل مسرح البدوي إلى الساحة الاحترافية مباشرة بعد الاستقلال، وقدم عروضا متنوعة على خشبة المسرح وشاشات التلفزيون، كما تناول البدوي في أعماله قضايا إنسانية واجتماعية وسياسية بألوان فنية متعددة، من الكوميديا إلى التراجيديا، ومن الواقعية إلى التعبيرية والتراثية، ورغم هذا التنوع ظلت نصوصه تطرح هموم وتطلعات الطبقة الشعبية والعمالية والفئات المهمشة.
وتأثر المسرح العمالي في المغرب بالتوجهات الفكرية والفنية السائدة خلال فترات معينة، ظهرت في المسرح الواقعي الملتزم بقضايا الشعب وهمومه، وساهم هذا التوجه في ترسيخ المسرح العمالي كجزء أساسي من الحركة الثقافية والفنية في المغرب، ورغم أهميته شهد هذا النوع من المسرح تراجعا تدريجيا حتى اختفى تمامًا من المشهد المسرحي المغربي.
خسارة الفقدان
يعود تاريخ المسرح المغربي إلى الحقبة الرومانية، عندما شهدت مواقع مثل ليكسوس وزيليس عروضا متعددة بلغات أمازيغية ولاتينية وقرطاجية، وأضفى على المسرح الروماني طابعا محليا مميزا، وتراجع المسرح الروماني بعد الفتح الإسلامي بسبب تعارضه مع القيم الإسلامية، لكنه استمر في أشكال شعبية مثل “الحلقة” و”البساط” و”سيدي الكتفي” و”عبيدات الرما”، التي حافظت على روح الأداء الجماعي وأسهمت في تشكيل الهوية المسرحية المغربية.
وشهد المسرح المغربي المعاصر تطورا كبيرًا في بداية القرن العشرين بفضل الفرق الأجنبية التي قدمت عروضها في المغرب، وحفز على ظهور فرق محلية مثل “الجوق الفاسي”، وركز المسرح في فترة الحماية الفرنسية على الموضوعات الوطنية، وتميز برواده الكبار مثل عبدالقادر البدوي والطيب الصديقي وأحمد الطيب العلج، الذين استلهموا أعمالهم من التراث المحلي والغربي، بينما يبقى المسرح العمالي تيارا فنيا يركز على تمثيل قضايا الطبقة العاملة والمجتمعات المهمشة، مستهدفا تعزيز الوعي الاجتماعي والسياسي لدى الجمهور.
المؤسسات الفنية في المغرب تعتبر من الركائز الأساسية التي يجب أن تلعب دورا كبيرا في إحياء أعمال الرواد وتوثيقها، كوسيلة للتواصل مع الأجيال الجديدة ويتميز هذا النوع من المسرح بأسلوبه الواقعي والمباشر، يعالج قضايا تهم حياة العمال اليومية وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، ليصبح منصة فنية للنقد الاجتماعي والمطالبة بالعدالة والمساواة، ولطالما تميز المسرح العمالي بدوره التفاعلي في تعزيز روح التضامن بين الطبقات العمالية، إلا أن اختفاء المسرح العمالي يمثل خسارة ثقافية كبرى، وهذا التراجع حالة من الغموض والتجاهل، تتقاطع فيه عدة عوامل مثل انعدام الكتابة المخصصة لهذا التيار المسرحي، ونقص الدعم الثقافي للفرق المسرحية، وضعف اهتمام الأجيال الجديدة بالتقاليد المسرحية النضالية، وتراجع النقابات العمالية التي كانت تمثل قاعدة دعم رئيسية لهذا المسرح.
فهل سيظل المغرب الفني هكذا كلما رحل رائد من رواده في المسرح أو السينما أو التلفزيون، تختفي أعمالهم وإرثهم الفني؟ فبذكرى رحيل عبدالقادر البدوي، أحد أبرز مؤسسي المسرح العمالي في المغرب وأحد أعمدته الأساسية، ندرك أن رحيله شكل خسارة كبيرة للفن المسرحي في البلاد، فقد كرّس نصف قرن من عمره لإثراء هذا الفن النبيل عبر “فرقة مسرح البدوي”.
ويزيد هذا الفقدان من تعقيد سؤال إحياء المسرح العمالي في الزمن الراهن، فهل اختفى هذا المسرح نتيجة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي غيرت ملامح المجتمع المغربي؟ أم أن فقدان مكانته كان نتيجة الإهمال الثقافي؟ في كلتا الحالتين، يعد تراجع المسرح العمالي خسارة كبيرة، كأداة نضالية فعالة تعكس هموم الطبقات الشعبية وقضاياها الجوهرية.
وتعتبر المؤسسات الفنية في المغرب من الركائز الأساسية التي يجب أن تلعب دورا كبيرا في إحياء أعمال الرواد وتوثيقها، كوسيلة للتواصل مع الأجيال الجديدة، فمن الضروري أن تقوم هذه المؤسسات بتخصيص فعاليات سنوية للاحتفاء بتاريخ هؤلاء الرواد، سواء في المسرح أو السينما أو التلفزيون، من خلال عرض أعمالهم وتوثيق تجاربهم الفنية، لغرس قيم الفن والإبداع لديهم، فالاهتمام بتوثيق أعمال الرواد وإحيائها يعبر عن احترامنا لتاريخنا الفني، ويحفز وعي الأجيال الجديدة بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي، ويدفعها إلى المشاركة الفعالة في الحياة الفنية مستقبلا.