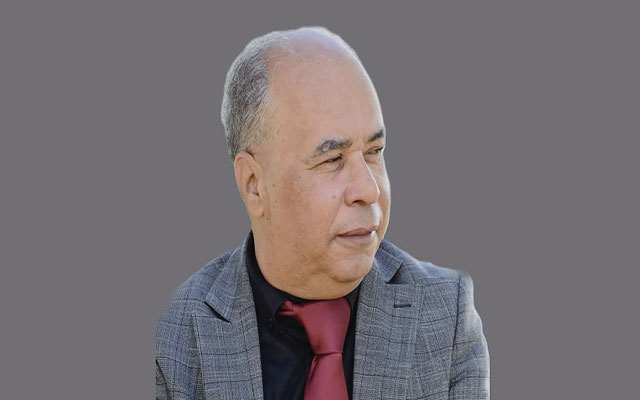دعا عبد الرحمان الحرادجـي، أستاذة مادة المخاطر الجيولوجية والجيومرفولوجية، إلى اتخاذ تدابير وقائية للتخفيف من أضرار الزلازل في المغرب، وعلى رأسها البناء بمواد ومواصفات مقاومة للزلازل في المناطق النشطة بقوة تكتونيا، وإبعاد المباني والمنشآت من الصدوع، والعمل هنا يبدأ بالتعرف على هذه الأماكن وجردها.
وقال الحرادجي في حوار مع "أنفاس بريس"، بإن إعادة الإعمار والترميم والتأهيل عمليات تستدعي تداخل التخصصات من حقول معرفية وعلمية متعددة لتقدير كل المخاطر المحدقة.
وقال الحرادجي في حوار مع "أنفاس بريس"، بإن إعادة الإعمار والترميم والتأهيل عمليات تستدعي تداخل التخصصات من حقول معرفية وعلمية متعددة لتقدير كل المخاطر المحدقة.
ضرب الزلزال منطقة الحوز التي لا تحسب على مناطق النشاط الزلزالي الكثيف فكيف حدث ذلك؟
أولا، حبذا لو نصحح بعض الصور المتداولة حول هذا الموضوع. يصح القول إن زلزال 08 شتنبر 2023 لم تكن بؤرته في الحوز كما قد يفهم من التسمية التي أصبح يعرف بها (زلزال الحوز)، وإنما كانت في قلب جبال الأطلس الكبير الغربي، لكن الارتجاج الذي انطلق منها لم يعم الجوار مثل الحوز وسوس فقط، بل امتد إلى مئات الكيلومترات حيث شعر به السكان في الرباط والدار البيضاء وفاس ومكناس وغيرها. أما الهزات الارتدادية اللاحقة فهي مرتبطة بالحدث الرئيس، لكن بؤرها جاءت في أماكن أخرى بطبيعة الحال، وغالبا غير بعيد من مركز الهزة الأولى، وأقل قوة منها.
فهذه المنطقة ليست من الأماكن المعروفة بنشاط زلزالي دؤوب وكبير مثل الطرف الشمالي لبلادنا (الريف)، غير أنها مع ذلك مرشحة لحدوث الزلازل، وإن بكثافة أضعف وتردد قليل، وهذه الاعتبارات لا تعفيها من حدوث هزات قوية من حين لآخر، بالرغم من كونها أصلا نادرة، واحتمال حدوثها بعد الهزة الرئيسة يظل ضئيلا جدا. فالذي يجعل هذه المنطقة عرضة للهزات الأرضية هو وجود مجموعة من الفوالق الكبيرة وتفرعاتها المتعددة والتي تحتك على طولها وعمقها كتل قارية تشكل أجزاء من الصفيحة الإفريقية. فهذه الفوالق (أو الصدوع والانكسارات) تؤطر وتحد سلاسل جبال الأطلس (الكبير والمتوسط خاصة) والريف. يوجد مكان تصادم الصفيحة الإفريقية مع الصفيحة الأوراسيوية على امتداد الهامش الشمالي لسلسلة جبال الريف وبينهما صفيحة ألبوران (أو البرهان) التي تؤثث قاع جزء من غرب البحر الأبيض المتوسط، بحكم حركية تكتونية تقلصية تترجم بالتقارب، وهناك يوجد نشاط زلزالي كثيف، لكن من حين لآخر، يمكن لهذه الحركية أن تترجم بزحزحة قد تحدث بعيدا، على مستوى الفوالق، ولاسيما الكبرى، وهذا ما حدث بزلزال 08 شتنبر 2023. وهكذا، يمكن أن تحدث هزات بجوار هذه الصدوع، بل حتى بعيدا عنها داخل الدرع الإفريقي (جنوب الأطلس الكبير)، لكن بقوة أضعف وتردد نادر جدا.
ماهي أبرز البؤر الزلزالية في المغرب، وماهي أهم التدابير التي ينبغي اتخاذها توخيا لمخاطرها؟
أبرز البؤر الزلزالية في المغرب تقع في جبال الريف، وخاصة حول فالق وادي النكور والحسيمة ومحور الناضور – كبدانة، وكذلك في هامشيها الجنوبي والغربي، لكن كثرة النشاط الزلزالي بها يجعل الهزات عموما خفيفة نسبيا، إذ إن تحرّر الطاقة المتراكمة مع الزمن على دفعات متعددة يجعلها أقل خطورة عموما. أما التدابير التي يمكن، بل ينبغي اتخاذها توخيا لمخاطرها، فهي وقائية بالأساس، إذ لا يمكن تجنب وقوع أي زلزال ولا تأجيله ولا التخفيف من قوته، مثلما لا يمكن التنبؤ بوقوعه، لكن يمكن التخفيف من أضراره. والوقاية هنا تعني البناء بمواد ومواصفات مقاومة للزلازل في المناطق النشطة بقوة تكتونيا، وإبعاد المباني والمنشآت من الصدوع. والعمل هنا يبدأ بالتعرف على هذه الأماكن وجردها، بناء على سجلات المراقبة التي توفر رصيدا هاما منذ القرن العشرين، رغم أنه غير كاف للإحاطة بالخطر الزلزالي، بسبب قصر المدة الزمنية التي وفرت هذه التسجيلات، وهنا يكمّل الرصيد بالمعلومات التي توفرها المصادر التاريخية. وهناك أيضا إجراءات تتخذ في تدبير الأزمات، إلا أن الأحداث الزلزالية تأتي عموما بشكل مباغت، ولا تترك فرصة التصرف والإنذار بشكل مبكر، لأن المدة الزمنية التي تفصل بين الإشارات الاستباقية وبين حدوث الزلزال تكون عموما قصيرة جدا، تقاس باللحظات أو الثواني أو بدقائق معدودات، ولا يمكن أن تتوفر في بلدنا أنظمة الإنذارات وتبليغها، بحكم ضعف النشاط الزلزالي فيها أصلا.
أبرز البؤر الزلزالية في المغرب تقع في جبال الريف، وخاصة حول فالق وادي النكور والحسيمة ومحور الناضور – كبدانة، وكذلك في هامشيها الجنوبي والغربي، لكن كثرة النشاط الزلزالي بها يجعل الهزات عموما خفيفة نسبيا، إذ إن تحرّر الطاقة المتراكمة مع الزمن على دفعات متعددة يجعلها أقل خطورة عموما. أما التدابير التي يمكن، بل ينبغي اتخاذها توخيا لمخاطرها، فهي وقائية بالأساس، إذ لا يمكن تجنب وقوع أي زلزال ولا تأجيله ولا التخفيف من قوته، مثلما لا يمكن التنبؤ بوقوعه، لكن يمكن التخفيف من أضراره. والوقاية هنا تعني البناء بمواد ومواصفات مقاومة للزلازل في المناطق النشطة بقوة تكتونيا، وإبعاد المباني والمنشآت من الصدوع. والعمل هنا يبدأ بالتعرف على هذه الأماكن وجردها، بناء على سجلات المراقبة التي توفر رصيدا هاما منذ القرن العشرين، رغم أنه غير كاف للإحاطة بالخطر الزلزالي، بسبب قصر المدة الزمنية التي وفرت هذه التسجيلات، وهنا يكمّل الرصيد بالمعلومات التي توفرها المصادر التاريخية. وهناك أيضا إجراءات تتخذ في تدبير الأزمات، إلا أن الأحداث الزلزالية تأتي عموما بشكل مباغت، ولا تترك فرصة التصرف والإنذار بشكل مبكر، لأن المدة الزمنية التي تفصل بين الإشارات الاستباقية وبين حدوث الزلزال تكون عموما قصيرة جدا، تقاس باللحظات أو الثواني أو بدقائق معدودات، ولا يمكن أن تتوفر في بلدنا أنظمة الإنذارات وتبليغها، بحكم ضعف النشاط الزلزالي فيها أصلا.
من المعلوم أن للزلزال تداعيات مرفولوحية على السطح فما هي أبرز الاحتياطات الواجب اتخاذها؟
سؤال وجيه، فالاعتقاد السائد لدى العموم هو أن حركة الأرض تتوقف مع انتهاء الزلزال وتلاشي تردد الهزات الارتدادية مع مرور الوقت. لكن المخاطر الجيولوجية، والتي تتمثل أساسا في الزلازل والبراكين وما يمكن أن يترتب عن بعضها من ظواهر إن حدثت في البحر، مثل الأمواج البحرية العاتية أو التسونامي، قد ترافقها اختلالات في توازن بعض السفوح التي تطبعها الهشاشة، وكلمة السفح تعني في الواقع كل سطح أرضي منحدر وليس فقط قدم الجبال كما هو متعارف عليه لدى العامة. وهذه الاختلالات يمكن معاينتها ميدانيا كما رآها الجميع في تساقط الصخور وتدحرجها وفي الانزلاقات الأرضية التي عرقلت عمليات الإنقاذ في بعض المناطق الوعرة، حيث أغلقت بعض الطرق والمسالك. فالزلازل، ولاسيما القوية منها، ترافقها في الواقع تحركات وزحزحات، وكذلك تشققات وتصدعات في بعض الكتل الصخرية للبناءات التضاريسية، ترشحها لحركات مؤجلة. فهذه الحركات القادمة قد تنشط بهزات أرضية لاحقة أو بدونها، ولا سيما مع مرور الوقت مع تهاطل الأمطار أو الثلوج أو التطورات الذاتية لهذه الكتل بفعل الجاذبية، فتحدث انهيالات وانهيارات وانزلاقات وانسياخات. وهذه الحركات تدخل في نطاق المخاطر الجيومرفلوجية، وينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار في تشييد أي مبان أو منشآت اقتصادية أو تجهيزية من طرق وسكك وقنوات وموانئ وسدود وجسور وأنفاق وغيرها. وفي السياق الزلزالي، تعتبر من الجوانب الجيوتقنية التي تراعى فيها المستجدات الناجمة عن الهزات والارتجاجات، وتقدير احتمال تنشيطها بالعوامل الخارجية المقترنة بالجاذبية، في كل الأمداء، القريب والمتوسط والبعيد. وكثير من السفوح أو أجزائها تفقد تماسكها وتكون عرضة لنشاط مورفودينامي قد يستمر لفترات طويلة بعد الزلزال، قبل أن تستقر بتوازن جديد بعد سنوات أو عقود أو أكثر، ولذا فإعادة الإعمار والترميم والتأهيل عمليات تستدعي تداخل التخصصات من حقول معرفية وعلمية متعددة لتقدير كل المخاطر المحدقة.
كيف تنظر إلى التوقعات التي يتم اطلاقها بين الحين والآخر بحدوث زلازل وهل لها ما يسندها من الناحية العلمية؟
من الناحية العلمية، ينبغي أن نميز بين التوقع وبين التنبؤ. فالأول يستند إلى معطيات بقياسات أو مؤشرات حاضرة، كما هو الشأن في توقعات أحوال الطقس، إذ لا تتعدى صدقيتها بضعة أيام. أما الثاني فهو مبني على فرضيات نضع فيها معطيات افتراضية. وبالنسبة للزلازل يمكن أن نرشح مناطق معينة لحدوث هزات أرضية، وذلك بحكم موقعها في أماكن الضعف الجيولوجي، وهي عموما تقع حول خطوط التقاء صفائح القشرة الأرضية المتقاربة منها والمتباعدة، بمعنى حول الفوالق التي تحدها وكذلك حول الصدوع التي تخترقها. لكن لا أحد يستطيع أن يتنبأ بمكان وزمان حدوث أي زلزال قادم. فبالرغم من صدور بعض المؤشرات الاستباقية، وكذلك انبعاث بعض الغازات بنسب غير عادية (الرادون مثلا) أو بعض التغيرات في المياه الجوفية أو التشققات غير الزلزالية، لا يتأتى الجزم بقرب حدوث زلزال. هناك بعض الحالات التي ساعدت فيها بعض هذه المؤشرات على التوقع، وإن بدون دقة، لكن كثيرة هي الحالات التي لاقت إخفاقا، كما أن بعض الهزات لا تسبقها مؤشرات دالة في أمد كاف. وهناك تشويش على هذه الوضعية العلمية لإشكال التوقع أو التنبؤ، ولنستحضر هنا ما يدعيه الهولندي فرانك هوخربيتس من دور لاصطفاف الكواكب والانجذاب في حدوث الزلازل. وقد فند بعض العلماء صحة هذا الدور، كما أن تنبؤات هذا العالم تفتقر إلى أي دقة لا في المكان ولا في الزمان. فلو كان لهذه الاصطفافات الدورية دور لتمكنا من وضع رزنامة للهزات القادمة، على غرار الكسوف والخسوف. فهو يقدم معلومات عامة في سياق الحركية الزلزالية للقشرة الأرضية، مع العلم أنها لا تتوقف لحظة عبر العالم، بحيث تقع مثلا زلازل بقوة "زلزال الحوز" (بدرجة 6-7) بمعدل حوالي 120 مرة في السنة، وبقوة زلزال أگادير (بدرجة 5-6) بمعدل 800 في السنة، أما الأقل منها قوة فتحدث بالآلاف، وبالتالي يمكن التنبؤ بحدوث زلازل بأي قوة مفترضة، لكن دون تحديد المكان والزمان بدقة.
سجل إثر الزلزال الذي ضرب الحوز جفاف عيون مائية بشكل نهائي أو مؤقت مقابل تفجر عيون جديدة فما تفسير ذلك من الناحية الجيولوجية؟
طفت على سطح فضاءات الإعلام والتواصل أخبار كثيرة حول نضوب عيون وظهور أخرى إثر حدوث الزلزال، وأصبحت موضوع تفسيرات وتأويلات، للأسف بعضها مجانب للصواب أو غير دقيق، إذ بعض أصحابها متطفل على الموضوع أو مخطئ في التدقيق. فهذه الظاهرة عادية جدا مع الزلازل، ولا سيما القوية منها، بل قد يظهر بعضها حتى قبل وقوع الزلزال فتعتبر من بين المؤشرات الاستباقية. فالمياه المعنية هي مياه جوفية، تخضع للدورة المائية المتغذية من الأمطار والثلوج التي تجدد مخزوناتها وانسيابها، وتتسرب إلى الفرشات والسدم الجوفية المعلقة في المرتفعات أو العميقة في الأحواض المخفوضة ومنها الارتوازية أيضا. وبطبيعة الحال، المياه لا تعبر سوى الصخور النفيذة وتوقف مرورها الصخور الكتيمة، ومع حدوث الضغط أو الارتخاء داخل القشرة الأرضية، يمكن لتسربات هذه المياه أن تغير بعض مساراتها فتنضب عيون وتنبثق أو تحيا أخرى، بل يتغير مستوى المياه الجوفية في الآبار صعودا أو هبوطا، كما قد يتغير طعم الماء أو لونه بامتزاج معادن ذائبة أو مواد عالقة فيتعكر بعضها، كما قد تتغير درجة حرارته. وهذه التغيرات الطارئة قد تكون ظرفية ومؤقتة، وقد تكون نهائية مستديمة.