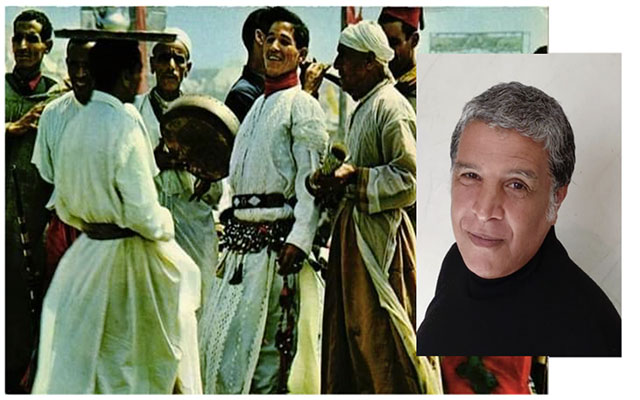أثارت النقاشات الأخيرة داخل المؤسسة البرلمانية حول مجموعة من المواضيع استياءا كبيرا داخل الأوساط الجامعية والرأي العام الوطني ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام؛ ليس فقط بالنظر إلى حجم الضرر الذي تلحقه بمصداقية العمل البرلماني والسياسي بصفة عامة وإنما لما أضحت تطرحه هذه النقاشات من تساؤلات عميقة حول إشكالية النخب والتواصل السياسي والبناء الديمقراطي بشكل عامة بالمجتمع؟
فما الذي حصل ويحصل في المشهد السياسي؟ ألم تعد هناك حقا قيمة للعمل السياسي النبيل ببلادنا؟ فهل ماتت السياسة مع الزعماء السياسيين الذين نشأوا في حضن الحركة الوطنية وشربوا من ثقافتها السياسية والفكرية الثرية؟ ألم يعد أعضاء الحكومة والبرلمانيين الذين ينتمون للأغلبية الحكومية يتسع قلبهم لطرح الأسئلة الرقابية من لدن نظائرهم من فرق المعارضة؟ ما هذا المستوى، وما هذا التفكير الأحادي والنظرة الضيقة في طرح الملفات والقضايا التي تشغل بال الرأي العام الوطني الذي ينتظر- في ظل الظروف المناخية القاسية والارتفاع المهول في أسعار المواد الغذائية- نقاشا عاما هادئا وجادا ومفيدا يريحه على الأقل من وطأة الظروف المعيشية القاسية؟ وقبل هذا وذلك أهذا هو جزاء المواطنين الذين بفضلهم وصل هؤلاء السادة أعضاء الحكومة والبرلمانيين المحترمين هرم السلطة التنفيذية والتشريعية ومنهم من وصل إلى هياكل السلطة القضائية بفعل التزكيات السياسية؟
تساؤلا ت وغيرها، نطرحها في ظل غياب نقاش عمومي في القنوات التلفزية العمومية بخصوص هذه النقاشات البرلمانية التي يبدو بأنها خرجت عن السياق العام وعن مقتضيات القاعدة الدستورية والضوابط التشريعية والمتوخاة من العملية الانتخابية التشريعية؟ ألا يملك هذا الشعب نخبا فكرية وثقافية وجامعية وإعلامية تساءل الواقع السياسي والبرلماني ببلادنا من منظور موضوعي وحيادي خدمة لاستقرار البلاد وإبعاد خطر الاحتقان الاجتماعي لا سيما في ظل الانتشار الكبير لقنوات التواصل الاجتماعي الذي يقرب الصورة والوضعية السياسية والبرلمانية لغالبية الشرائح الاجتماعية؟
من المعلوم، تعتبر الانتخابات تلك اللحظة المفصلية في تاريخ النظم السياسية المعاصرة، إذ بواسطتها يتم إسناد السلطة في الأنظمة الديموقراطية وعبرها يتم إشراك المواطنين في العملية السياسية، لذلك تعتبر الانتخابات إحدى أهم آليات الديمقراطية التمثيلية وإن كانت هذه العملية تختلف مضامينها من نظام سياسي لآخر حسب طبيعة وبنية النظام الديمقراطي والنسيق السياسي في كل بلد.
ولذك تظل الانتخابات عصب الرحى في كل نظام سياسي دستوري في أي دولة مستقلة في العالم المعاصر؛ فمن خلالها يمكن للمواطنات والمواطنين التعبير عن اختياراتهم الحرة والنزيهة، من خلال التصويت عبر صناديق الاقتراع التي تتنافس الأحزاب خلالها وفق طرق ومنهجيات تختلف باختلاف الأنظمة الانتخابية المتبناة أو باختلاف طبيعة الفصل المعتمد بين مختلف السلط من نظام ساسي لآخر.
لقد ظل الرهان الأساسي المتوخى من العملية الانتخابية في التاريخ السياسي للمغرب الحديث رهانا جوهريا لتعزيز شرعية الدولة وتجسيد الاختيار الديمقراطي، وذلك من خلال التحسين المستمر للمنظومة المؤطرة للعملية الانتخابية، غير أن نتائج الانتخابات أثبتت أن أثر الإصلاحات سرعان ما يتلاشى في ظل كوابح سوسيلو جية وسياسية ندفع في اتجاه تكريس الممارسات السابقة التي كانت تطبع الفعل الانتخابي.
وفي كل الأحوال، يبقى المواطن المغربي، ناخبا أو منتخبا، هو المحور الرئيسي للعملية السياسية إجمالا والعملية الانتخابية خصوصا، مع ما تسمح به هذه الأخيرة من تسلق في سلم المسؤوليات السياسية والحزبية والحكومية والبرلمانية على حد سواء. لذلك يجب إعادة النظر في العلاقة التي تربط الاثنين، الناخب والمنتخب، في علاقتهم عامة بالعمليات الانتخابية من جهة وبالعملية الديمقراطية من جهة أخرى.
لكن نجاح أية عملية انتخابية تبقى مرتبطة بشكل أساسي بالثقافة السياسية التي يتمتع بها المواطنون بمختلف مستوياتهم وشرائحهم الاجتماعية، التي نشأوا عليها اجتماعيا أو اكتسبوها من خلال تجاربهم السياسية، ومتى كانت هذه الثقافة منعدمة فإن الانتخابات تظل في مرتبة متدنية من اهتمامات المواطنين بصفة عامة. وتستدعي الثقافة السياسية التوفر على معرفة مسبقة وكبيرة بالانتخابات وأنواعها فضلا عن طرق المشاركة فيها، قبل امتلاك ثقافة الفهم المعرفي والوعي الّإدراكي بأهدافها وغاياتها القريبة أو المرتبطة بشكل أو بآخر بحياتنا الخاصة والعامة.
وإذا كانت السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها؛ فإن اختيار الأمة لممثليها في المؤسسات المنتخبة يتم بالاقتراع الحر والنزيع والمنتظم؛ وقد اعتبر المشرع الدستوري المغربي كذلك أن مشروعية التمثيل الديمقراطي في المغرب تقوم على أساس الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة. ومن ثم فإن المؤسسة البرلمانية، بما لها من مكانة اعتبارية كممثل للأمة وبما لها من اختصاص أساسي في ترجمة إرادة صاحبة السيادة عبر إصدار القانون، فقد حظيت منذ الاستقلال باهتمام المشرع الدستوري الذي خولها مكانة مهمة في ترابية المؤسسات في الهرم السياسي للدولة المغربية، ومنحها الدستور اختصاصات تليق بمكانتها الدستورية والاعتبارية.
ولذلك، تشكل الاستحقاقات الانتخابية خصوصا البرلمانية منها مناسبة أساسية لفتح نقاشات عميقة حول السياسات العمومية في مختلف جوانب الحياة العامة، ومن المفترض بعد الانتهاء من هذه العملية وتشكيل الحكومة والبرلمان بغرفتيه أن يستمر هذا النقاش الجدي والمسؤول إلى غاية انهاء الولاية التشريعية والحكومية وهكذا دواليك؛ إذ يفترض أن يعمل السياسيون بمختلف مشاربهم الفكرية وانتماءاتهم الإيديولوجية على تقييم التجربة المنتهية وابراز نجاحاتها واخفاقاتها انطلاقا من واقع المواطن وأثرها عليه.
فتخليق العمل البرلماني يبقى مرتبط بشكل أساسي بتخليق الحياة السياسية وهذه الأخيرة مرتبطة بدورها بتخليق العملية الانتخابية، لأنها تفضي إلى العمل المؤسساتي في شقيه الحكومي والبرلماني.
كما يعد الخطاب السياسي أحد الدعامات الأساسية والرهان الأول لنجاح الحزب أو التكتل أو أي تنظيم سياسي معين في إثبات مصداقيته وتلميع صورته تجاه المواطن، ولهذا دائما ما نجد أن كل من هؤلاء يحاول جاهدا تمرير خطاب يستقطب أكبر عدد من المتعاطفين أو يدحض أكبر عدد من الأفكار الواردة في خطابات أخرى وتفنيدها وهذا في إطار ما يعرف بالتسويق الانتخابي للحزب.
غير أن ما يلاحظ في الممارسة السياسية خلال هذه المرحلة هو التباعد والتنافس الحاصل في الخطاب السياسي وانقسامه إلى شقين متناقضين ومتباعدين؛ خطاب سياسي من موقع الهجوم تتبناه بعض الاحزاب والتي كان بعضها في وقت سابق في المعارضة ومنها من كان مشاركا في الحكومة السابقة؛ وخطاب يدافع عن المكتسبات والانجازات وهو الخطاب الذي تتبناه الاحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية. وبين هذين الخطابين المتناقضين والمتابعين يتيه المواطن في سرديات وحيثيات لا تهمه ولا تلامس واقعه الاجتماعي والاقتصادي ولا تدغدغ أماله واحلامه. إلى درجة هذا الحد افتقدت الساحة السياسة لخطاب سياسي وتواصلي يكون في مستوى اللحظة والتحديات والطموحات. بل هناك من قفز على الواقع وبدأ يتكلم على حكومة المونديال.
وبنفس القدر، يلاحظ غياب وافتقار الاحزاب السياسية في مختلف مواقعها لتواصل سياسي فاعل بين المنتخبين والناخبين وهو أمر في غاية الخطورة؛ فلا ديمقراطية بدون تواصل فهذا العنصر هو الذي يصنع المستقبل السياسي من خلال تظافر الجهود بين حامل المطالب والحاجيات( الناخب) وبين المستجيب لها أو المتفاوض عليها، على الأقل، ( المنتخب).
فلا سياسة انتخابية فاعلة بلا تواصل ديمقراطي فاعل. تلك اليوم هي القضية المصيرية والاستراتيجية على مستوى العلاقة الواجب توافرها ما بين المسؤول السياسي والمواطن السياسي، واللذين يتحملان على عاتقهما كلفة الانقطاع في حلقة التواصل المفروضة واقعيا؛ فعلى سبيل المثال، تظل مهام النائب البرلماني محصورة في التشريع والمراقبة ثم التقييم، لكن تحقيقها يصعب في ظل غياب الفعل الديمقراطي الذي يستند على حضور المواطن الفعلي وحضور هذا الأخير لا يمكن أن يحدث إلا في وضعية المهمة الرابعة والتي نسيمها بالوظيفة التواصلية.
فمكانة الانتخابات في الحياة السياسية العامة ترتبط بمقدار ثقافة الوعي السياسي والإدراكي الذي يمنحه المجتمع لمواطنيه، والذي تتجلى أغلب مظاهره في الفضاءات العامة المفتوحة للنقاش الحر والنزيه حول القضايا الوطنية الأساسية- دون استثناء ما عدا تلك المرتبطة بالمقدسات والثوابت الوطنية - وعلى رأسها ثقافة الانتخابات فضلا عن دور مؤسسات التنشئة السياسية في هذا الإطار وفي طليعتها الأحزاب السياسية.
لقد كشفت النقاشات البرلمانية مؤخرا عن عطب ّأو عدم الفهم العميق لنبل العمل السياسي ومصداقية العملية الانتخابية وتدني الخطاب والتواصل السياسي وكلها عناصر أساسية لتحقيق الغايات المتوخاة من وراء إجراء العمليات الانتخابية وأساسية للبناء الديمقراطي.
فالمرحلة السياسية التي نعيشها اليوم بعد مرور أربعة سنوات عن اجراء انتخابات شتنبر من عام 2021؛ تطرح سؤالا عريضا وعميقا حول مستقبل العمل السياسي ببلادنا وتتطلب المزيد من التربية على السياسة الفاعلة والمتخلقة، بجانب الوعي البرلماني المسؤول في أداء المهام والمسؤوليات والأدوار التمثيلية وبخاصة فيما يتعلق بإشكالية التواصل غير الدائم وغير المتواتر مع الفاعل السياسي الحزبي منه والبرلماني وجماعاتهم الترابية؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان الثقة في الممثلين بصفة عامة والعملية الانتخابية برمتها، وهذا هو الحاصل فعلا في الممارسة السياسية والذي يبدو بأنه يتطلب سنوات ولربما عقود من الزمن لا ستراجعها، وما بين فقدان الثقة واسترجاعها، ‘ن تم ذلك فعلا، تضيع أجيال وأجيال من الفرص الممكنة لصعود سلم الديمقراطيات الحديثة في العالم المعاصر.
لم يعد خافيا على أحد الأدوار السياسية التي باتت تلعبها التكنولوجيا الحديثة في التنفيذ والتشريع، بواسطة الحكومات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي التي لا تفرط في دورها الرقابي نتيجة تزاوج السيبراني بالديمقراطي. و" السيبرديمقراطية" ترمي إلى تحقيق الديمقراطية الخالصة التي تحتاج إلى نظام تمثيلي. الجمهور نفسه سينخرط مباشرة في اتخاذ القرار بفضل أعاجيب الاتصال.
لقد اعتبر الكثيرون الوسائل الحديثة في التواصل السياسي كأحد المداخل الأساسية للديمقراطية التشاركية ومؤشرا حقيقيا على عودة السلطة للمواطنين في علاقتهم بممثليهم، علاقة غير مألوفة إلا أنها ساهمت بقوة في بعث النقاش العمومي في ظل غيابه عبر مختلف القنوات الرسمية واحتدامه في صالونات وساحات افتراضية لا تجد صعوبة في تحولها إلى واقع يغني تجربة ديمقراطية وليدة في المغرب، وكل هذا يحتم على الفاعل السياسي والحزبي تجديد وتنويع تواصله ويفرض عليه تحديث تقنيات التأثير على الكتلة الناخبة.
هذا الرأي هو مجرد تفاعل من مواطن مغربي من حقه التساؤل عن الوضع السياسي والبرلماني ببلاده ، وهو ليس ضرب في العمل السياسي والبرلماني أو التنقيص منه، بل محاولة للفت الانتباه ودق ناقوس الخطر من المآلات التي يمكن أن تتجه فيها البوصلة السياسية ببلانا، وليس الهدف منه التقليل بما يقوم به السادة أعضاء الحكومة والبرلمانيون المحترمون وإنما مجرد تفاعل وتعبير عن رأي من مواطن و أكاديمي من أحقيته تحريك عملية التساؤل والتفاعل مع محيطه الاجتماعي والثقافي والسياسي.
محمد الكيحل، أستاذ العلوم السياسية بالمعهد الجامعي للدراسات الافريقية
ورئيس مركز إشعاع للدراسات الجيوسياسية والاستراتيجية