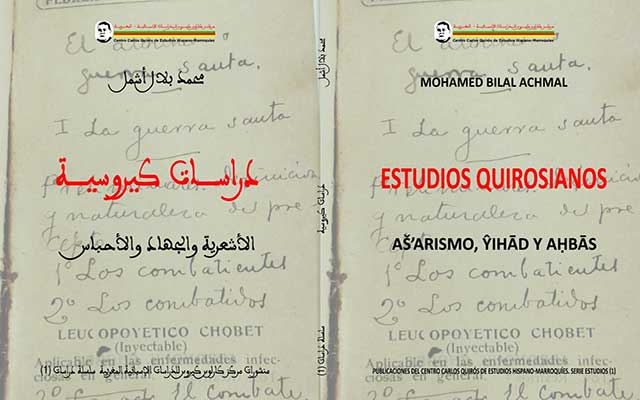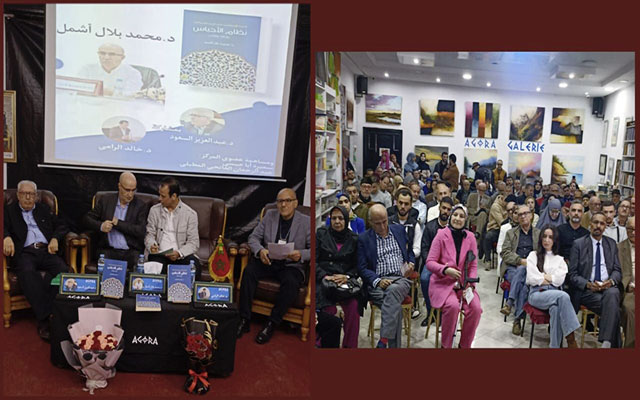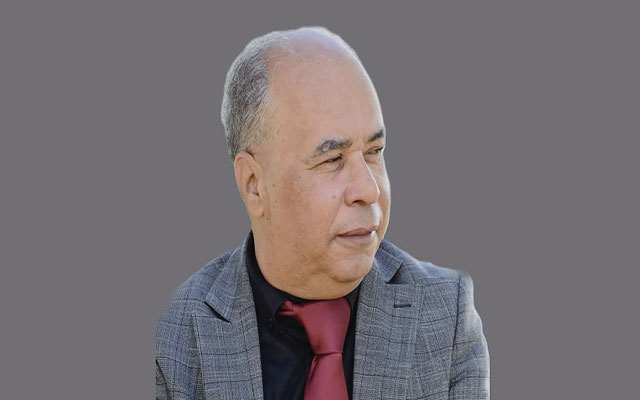تمثل قضايا الأسرة في المغرب اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة الفقه الإسلامي على استيعاب التحولات الاجتماعية والثقافية دون التفريط في أصوله أو الانجراف خلف تيارات التغيير العشوائي.
لقد أصبحت هذه القضايا فضاءً مشحونًا بالتوتر بين ثنائية الجمود والتجاوز، حيث يميل البعض إلى التعامل معها من منظور تقليدي يفتقر إلى المرونة، في حين ينادي آخرون بتأويلات مبتورة تفقدها جوهرها القيمي. إن التحدي الأكبر يكمن في إيجاد مسار وسط يجمع بين عمق النص الشرعي ورحابته وبين المتغيرات التي تفرضها الحياة المعاصرة، بعيدًا عن التشدد الذي يعطل الدين أو التحرر الذي يفرغه من مقاصده.
إن النظر إلى قضايا الأسرة في المغرب لا يمكن أن يقتصر على معالجة آنية أو حلول ترقيعية، بل يستدعي إعادة بناء رؤية نقدية إيجابية ترتكز على فهم شامل للواقع ووعي عميق بمقاصد الشريعة. هذا النهج يتطلب خطابًا فقهيًا يتسم بالقوة في ثباته على المبادئ، والهدوء في استجابته للتحديات، والنقد البناء الذي يعيد توجيه النقاش نحو جوهر المشكلات بدل الاكتفاء بسطحها. ومن هنا، يمكن صياغة رؤية تستجيب للتحولات بوعي، وتعيد للأسرة مكانتها كركيزة أساسية للاستقرار المجتمعي والتوازن الثقافي، دون المساس بالثوابت التي تشكل هوية الأمة وقيمها.
فقه واقع الأسرة المغربية والعقل الفقهي المنضبط
فقه واقع المجتمع المغربي بتاريخه الطويل وتجربته المتجذرة، كان دائمًا مرآة عاكسة للسيروة التاريخية لهذا سلبا وإيجابا، وكتب النوازل المغربية شاهدة على ذلك، وعلماء اجتماع المجتمع المغربي الذين تعاملوا مع التاريخ والفقه يعرفون أكثر من غيرهم تلك التحولات التي وقعت، والتيارات التي تجاذبت المواطن المغربي على المستويات العقدية والفقهية والفكرية والسياسية والاقتصادية والعسكرية، وهي تحولات كان الفقه فقه حاضرا بصورة ما.
اليوم، لم يتغير فيه شيء عن الأمس، من حيث ظهور الإشكالات الحارقة، والأسئلة القلقة والمقلقة، وخاصة في قضايا الأسرة المتشابكة، والتي يرى طيف واسع من المجتمع المغربي أنها المجال الأوحد الآن الذي تلامس فيه الشريعة القانون ضمن المنظومة التشريعية المغربية، وهنا يبرز سؤال تحدٍ جديد: كيف نحافظ على الخطاب الفقهي دون أن يتحول إلى قيد يكبل الناس عن مواجهة مستجدات عصرهم؟ مع واجب الاعتراف أن الجمود الذي نراه عند بعض الأطراف ليس تعبيرًا عن وفاء للنصوص، بل هو في جوهره قصور عن فهم الشريعة نصا ومقصدا وروحا وفلسفة.
حين نتأمل قضايا مثل الطلاق أو النفقة أو حضانة الأطفال، نجد أنفسنا أمام مسائل تلامس حياة الناس بأدق تفاصيلها، حيث لا تكفي الأحكام الجافة أو الحلول الجامدة، أو تلك الحلول الحادة التي تتخذ شكل المفاصلة بين الدين والمجتمع، وبين الفقه والقانون، وبين الفرد والجماعة، وبين الدولة والمواطن. الحل لا يكمن في تجاوز الدين، بل في الغوص أعمق في نصوصه ومقاصده والمساحات والإمكانات التي تتيحها الشريعة، لنكتشف كيف يمكن للفقه أن يتعامل مع الواقع أو يتخذ شكلا جديدا ومنضبطا يناسب زماننا.
لا بد من الإقرار أن كل دعوة إلى تجديد الخطاب الفقهي هي دعوة لن تكون سليمة منطلقا، أو وسيلة أو مقصدا، إلا إذا كانت موضوعية في أحكامها، تملك الجرأة وليس الجراءة على مراجعة تفسيرات وتلخيصات وشروح أسلافها، وأن تكون شجاعة في تقرير أن كثيرا من مناطات القضايا في الزمن نفسه لم تعد هي نفسها، لتغيرها بتغير السياقات، لكن مع التزام القاعدة القرآنية {يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق} [سورة النساء:171]، ودون الوقوف في فوهة تنميط الفقه وفق منهج تفقه متشدد أو متحلل، بل أن نقف موقف المنضبط "للحد الأعدل الأوسط"، الذي هو الخطاب الفقهي المتعلق بالتوجيه الإلهي في قوله سبحانه وتعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [سورة البقرة:185]، وقوله عليه الصلاة والسلام: (بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا)، والمعتبر في هذا التجديد المنشود هو ألا تكون "المراجعة تراجعا"، وألا يصبح "التسهيل تساهلا"، وألا يستحيل "التنزيل تنازلا".
الاعتلال الأيديولوجي في معالجة قضايا الأسرة المغربية
المقصود بالاعتلال الأيديولوجي هو تلك التشوهات التي تطرأ على النقاشات والتوجهات المرتبطة بالأسرة بسبب هيمنة رؤى أيديولوجية متصارعة، تُغلب مصالحها وأجنداتها على حساب المصلحة العامة. يتجلى هذا الاعتلال في تحريف النقاش من البحث عن حلول متوازنة ومستدامة إلى محاولة فرض تصورات جامدة أو منفلتة. الاعتلال الأيديولوجي لا يعني فقط صراع الأفكار، بل يشمل أيضًا غياب الحوار العقلاني واستغلال الأسرة كموضوع للصراع السياسي والاجتماعي، ما يؤدي إلى تعميق الانقسامات داخل المجتمع وتهديد استقراره.
تسهم التيارات المحافظة في الاعتلال الأيديولوجي عندما تفرض رؤى تقليدية صارمة على قضايا الأسرة، معتبرةً أن أي نقاش أو تعديل يُعد مساسًا بالثوابت الدينية. هذا التوجه يُقيد العقل الفقهي ويعجز عن تقديم حلول عملية تناسب التحولات الاجتماعية والاقتصادية. في المقابل، تنخرط التيارات الحداثية في ترويج تصورات تفكيكية تُضعف مفهوم الأسرة كمؤسسة قائمة على التعاون والتكامل، وتدفع نحو نماذج فردانية تُفكك الروابط الاجتماعية وتتنافى مع القيم المغربية.
إن تحليل تأثير التيارات المحافظة والحداثية على قضايا الأسرة يتطلب مقاربة نقدية هادئة ومتزنة، تنظر في عمق الأيديولوجيات التي تحرك هذه التيارات، وتدرس آثارها على مستوى الفقه والمجتمع.
التيارات المحافظة: إشكالية الجمود والتأطير الأحادي
تتعامل التيارات المحافظة مع قضايا الأسرة من منطلق الثبات المطلق للأحكام الشرعية المتعلقة بها، مما يؤدي إلى تبني مقاربات دفاعية تجاه أي محاولات للنقاش أو التجديد. يتمثل ذلك في اعتبار كل مبادرة لإعادة النظر في الأحكام المتعلقة بالزواج أو الطلاق أو أدوار الجنسين تهديدًا للثوابت الدينية. هذه المقاربة تعتمد أحيانا على قراءة انتقائية للنصوص الشرعية، حيث يتم تجاهل السياقات التاريخية والاجتماعية التي أثرت على الاجتهادات السابقة، وأحيانا تعتمد على انفعالات وجدانية غير واقعية إن لم نقل غير ضرورية، وهو ما يؤدي إلى انفصال بين الواقع ومتطلبات الخطاب الفقهي، مما يضعف القدرة على التفاعل مع التحولات الاجتماعية مثل زيادة نسب التعليم والعمل لدى النساء، وتغير مفهوم الأسرة الممتدة إلى النووية، وكذلك يعزز حالة من الجمود المجتمعي، حيث يصبح الالتزام الجاف بالنصوص على حساب البحث عن حلول عملية لمشكلات معاصرة مثل ارتفاع معدلات الطلاق، أو تأخر سن الزواج.، ما قد يولد مشاعر التذمر أو النفور لدى الأجيال الشابة التي تبحث عن فهم ديني أكثر اتساعًا وشمولاً.
التيارات الحداثية: فخ التفكيك والفردانية
على الجانب الآخر، تتبنى التيارات الحداثية توجهات تهدف إلى إعادة تعريف الأسرة استنادًا إلى معايير الحداثة الغربية التي تُركز على الفردانية المطلقة. تعتبر هذه التيارات أي قيود تُفرض باسم الدين والفقه أو القيم المجتمعية قمعًا لحرية الفرد، مما يؤدي إلى تصادم مع القيم الثقافية المغربية. هذه التيارات تُغفل الطبيعة التكاملية للأسرة، وتُقدم تصورًا يعتمد على تحرير الأفراد من أي التزام جماعي. يخلق هذا التوجه انفصالًا بين الحرية الفردية والمسؤولية الاجتماعية، ويؤدي إلى تآكل الروابط الأسرية والمجتمعية، كما يؤدي هذا التفكيك إلى ظهور نماذج جديدة للأسرة تتعارض مع التقاليد المغربية، مثل العلاقات غير الموثقة، أو الأسر التي تفتقر إلى دور واضح للأب أو الأم. هذه النماذج قد تُضعف الانسجام الاجتماعي وتؤثر سلبًا على استقرار النسيج الثقافي والقيمي.
بين المحافظين والحداثيين: الحاجة إلى منهج وسطي
إن التحدي الحقيقي لا يكمن في الانحياز لطرف دون الآخر، بل في بناء نموذج وسطي يجمع بين مرونة الاجتهاد الفقهي ومراعاة القيم والخصوصيات العقدية والمذهبية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية. هذا النموذج يتطلب دراسة قضايا الأسرة ضمن سياقها الاجتماعي والاقتصادي المعاصر، مع استحضار المقاصد الشرعية التي تهدف إلى تحقيق العدل والاستقرار.
إن على الخطاب الحداثي باعتباره جزءا من الواقع، أن يركز على الجمع بين حرية الأفراد والمسؤولية تجاه الأسرة والمجتمع، بحيث تكون الحرية وسيلة لتقوية الروابط الاجتماعية وليس لتفكيكها، فالمجتمع المغربي يحتاج إلى خطاب ثقافي جديد يُعيد تعريف دور الأسرة بما يحافظ على هويتها، ويعترف في الوقت ذاته بالتغيرات الحديثة. هذا الإصلاح يمكن أن يكون أداة لتحقيق التوازن بين الطرفين يقوم على ثبات الاجتماع على الإسلام، والوطن وعلى المذهب المالكي، وعلى الملكية، وعلى الأسرة، باعتبارها أمورا لا تقبل ولا تصلح أن تكون عليها أو حولها مزايدات من أي نوع.
الحكومة خادمة لا متحكمة
على الجميع أن يفهم أن وصولهم إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية هو أمر مرتبط بمؤسستين: مؤسسة المجتمع الناخب، ومؤسسة الملكية باعتبارها أولا جزءا من هذا المجتمع، وثانيا باعتبارها خادمة له وساهرة على وحدته ومقدساته، ورمزا لوحدة مكوناته العرقية واللغوية.
نعترف بأن الدولة تعيش تحت ظل السيادة المنقوصة، أي: إن الدولة بمفهومها وصورتها وعلاقاتها الدولية ترتبط بالمؤسسات والمنظمات الدولية، وتوقع على اتفاقيات قد تتصادم مع القوانين المحلية بل ومع الدستور نفسه أعلى قانون مؤطر للدولة، هي إكراهات لا بد من التعامل معها بمنطق الواقع، لكن أيضا على أي وزير أو برلماني أن يعلم أن توكيله من الشعب ليس مطلقا، بل هو توكيل تنطبق عليه جملة وتفصيلا القاعدة الفقهية والقانونية التي تقول: الوكالة إذا طالت قصرت، وإذا قصرت طالت، وتوكيل الشعب له ضمنا هو وكالة مقصورة وإن لم يصرح بها، مقصورة على أن تحفظ سيادته، وهويته، وكرامته، وحضارته، وإرثه، وعلى تحديثه وعصرنته، لكنها لا تتعدى أبدا إلى أن تغير تركيبته، لا تتعدى أبدا إلى ينظر وزير إلى نفسه باعتبار منصبه أنه متحكم، مهما كانت إمكانياته في معرفة لون الجوارب التي يلبسها المواطن المغربي.