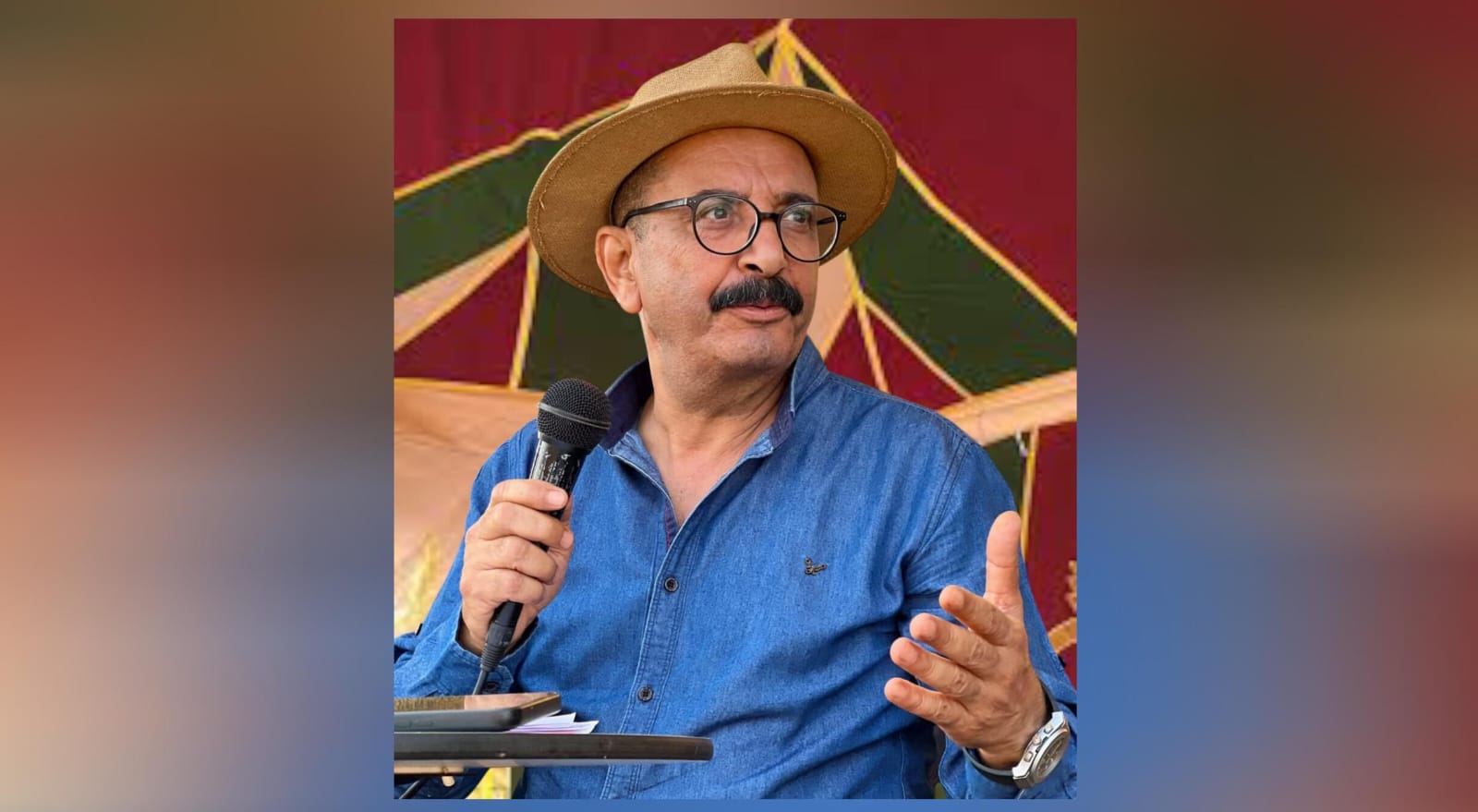ازدهار الفساد ما دامت حماية المكاسب لا تتم إلا بمزيد من الفساد الذي قد يصل إل العنف والإجرام
ازدهار الفساد ما دامت حماية المكاسب لا تتم إلا بمزيد من الفساد الذي قد يصل إل العنف والإجرام
ثمة منافسة كبيرة بين بعض العائلات للحصول على المغانم السياسية والاقتصادية، غير أن اللافت للانتباه ليس هو التنافس الذي يرتبط بالتدافع السياسي الطبيعي، بل اللافت هو أن هذا التنافس يقع بداعي حيازة الحماية، والدفاع عن الامتيازات وحقوق "الملكية". وهذا يحيل إلى منحى مافيوزي في التعاطي مع الشأن العام الذي يتحول إلى «شأن خاص»، ذلك أن العائلة تعني ضبط الأتباع وتسخيرهم من أجل حماية هذا الشأن الخاص. الأتباع أو أفراد العائلة لا يملكون حقا خيارات متعددة أو متنوعة أمام الضوابط التي تفرضها العائلات.
هذا ما انتبه إليه مؤلف «متلازمات الفساد» الثروة والسلطة والديمقراطية"، مايكل جونستون، الذي أكد أن هذا المنحى العائلي في التعامل مع الشأن العام يتغذى على انعدام الأمان الواسع الانتشار. كما يعتبره «أكثر أنواع الفساد ضررا على التنمية». كما انتبه إلى أن نشاطات العائلات تحدث خارج المنظمة الرسمية «المؤسسات، القوانين..»، مما يتسبب في تنامي النشاطات غير المشروعة، أي في ازدهار الفساد، ما دامت حماية المكاسب لا تتم إلا بمزيد من الفساد الذي قد يصل إل العنف والإجرام.
هكذا، إذن، أصبحنا نرى في المغرب جملة من الممارسات التي تتصل كلها بالتنافس العائلي لحماية المكتسبات، إلى الحد الذي أصبحت فيه المناصب المهنية والمراتب الاجتماعية مجرد مكافأة على الولاء، وعلى مدى الالتزام بحماية المكاسب، وليست استحقاقا قائما على مبدأ التنافس الحر المبني على الكفاءة ومبدأ تكافؤ الفرص.
ولا ينحصر التنافس العائلي في قطاع الأعمال، كما نلاحظ ذلك بين عائلة أخنوش والصفريوي وغيرهما على سبيل المثال، بل يمتد التنازع إلى الهيئات الحكومية والأحزاب السياسية، وأجهزة تطبيق القانون ووسائل الإعلام، بل وحتى بعض النشاطات الأدبية «شعر، قصة، رواية، مسرح، سينما، تشكيل... إلخ»، مما يؤدي إلة نشوب صراعات قد تنتهي إلى العنف، وقد تنتهي إلى «المصاهرة» و«تآلف القلوب» لتقوية حماية المكاسب ضد خصم مفترض، في سياق مبدأ «خميرنا ما يديه غيرنا».
على المستوى السياسي، ورغم التقدم الواضح في القوانين والمواثيق «الأخلاقية» التي تضع الممارسة الديمقراطية فوق جميع علاقات القرابة، سواء أكانت عائلية أم إثنية أم عقدية أم سياسية، فإن نُظُم المؤسسة تعاني من ضمور في الوظائف التي تؤديها الدولة أو من المفروض عليها أن تؤديها. وهذا الاختلال في البيئة المؤسساتية هو ما يتيح للعائلة السياسية مساحة الركض المنفرد نحو مصالحها الخاصة، خاصة مع توفر الفرص وسيادة نظام الريع والمكافآت واتساع رقعة زواج المال والسلطة.
لقد تابعنا، خلال الانتخابات العامة الأخيرة، كيف خاضت «عائلات سياسية» معروفة هذا السباق، وكيف لم يستثن من ذلك الأب والابن والابنة والزوجة والعم والخال وابن الأخ أو الأخت، من أجل تقوية حظوظ أفرادها للظفر بمقاعد في البرلمان أو الجماعات الترابية، مع ما صاحب ذلك من احتداد في المواجهة قد تصل إلى العنف للدفاع عن مجالات النفوذ الخاصة. كما لاحظنا أن العائلات نفسها قد خاضت السباق في الانتخابات الأسبق، وكيف أصبحت كل مدينة رهينة في يد عائلة واحدة، مما أفرغ الاقتراع الديمقراطي من محتواه وحلت محله قرابة الدم التي أصبحت هي حصان الوصول إلى الغنائم السياسية والمالية. إذ ما إن يحل موعد الحملة الانتخابية حتى تتقدم العائلات نفسها المشهد، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول الأساس الذي تعتمد عليه الأسباب في منح التزكيات الانتخابية؟ هل هو الكفاءة أم المال؟ هل هو التدرج في الأجهزة الحزبية أم الانتماء العائلي؟
إن حكم العائلات مؤشر قوي على أن الأحزاب أصبحت مجرد فكرة خيالية، وأن السلطة السياسية ليس طريقها هو تنافس البرامج والأفكار قدر ما هي «ميركانتو» مفتوح لمن له القدرة على الشراء، وأن المناصب مجرد بضاعة قابلة للتفويت كلما كان المقابل المادي مجزيا، وهنا نطرح السؤال التالي: هل من الطبيعي أن يؤول تدبير الشأن الحزبي إلى عائلة واحدة تفعل به ما يشاء؟ هل من الطبيعي أن تتشكل الزعامات الحزبية من «المظليين» الذين لم يسبق له أن تشبعوا بأفكار هذا الحزب أو ذاك؟ هل من الطبيعي أن يقترح هذا الزعيم أو ذاك أبناءه لشغل بعد المناصب العليا دون العودة إلى الأجهزة الحزبية؟ هل من الطبيعي أن «تُفَصَّل» المغانم السياسية على المقاس العائلي؟
قد يكون أمرا طبيعيا أن نلاحظ على المستوى الدولي أن هناك عائلات تدير الشأن العام باقتدار ديمقراطي غير مطعون فيه، مثل عائلات «بوش» «الأب والابن» و«كلينتون» «الزوج والزوجة»، و«كينيدي» «الإخوة»، «فرانسوا هولاند وسيغولين رويال»، «غاندي» «جواهر لال نهرو، أنديرا، راجيف، سونيا، راهول..»، «الحريري» «الأب رفيق، والابن سعد».. إلخ. غير أن هذه الممارسة تقتات، مغربيا، على أن حقيقة أن المؤسسات الديمقراطية أقل وضوحا ومصداقية، خاصة في ظل استمرار النشاطات الخاصة لهذه العائلات، وفي ظل الوسائل الفاسدة المتاحة التي تمكنها من الوصول إلى المناصب، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى زواج المال والسلطة، مع ما يعنيه ذلك من تحكم في مصادر القرار، وتوجيه هذا القرار لخدمة المصالح العائلية ومجالات النفوذ الخاصة، وعدم السماح للطارئ، حتى وإن كان وجها ديمقراطيا يتمتع بالكفاءة والنزاهة، بالوصول إلى «الحكم». لا قرارخارج العائلة، ولا قرار خارج الولاء لها ولمغانمها.
نستطيع أن نقول، إذن، إن حكم العائلات «يستعمل» التنافس الديمقراطية بوصفه آلية مؤسساتية للتحكم في المؤسسات وابتزاز الدولة، خاصة أمام حالة تواطؤ مؤسسات الحكامة أو المؤسسات الرقابية والقضائية التي تلتزم الصمت. كما يؤدي ذلك إلى ترسيخ أنواع معينة من الفساد والاستيلاء الممنهج على مصادر الثروة، وتكلس مسارب تجديد النخب، وبالتالي نفور المرء من العملية السياسية، مما ينعكس سلبا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد لاحظنا ذلك في عدد من حملات التطهير الموسمية التي عرفتها بلادنا، بصرف النظر عن مدى استقلالية مؤسسات الدولة في القيام بهذه الحملات، وبصرف النظر عن قدراتها الإدارية الرادعة ومصداقيتها السياسية والأخلاقية. ذلك أن استمرار هيمنة العائلات السياسية على تدبير الشأن العام توضح أن ضعف المؤسسات الرقابية مذهل، مما يؤكد أن بلادنا ما زالت تعيش مستويات مرتفعة من الفساد لا مجال لحصر تصاعدها إلا بالعمل على حرمان العضلة العائلية غير القانونية من التضخم وإعادتها إلى حجمها الطبيعي، والتسويق لعمل سياسي نزيه قائم على تباري الكفاءات، وليس على التدافع بالمناكب وإرشاء الأحزاب وشراء الذمم.