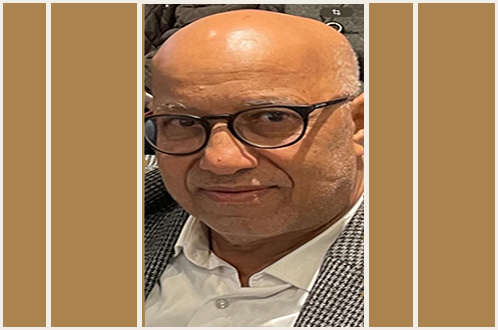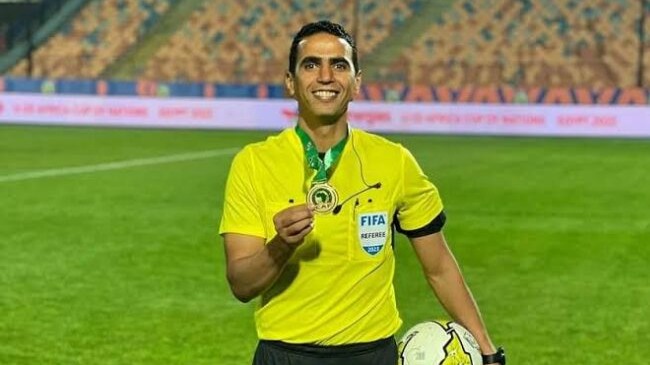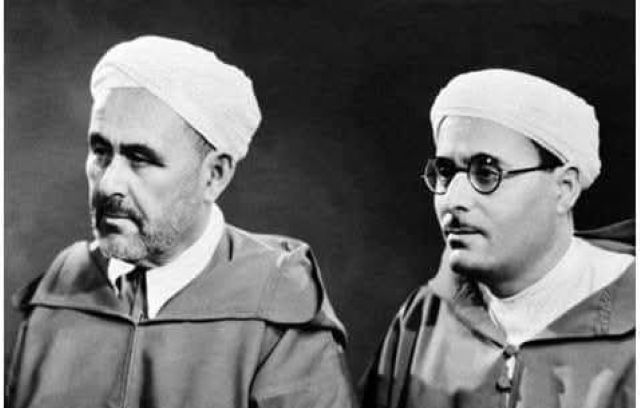خلص حميد لغشاوي، باحث في تحليل الخطاب في حوار مطول مع "أنفاس بريس" إلى أن موت النقابة هو ندير بموت الأحزاب وموت الصراع الطبقي، وولادة وعي احتجاجي آخر متحرر، وأكثر تفاعلا مع التكنولوجيا، يستوطن وسائط التواصل الاجتماعي، مشيرا بأنه من الخطأ الجهل بتأثير سياسة الحياة الافتراضية في تأجيج الحياة المعاصرة والتي صارت تنبني، في بعض الأحيان على قيم عرضية وهامشية، وما يجسد هذا هو استيلاء شبكات التواصل الاجتماعي على السلطة، مشيرا بأن التجمعات الاحتجاجية الحالية (التنسيقيات) هي الابنة البكر للنظام العالمي الجديد، وهي إبداع احتجاجي يستند إلى وعي متجدد وتجديد تاريخي لفعل الاحتجاج المنفلت من التأثير السياسي والتجربة الحياتية، والمندفع نحو الحلم والتخيل والهذيان الجماعي والرغبة في الانتقام ..
هل يمكن القول إن احتجاجات التنسيقيات في قطاع التعليم تنذر بموت الأحزاب والنقابات في المغرب علما أن البعض يرى أن الظاهرة أصبحت عالمية؟
يمكن القول إن سياق الاحتجاجات التي يعرفها قطاع التعليم، لا تخرج عن بعض القرائن الدالة على إعادة تمثُّل وعي احتجاجي عالمي: السترات الصفراء في فرنسا، أنصار دونالد ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية، التنسيق الوحدوي للتعليم في الأردن وكندا، ثقافة المقاطعة التي صارت واضحة في مجالات حيوية كالاقتصاد (مقاطعة بعض المنتجات الاستهلاكية) والسياسة (العزوف الانتخابي). ومن السخف أن نرى في هذه الأشكال الاحتجاجية وقائع بلا قيمة، ومن الغباء شرحها أو الاقتصار على اتهامها، وكل المقاربات التي تنحو نحو هذه القراءة، أو تلك التي تحاول تسيّيسها أو تمرير إيديولوجيتها، تشكو من عيب كبير يتمثل في خلط انطولوجي. ولذلك سنعيد صياغة سؤالكم وفق إشكالية أخرى وهي: علاقة الرابط السياسي بالاحتجاجات التي تتخذ من التجمعات الحرّة فضاءً للنضال؟.
لابد أن نشير إلى أن تاريخ المجتمعات، هو تاريخ "صراع الطبقات" وهذا الصراع ينتهي بالاعتراف بالتفاوتات الاجتماعية وشرعية المؤسسات والنظام الاجتماعي. إن التغيرات التي حدثت في القرن الواحد والعشرين خرجت عن طوع "العقد الاجتماعي" وتخلصت من أحباله وشرعيته القسرية، التي تستخدمها الدولة عبر الرابط السياسي، (الأحزاب والنقابات) وأعْلت من شأن الوسائط الجماهيرية والرأي العام اللامتناهي، والأحاديث اليومية. فمن سمات هذه المرحلة هي الفراغ، الفراغ يولد حقيقة اعتباطية وهي أحقية كل الأفراد والتجمعات في تعبير عن الوجود والموجود. والصراع الجدلي الجلي بين الآراء المتناثرة في شبكات التواصل الاجتماعي وقرارات الدولة صورة واضحة عن غياب الرابط الجامع بينهما.
يمكن التأكيد أن الرابط السياسي في العصر الحديث عرضي وهش، فهو لايبني الفرد ولا يشارك في تمثيلياته (العزوف الانتخابي)، ولا تؤثر فيه أفكار النقابة ولا يتق في تمثيلياتها، بِنِيّة أنّ المطالب الملحّة لا تجد موقعها الحقيقي في الحركة النقابية، لأن الدولة قلصت من حجمها، أو اتخذتها ذريعة للجم اندفاعات أفرادها المطالبة بحقوقها.
تبقى إذن التجمعات التي تبدأ من وسائط المجتمع الافتراضي هي الملاذات الحامية المتمردة على السياسة والسياسي والدولة، وتعرف كيف تفرض نفسها فوق السلطة، بعبارة أخرى، إن هذا الهروب ليس سوى جدال سجالي موجه لاتهام الأحزاب والنقابات، وبذلك فهو يحطم الخوف ببناء معادل نقابي لايتأسس على "عقد اجتماعي"، بل على مصلحة مشتركة (المطالب)، ولذلك فالفاعل السياسي يصبح في نظر هذه التجمعات مغتصبا للحقوق، فمقولة العنف ومقولة السلطة في نظر التجمعات الجديدة مرتبطان، حتى ولو كانت "النّية" صادقة، إن هذا الوعي الاحتجاجي يمتلك شرعيته من التحولات الجديدة التي تستدعي معيار الوعي بالذات والجماعة و"المساواة في القوة" للحصول على كل الحقوق.
ووعيٌ من هذا النوع لا وجود له عند الأحزاب والنقابات أو تلك الأحزاب والتجمعات المعارضة لسياسة الحكومة، بل إنّه يغلق قوسا تاريخيا كان سائدا، ويفكك بنيات ما كان يطلق عليه ب"التقاليد السياسية". ويشعل حربا حقيقية تدور رحاها في الوسائط التوصل الاجتماعي أولا ثم تنتقل إلى المواجهة بالاحتجاج الواقعي عبر تجمعات لها أهداف محددة.
ولذلك فضعف الرابط السياسي حقيقة لا يختلف حولها اثنين؛ وكلما نشبت انتقادات تجاه السياسي، حول رأي أو موقف أو رؤية أو قرار.. تكالبت عليه الأطياف الاجتماعية، لأن صورة السياسي في نظر العامة هي صورة الانتهازي والمسعور وراء الربح المادي وتدمير أرزاق الناس، أي ذلك الظالم والمستبد والسفسطائي، يحمل تاريخا من الإخفاقات، مما جعل الناس تفقد الثقة في مخرجاته للأزمات.. وهذه الصورة واحدة من تناقضات العولمة وردّتها؛ حيث فقدت الأشياء المعنى والهوية، بما في ذلك السياسي والسياسة، وفكت الارتباط مع المؤسسات وانفلت الفرد من قبضتها، بالتمرد والمواجهة والصراع، إن هيبة السياسة، اليوم، تنحو نحو المحلية. إلى الأمور المحلية وعلاقات الجيرة كما يقول "روبير ريديكير".
إذن موت النقابة هو ندير بموت الأحزاب وموت الصراع الطبقي، وولادة وعي احتجاجي آخر متحرر ومصفى، وأكثر تفاعلا مع التكنولوجيا، يستوطن وسائط التواصل الاجتماعي، وينخرط في حيويتها وهويتها المتناثرة التي يعاد تشكيلها من جديد عبر تكتلات دينامية. ولذلك من الخطأ الجهل بتأثير سياسة الحياة الافتراضية أيضا في تأجيج الحياة المعاصرة والتي صارت تنبني، في بعض الأحيان على قيم عرضية وهامشية، وما يجسد هذا القلب (حسب تعبير روبير ريديكير) هو استيلاء شبكات التواصل الاجتماعي على السلطة.
ماهي أسباب هذا الاحتجاج في نظرك؟
هناك نسق تاريخي/ فلسفي يمكن أن يقربنا من هذه المسألة: الفلسفة الغربية قتلت الإله، كما يقول نيتشه "الإله أطيح به من برجه"، والإله في العرف الديني/ المسيحي هو الضامن للحقائق الأبدية (ديكارت)، ولذلك سلّمت البشرية نفسها إلى القيصر الذي أباح لنفسه الجلوس في برجه السياسي للتنظير والتحكم والبطش والإدانة والتنكيل العمومي، ثم تَأَلّهَ فيما بعد، ويعتبر الفاعل السياسيّ سليلاً للقيصر (الإله).
من الناحية الاجتماعية، يقدم الرابط السياسي وعودا لمتطلبات الحياة المتجددة، تكون مقيّدة بالبيئة الاجتماعية والمؤسسة التي ينتمي إليها، وهي بيئة واقعية، والتعبيرات التي تصدر عنه مقيّدة وعليا، ويمكن فهمها واستيعاب مفاهيمها ورسم حدودها في سياق ما هو سياسي واجتماعي محلي ودولي، وحين تكون هذه القرارات تنبني على إكراه معين "الزيادة في الأسعار، تعديل مدونة الأسرة، النظام الأساسي الجديد في التعليم.. إلخ. تبرز معها الروح القلقة للمجتمع، حين لا تستجيب لحاجاته في العمل والاستهلاك والترفيه، وتظهر معالمها في وسائط التواصل الاجتماعي، وتؤجج الشك والخوف، وتقود رأيا عاما يكون معارضاً، وسيّئا في بعض الأحيان حين ينبني على تخمينات خاطئة أو تكون وراءه أجندات لها أهداف محددة، لذلك تصبح هذه القرارات مشكوكاً فيها وإن كانت تتذرع بذرائع مقبولة: كالعدالة والمساواة، ف"العناصر العقلانية تعد دائما جزءا طبيعيا من التفكير المؤامراتي" (كما تقول فلندية سيسكو هايكلا).
من الناحية التقنية، يمكن القول إن العالم يعيش "قطيعة إبدالية": "ظاهرة للقطيعة، ظاهرة للفقزة؛ قفزة أنتربولوجية وقفزة سياسية" من نتائج هذه القفزة هي اختفاء الواقع وذوبان قيمه الثابتة في العالم الافتراضي، بما في ذلك الرابط السياسي بين الدولة والفرد. ربما هذا ما يبرر العطش للانتقام من الفاعل السياسي الذي لحق الإدراك الجماعي، وتتجلى صوره في العقاب الافتراضي، ويكون عبارة عن تعبيرات حرّة تصدر من داخل الحياة الافتراضية، بأحكام مسبقة أو تأويلات إيديولوجية، وتلتقي مع رياح الأهواء الافتراضية المتضاربة، من جراء الفتن والمؤامرات السياسية والحروب التي يحفل بها العالم، ولاسيما في الحقل السياسي، فالنزعة التي تغلب على السياسي في نظر العامة هي نزعة براغماتية، قد لا تستجيب لكل المطالب، وهذه هي الشروط الأولى لتأسيس تجمع مضاد، يتوحد أفراده تحت ميثاق موحد يسمى "المطالب".
إن الرابط السياسي اليوم (كمقياس واقعي) صار شكليا، ولم يعد متصلا بواقع الحياة المتجددة، والمؤدي إلى المنفعة والخير الإنسانيين. لم يعد يمتلك الرابط السياسي "السلطة الأبوية (بتعبير روبرت فيلمر)". وحلت محله اليوم السلطة الافتراضية التي تتأسس على سلطة الشعور والرقابة وسنن الطبيعة الافتراضية، ثم سنة الخوارزميات التي تضبط إيقاعها وتوجه رغبات أفرادها وأفعالهم، في انعدام تام لقانون معروف ومتعارف عليه داخل المجتمع الافتراضي، لتبرير حكم أو تأسيس تجمعات. إن السّنة الاجتماعية الواقعية كانت تقتضي معايير يقاس بها الوعي الاجتماعي: وهي العدالة والحرية والمساواة، وتكون السلطة وحدها تراقب الفرد (ميشال فوكو)، أما اليوم فالسنة الاجتماعية مركبة ولا تحكمها سلطة واحدة، بل تفرضها سلطة فوقية مدمرة، وهي سلطة التكنولوجيا، ولن يتولد عن هذا التصور إلا سلطة العنف المضاد والاستبدادية والتفاهات. جعلت ممثلي الرابط السياسي في وضعية أقلية، إننا نتحرك ضمن دائرة ملغومة مبنية على "اللايقين" العمومي، وهذا أمر يدركه الجميع.
قد يقال إن الفاعل السياسي لا يعترف بالمتمرد الجديد (التنسيقيات)، ولا يلزمه الحوار معه، ولا يمكن أن تقاس القرارات السياسية على الدخلاء والغرباء، الذين يتجاوزون الرابط السياسي (النقابات مثلا) ويشعلون الفتن ويؤججون المظاهرات، أو يُدينون السياسي أو قضية سياسية، حتى وإن كان هذا الخرق مغلّفاً بأسباب قاهرة أو منفعة مشتركة، تسمى"مطالب اجتماعية عادلة". ولكن الوضع مختلف؛ بل إن هذا المتمرد الجديد يشكل صورة للرأي العام المعاصر عبر شاشة "سمارتفون". بعبارة أخرى: هو جمهور ينوّر نفسه بنفسه بعيداً عن الفاعل السياسي والنقابي اللذين أصبحا شبيهين ب"مآسي الخريف والشتاء" في نظره.
ماهو المستقبل الذي يمكن أن نستشرفه في ضوء هذه التحولات؟
يجب أن نعي مسألة غاية في الأهمية وهي أن تشكيل الإنسان والعالم يخضعان، اليوم، لسلطة فوقية، وهي سلطة كوكب "سمارتفون". استيلاء شبكات التواصل الاجتماعي على السلطة هي تحصيل حاصل، بعبارة أخرى إن الإنسان ينفصل عن الواقع الاجتماعي التقليدي بمؤسساته التي تسكن صورتها السلبية اللاوعي الجماعي. يمكن أن نستشهد في هذا السياق بقول روبير ريديكير الذي يؤكد أن "شبكات التواصل الاجتماعي هاته تضع اليوم نفسها فوق الدول، فهي مسلحة بحسن نيّتها، إنّها التجسيد الساخر والآلي للروح الجميلة القديمة؟ إنّها تريد السيادة الحقيقية، إنّها حلّت محلّ السّيادة التي تحدث عنها هوبز قديما ـ الروح الرقمية للعالم. الروح: إنّها واقع يقول الخير والشر ويحدد العادل والظالم وهي التي تحكم وتدين، وهي التي تنفذ هذه الأحكام، بعبارة أخرى، إنّها السلطة الروحية. ومن هذه الزاوية، أصبحت الدولة، هي التي شكليا للسلطة التنفيذية، في مقام المنفذّ للأحكام التي تصدرها شبكات التواصل الاجتماعي، وقد اعترفت بتخليها عن سيادتها، عن روحها".
في عالم "سمارتفون" تتجدد الرغبات وآمال تحققها، والخوف من إحباطها وإخفاقها يكون مصدره من الواقع الموضوعي المقيّد بالرابط السياسي، هذه التركيبة الثنائية تدفع الجماهير الافتراضية إلى تأسيس تجمعات تدفع إلى مزيد من الصدام، دون تسوية تلوح في الأفق مادامت الرغبات متحوّلة ومتجدّدة، ويمكن أن تكون هناك هدنة.
إن هذه التجمعات الاحتجاجية هي الابنة البكر للنظام العالمي الجديد، للبشرية الجديدة، إنّها إبداع احتجاجي يستند إلى وعي متجدد وحذق وملم بالأخبار، إنّه التجديد التاريخي الحقيقي لفعل الاحتجاج المنفلت من التأثير السياسي والتجربة الحياتية، والمندفع نحو الحلم والتخيل والهذيان الجماعي والرغبة في الانتقام .. كل هذه الأهواء تشكل دمًّا "كوزموبوليتيا" يصعب قولبته أو تصنيفه إيديولوجياً، إنّه إنسان التجمعات الغاضبة. يقول "الجحيم هو نحن".
والأخطر هو حين يتحول الفاعل السياسي العالم بالدواليب الخفية لسيرورة المرفق السياسي، إلى كائن افتراضي معارض سياسيا، أي خارج الأغلبية الحاكمة، ويحمل فانوسا في مجتمع مظلم يجمع به الحشود ويحرضها على الانتقام الجماعي؛ من السياسي والسياسة والدولة والمجتمع، ويدخل في هذه الصنف، أيضا، تلك النجوم التي تسكن في كهوف افتراضية خارج البلد، أو ما يسمون ب"المؤثرين اللاجئين". هذه السيرورة تشكل منعطفاً حادًّا في أزمة بناء مصداقية الدولة وتهدد كيانها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والديني؛ بتأجيج الغضب والمظاهرات. فتصير قرارات الدولة محل اعتراض ومساءلة واتهام. والمغرب يمثل صورة مثلى لهذا الصراع.