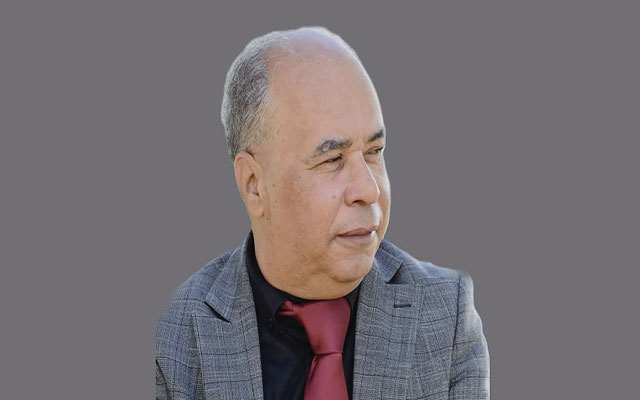يفكّك مولاي عبد الحكيم الزّاوي، باحث في علم الاجتماع، تمظهرات تكرار سيناريو الفشل والتعثر الذي ظل يطارد عددا من الحكومات في تنفيذ ركائز الدولة الاجتماعية وبرامجها التي يطلقها الملك وتفشل الحكومات في أجرأتها عبر ثلاث مستويات ومداخل.
وأوضح الباحث الزاوي، في حوار مع "الوطن الآن "و"أنفاس بريس"، أن "المطلوب تغيير العقلية السّياسية. وهي مسألة جوهرية من أجل تغيير المسار، بهدف الإنتقال من الدّولة التي تعتمد على منطق الدّعم إلى الدولة التي تعتمد على منطق التمكين الاقتصادي":
عدد من البرامج الاجتماعية التي أطلقها الملك محمد السادس وعهد إلى الحكومة بتنفيذها وأجرأتها تواجه عددا من الألغام أثناء التنفيذ. ما قراءتك لذلك؟
يحيل السؤال في جانب منه إلى علاقة الانفصام التي تعتري الخطاب والواقع. وهي ملاحظة جوهرية في هذا السياق. لكن قبلا، وجب التذكير بمقتضى أساسي، يرتبط بالاختيارات النيوليبرالية الكبرى التي راهنت عليها الدولة منذ ثمانينات القرن الماضي. فحينما ننظر إلى هذا الاختبار نجد أنه أفرز ندوبا بنيوية ارتبطت بسياسة التقويم الهيكلي. النتيجة: تعليم غير منصف، وغير متكافئ، خدمات صحية رديئة، وولوج جد محدود إلى الشغل والسكن...هذه النّدوب البنيوية سعت تدخلات الدولة إلى معالجتها، لكن الواقع يقر بأن هذه التدخلات اتسمت بالانتقائية، أو لنقل بالاستدراكية، والبعض يصفها بالإحسانية أو الإسعافية...عموما، لا ترقى مجمل التدخلات إلى تقديم حلول جذرية وشاملة للمسألة الاجتماعية من حيث تحقيق العدالة الاجتماعية والاستفادة من الخيرات والثروات...
عودة على السؤال، في البدء، يقتضي الجواب عنه ضرورة التدرج في بناء التحليل. هناك على الأقل، ثلاث مستويات في التحليل.
أولا، هناك الشق المتعلق بالمبادرات الملكية التي تسعى إلى القطع مع الترسبات التنموية السابقة وتراهن على خلق ثورة اجتماعية حقيقية من خلال الاستهداف المباشر للفئات الاجتماعية المقصية من التنمية والأكثر هشاشة. يظهر تحليل هذا الجانب، أننا أمام رؤى واضحة وصريحة تعمد إلى تحسين الوضع الاجتماعي للمغاربة، وإلى تحويل الاقتصاد المغربي من اقتصاد ريعي محدود إلى اقتصاد اجتماعي تضامني.
وفي المستوى الثاني، الشق الثاني، المتعلق بالسياسات الحكومية التي تراهن على الهاجس السياسوي وربح الزمن الانتخابي والتسويق الإعلامي للمبادرات الملكية دون أن تكون لها القدرة على التفعيل والتنزيل.
أما الشقّ الثالث، مرتبط الشعب من خلال تراجع منسوب الثّقة والتّوجس من كل المبادرات والأوراش التي تعلنها الحكومة، وهي مسألة ترتبط بفشل المشاريع السابقة، وبغياب مؤسسات الرقابة وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة...وبالتالي، الجمع بين هذه العناصر كفيل بتركيب رؤية شمولية وعامة حول علاقة الانفصام التي تعتري الخطاب والواقع. تم هنا يجب أن نحيل على مسألة هامة على قدر كبير من الأهمية ترتبط بتضارب الأرقام بين المؤسسات في توصيف المعضلة الاجتماعية، نحيل هنا على "البوليميك" الدائر بين المندوبية السامية للتخطيط والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الدولية. هذه المسألة تجعل عملية الاستهداف صعبة. في السياق ذاته، وجب طرح السؤال الآتي: لماذا الدولة الاجتماعية الآن؟ لا يجب أن ننسى أن مغرب ما بعد كورونا عرَّى عن حقيقة بعض الفئات الاجتماعية، وخاصة الفئات الهشة، وانضافت إليهم اليوم ما يسمى «الفئة المتوسطة» التي استنفدت قدراتها من أجل الصمود أمام واقع التضخم الاقتصادي وغلاء الأسعار والزيادات الضريبية وتعثر الحوار المركزي حول الزيادة العامة في الأجور.
-من المفروض أن تحرص الحكومة على تنفيذ وتنزيل ركائز الدولة الإجتماعية، غير أن التجارب السابقة للحكومات المتعاقبة أكدت أنها لم تكن في مستوى التطلعات. اليوم هناك تخوف وتردد من تكرار نفس السيناريو واجتراره. كيف تحلل وتقرأ ذلك؟
نحن الآن في مرحلة النّقد والتجاوز. نمتلك وعيا جماعيا ومؤسساتيا بأن الاختيارات النيوليبرالية كانت مكلّفة جدا على مستوى تحقيق الإنصاف والعدالة وتكافؤ الفرص...قبل الاشتباك مع السؤال، يحضرني في هذا الصدد كتاب كان قد صدر مُوفَّى سبعينيات القرن الماضي من طرف الاقتصادي المغربي جميل السالمي بعنوان: Le Maroc: Planification sans développement، "المغرب: تخطيط من دون تنمية". أعتقد أن هذا الكتاب لا يزال يحظى براهنية كبيرة في تحليل الوضع الاقتصادي في مغرب اليوم. كيف ذلك؟.
إذا حاولنا أن نستعرض مسار تنمية المغرب على مستوى الوثائق يمكن أن نقول بدون تردّد أننا نتوفر على مخططات ومشاريع رائدة لا مثيل لها في العالم: عناوين جذابة، مشاريع طموحة وسيولة مالية مغرية... لكننا على مستوى الواقع لا نجد أثرا لذلك على المعيش اليومي للمغاربة. الواقع، هناك خلل، أو لنقل، ثمة حلقة مفقودة مثلما يقال في نظرية تحليل النّظم الاقتصادية بين المدخلات والعمليات والمخرجات... أتصور أن عملية الربط بين هذه المداخل الثلاثة تقتضي إحداث ثورة في التدبير من خلال تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة واستقطاب الكفاءات الوطنية واستبعاد منطق الولاءات...عمليا، لا تتأتى هذه العمليات من دون الاهتمام بالموارد البشرية. والحديث عن الموارد البشرية يجرنا إلى الحديث عن قطاع التعليم مشتل صناعة هذه الموارد. والمناسبة شرط كما يقال على ضوء صدور النظام الأساسي وردود الفعل تجاهه من طرف الشغيلة التعليمية. يعاني اليوم هذا القطاع من إهمال واضح من طرف كل الحكومات المتعاقبة رغم جاذبية الشعارات الكبرى التي تسوق في الإعلام العمومي وفي جلسات البرلمان. التعليم هو مدخل التمكين الاقتصادي، لأن الاهتمام بالتعليم هو الذي من شأنه أن يعزز قدرة الأفراد من أجل الاندماج في النسيج الاقتصادي، وأن يساهم في خلق التنمية الحقيقة. غير ذلك، سيظل الخطاب السياسي ينتج الإفلاس العام مثلما نجد اليوم في حكومة عزيز أخنوش. تبعا لذلك، التدبير الحكومي يعاني من آفة تعدد البرامج الحكومية المحدودة الأثر والفعالية. ففي دراسة أنجزتها منظمة اليونيسف عام 2018 وفق دراسة مسحية أكدت على وجود مشروع اجتماعي يشرف عليه حوالي 50 متدخلا مؤسساتيا. دلالة الرقم فقط تحيل على فشل التدخلات الحكومية.
من جهة أخرى، عمقت جائحة كورونا من واقع هشاشة المجتمع المغربي، وفضحت محدودية التدخلات السياسية في تحقيق التضامن والتماسك الاجتماعي. كل الاستجابات التي تنادي بها الدولة الاجتماعية لا تخرج إذن عن سياق خاص وعام في الآن ذاته. فيُقر الفصل 31 من دستور 2011 على حق الفرد المغربي في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، ويفرض الالتزام الدولي الذي وقعه المغرب الخاص بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للتضامن الاجتماعي الصادرة عن منظمة العمل الدولية، على ضرورة الاهتمام بالمسألة الاجتماعية من أجل تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير الموارد البشرية المؤهلة القادرة على الاندماج السوسيو-اقتصادي.
وعلى مستوى الأرقام، ففي مجال التغطية الصحية يعاني المغرب من خصاص كبير، فهناك 11 سريرا لكل 10.000 نسمة، يقابلها في الجزائر 19 سريرا، 22 سريرا في تونس. ويتخرج سنويا من كليات الطب حوالي 1400 طبيب سنويا نصفهم يهاجرون إلى الخارج. فإذا وضعنا هذه الإحصاءات على طاولة التحليل واستحضرنا مؤشر شيخوخة المجتمع في أفق سنة 2050، حيث سينتقل من أربعة مليون ونصف إلى حوالي عشرة ملايين، تكون الدولة الاجتماعية مندورة من الأساس بخيبة الأمل، لا سيما على مستوى صناديق التقاعد.
- إذن، ما المطلوب فعله من أجل أن يصل صدى ما تخططه الدولة إلى المواطن، وتتحقّق فعلية الدولة الاجتماعية في حياة أيّ مغربية ومغربي ينشد العيش الكريم والكرامة الإنسانية؟
المطلوب، هو تغيير العقلية السّياسية. وهي مسألة جوهرية من أجل تغيير المسار. يقتضي ذلك أولا إعادة طرح سؤال الانتخابات في المغرب والتقطيع الإنتخابي. كيف يمكن أن نفهم أن بعض الوجوه السياسية التي تُدبّر الشأن الحكومي لا ترتبط بصناديق الاقتراع، وكيف نفهم أن أخرى يتم استجلابها من عالم المقاولة والاقتصاد وصبغها بالألوان السياسية...
الحصيلة، نحن هنا أمام فاعلين جدد منفصلين عن هموم وانشغالات المجتمع، بل يمكن أن نستجلي عنصرا آخرا يرتبط بتضارب المصالح ووجود شبهات فساد. والحال، أن العملية الديموقراطية التي تنطلق من القواعد هي التي تجعل المواطن مؤهلا لمحاسبة ومعاقبة الفاعليين السياسيين في الاستحقاقات القادمة. وجب الإقرار اليوم، أن الوضع لم يعد يُدبره الفاعل السياسي، بل أصبح الفاعل الاقتصادي أو ما نسميه بالدارجة «مول الشكارة» هو من يتحكم فيه. وهذا خطر على البناء الديموقراطي مثلما يُنبهنا إلى ذلك المفكر الفرنسي آلان باديو في كتابه «أفول الديموقراطية». وحتى تتحقّق شعارات الدولة الاجتماعية على الدولة أن تسهر على عملية الاستهداف المباشر للفئات المعنية بالدعم في مرحلة أولى، وأن تتصدى لتجار الأزمات التي تستغل كل ورش حكومي من أجل مراكمة الأرباح.
وفي مرحلة ثانية، الانتقال من الدّولة التي تعتمد على منطق الدعم، إلى الدولة التي تعتمد على منطق التمكين الاقتصادي. لا يتحقق التمكين إلا بسياسات عمومية قوية تتوجه رأسا إلى التعليم والصحة والشغل. أو لنقل الانتقال من الدولة حارسة الطرائد Etat gardien de chasse إلى الدولة البستانية Etat Jardinier التي تسقي الجميع بلا استثناء. يواجه ذلك مشكل الاقتصاد غير المهيكل ونظام الاستهداف الذي يُصعِّب تحديد الفئات المستحقة. لكن ثمة تخوف أساس، بخصوص تمويل أوراش الدولة الاجتماعية من خلال المس بالقدرة الشرائية للمواطنين وخاصة صندوق المقاصة.