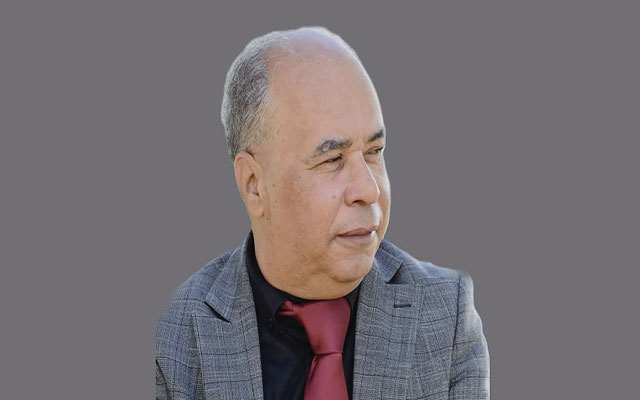يعتبر د. محمد المحيفيظ أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة ابن طفيل، أن معايير تقييم الكتب وقياس جدواها تنبني -حسب رأيه- على ثلاث عناصر أساسية:
أولها؛ المعطيات والمعارف التي توفرها هذه الكتب للقارئ وثانيها؛ المسارات والدروب التي قد تثيرها كمشاريع للبحث مستقبلا، وثالثها؛ الأسئلة التي يمكن أن تولدها في ذهن القارئ وليس فقط الإجابات التي يقدمها الكاتب.
وهكذا فإن قراءة كتاب أذ. محمد الصديقي: "أوراق من دفاتر حقوقي" تستجيب كليا لهذه المعايير، بل وتتجاوزها في نظري المتواضع بتحقيق نوع من المتعة والانجذاب عند قراءة الكتاب ولا سيما منها المرافعات، فضلا عن منافع أخرى في الكتاب، وهي ما سنحاول أن نقف عند البعض منها في هذه الورقة.
من الأسئلة التي تقفز إلى الذهن عند قراءة كتاب الأستاذ الصديقي تتمثل في ماهية الكتاب؟، أي في أي جنس من الكتابة يمكن أن نصنفه. إذ يلاحظ أن مجموعة من القراءات ذهبت إلى اعتباره "سيرة ذاتية" أو ضمن صنف "المذكرات"، لكن الذين يعرفون الرجل وغنى مساراته المهنية والفكرية والنظرية ..إلخ يعرفون أيضا أن ما تضمنه الكتاب لا يغطي كل جوانب مسيرة الرجل وعطاءاته، بل إنه نفسه كان على بينة من هذا الأمر- على ما يبدو- واختار لكتابه عنوانا "محايدا" لا يحيل بالضرورة على أن الأمر يتعلق بمذكرات أو سيرة ذاتية، دون أن يعني ذلك إمكانيات التأويل والفهم المغاير لهذا العنوان الموسوم بـ "بأوراق من دفاتر حقوقي".
مقدمة لمشروع أوسع
بتأمل هذا العنوان قبل قراءة الكتاب، وبعد قراءته تتولد انطباعات وتساؤلات متباينة لعل أهمها بالنسبة لي: ألا يشكل هذا الكتاب مجرد مقدمة/ تمهيد لمشروع أوسع، وأننا قد نترقب أن يكشف ذ محمد الصديقي عن باقي "أوراقه" أو بالأحرى "دفاتره"؟
الذين يعرفون أذ. الصديقي وطبيعة شخصيته، يعرفون بالتأكيد أنه رجل يفضل الظل، ولذلك فحتى مبادرة إصدار هذا الكتاب وأسباب نزوله ما كان لها أن تتم لولا توفر بعض الشروط التي دفعت (وأشدد على هذه الكلمة) المؤلف إلى إصدار هذا الكتاب ضمن نوع من الوفاء بالالتزام بالدرجة الأولى، لذلك نجده يصرح: "إني لست من الأشخاص الذين يجدون لذة أو متعة للحديث عن أنفسهم، لم أكن أتحدث عن نفسي إطلاقا وبصفة عامة، لم أكن أقول أني أنجزت كذا وحققت كذا أو فعلت كذا وكذا… لكن اليوم، أظن أن الظروف تفرض علي الحديث عن ذلك الجانب، والبوح ولو بالقليل مما تيسر منه" (ص 13).
فكرة الكتاب إذا مرتبطة بحدثين متزامنين انتهاء مهام ذ. الصديقي بالمجلس الدستوري في سنة 2017 ورجوعه إلى مكتبه (مكتب المحاماة)، وشروعه في النبش في أوراقه القديمة واسترجاع بعض الصور من الماضي على حد تعبيره في مقدمة الكتاب، وتزامن ذلك مع دعوة النقيب ذ. محمد بريكو نقيب هيئة المحامين بالرباط للأستاذ محمد الصديقي للمشاركة في افتتاح الجلسات الحوارية التي ذأبت الهيئة على تنظيمها، وتم ذلك في ليلة رمضانية امتدت من مساء يوم 16 ماي 2019 الى صبيحة اليوم الموالي (الموافق للعاشر من رمضان 1440 هـ)، والتي أدارها باقتدار وحنكة الأستاذ الراحل الطيب الأزرق المحامي بهيئة الرباط.
كرسي اعتراف
كانت هذه الأمسية بمثابة "كرسي اعتراف" أجاب خلالها ذ. الصديقي على كل الأسئلة التي وجهت اليه ، وكان محتوى هذا اللقاء هو المتن الأساسي للكتاب، ولكن طبيعة وسياق وظرفية هذه التظاهرة، لم تكن تسعف بأن يتوسع أذ. الصديقي في سرد كل عناصر الإجابات الممكنة على مختلف الأسئلة التي طرحت عليه على اختلاف مواضيعها وتشعب بعضها، حيث كان يكتفي بذكر بعض العناصر الأساسية.
فقد اهتدى أذ. الصديقي إلى وضع فهرسة لكتابه تشبه - من حيث الشكل- تلك التي تعتمد في المدونات التشريعية، ولعل ذلك يعود لتكوينه كرجل قانون بامتياز، فجاء المؤلف/ الإصدار في سبعة كتب بالإضافة إلى مقدمة وهي كالاتي:
الكتاب الأول: مسار النقيب وهو بالتحديد محتوى اللقاء الحواري المنظم من قبل نقابة المحامين بالرباط الذي سبق أن أشرنا إليه.
الكتاب الثاني: حمل عنوان "من معارك الدفاع في محاكمات لها تاريخ" وتضمن مرافعات ذ. الصديقي في أربع محاكمات تخص محاكمة: أطلس بلحاج ومن معه أمام محكمة الجنايات بالرباط (يناير 1969) محاكمة عمر بنجلون ورفاقه (19 يوليوز 1976)، وعنونها بـ "المسرحية الهزيلة" ثم محاكمة عبد الرحيم بوعبيد ورفاقه (11 شتنبر 1981) التي عنونها بـ "محاكمة رأي"، ثم محاكمة محمد نوبير الأموي (24 مارس 1992) التي عنوانها بـ "بمحاكمة حرية التعبير" واكتفى فيها بالتذكير بشكل موجز جدا بالسياق الذي تمت فيه المحاكمة وغياب ضمانات المحاكمة العادلة والاستعجال في إصدار الحكم ابتدائيا واستئنافيا، حيث كان الهدف وفق تفسير ذ الصديقي "عرقلة أي انفراج حقيقي".
وضمن نفس الكتاب الثاني تم إدراج النص الكامل للشكاية المباشرة التي تم توجيهها إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط في 5 يوليوز 2001، بشأن ملف الشهيد المهدي بن بركة والمطالبة بفتح تحقيق إثر التصريحات التي أدلى بها أحمد البخاري الذي عمل بجهاز الاستخبارات. كما تم ادراج ملتمس النيابة العامة الكتابي بشأن هذه الشكاية، وكذا التعقيب عليها.
الكتاب الثالث عنونه ذ. الصديقي بـ "مسائل في شؤون العدالة وشجونها" والذي خصصه لبعض الحوارات الصحفية والعروض والمقالات التي تناول فيها بالتحليل جملة من القضايا الهامة من قبيل، محاربة الرشوة والفساد، إصلاح قانون المحاماة، مراجعة التشريع الجنائي المغربي، حكامة واستقلالية القضاء…الخ .
الكتاب الرابع عنونه ذ. الصديقي بـ "في معترك الحقوق والحريات"، وخصصه لبعض المحطات الأساسية في تاريخ الحركة الحقوقية سواء في جانبها المدني (الجمعوي) أو في جانبها المؤسساتي ، و لاسيما سياق تأسيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وخلفيات القبول بالمشاركة في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
كما تضمن هذا الكتاب حوارات صحفية ومقالات وعروض تناولت مواضيع وإشكاليات هامة حول ثقافة حقوق الإنسان وتوطيدها في المجتمع وعلاقة الديمقراطية بحقوق الإنسان وفلسفة الانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية وإصلاح منظومة العدالة ومهنة المحاماة…إلخ.
الكتاب الخامس خصصه ذ. الصديقي لتقديم شهاداته في حق العديد من الشخصيات التي عرفها عن قرب، وعمل الى جانبها (عبد الرحمن اليوسفي، عبد العزيز بناني وعبد الواحد الراضي).
الكتاب السادس خصصه ذ. الصديقي للكلمات التأبينية التي ألقاها في حق شخصيات حقوقية وسياسية وأكاديمية معروفة (عبد الرحيم بوعبيد، عبد الرحمن القادري، عبدالرحيم المعداني، محمد بوزوبع، احمد الشاوي، لطيفه التازي، ادريس السغروشني).
أما الكتاب السابع فقد خصصه ذ. الصديقي لنشر صور ووثائق ومستندات منتقاة من أرشيفه الخاص، إذ يلاحظ أن هذا الانتقاء قد تم بعناية، لكون تلك الدعائم لها صلة مباشرة بأحداث ووقائع ومواقف وردت فيما سبق وتناولها أذ. الصديقي في متن الكتب المشكلة لهذا الإصدار، وهي بذلك تزيد من تعزيز مصداقية روايته وشهادته عن الأحداث التي تطرق إليها.
مؤلف لجمهور متعدد
فكتاب ذ. الصديقي "أوراق من دفتر حقوقي"، يعطي الانطباع بأنه مؤلف موجه لنوع معين من القراء المفترضين (مهنيو القانون، نشطاء حقوق الانسان، النخب الحزبية…)، لكن بمجرد الانتهاء من قراءة الكتاب، يتوارى هذا الانطباع ويتضح أن متن المؤلف أو بالأحرى متونه جديرة بالقراءة ومتاحة لجمهور أوسع ومتعدد، ففيه يجد المؤرخ والصحفي والحقوقي والسياسي والطالب وعموم القراء ضالتهم لمعرفة تفاصيل هامة ودالة من تاريخ المغرب الذي لم يكتب بعد (أقصد التاريخ الراهن الذي يغطي العقود الأربعة التي أعقبت الاستقلال).
الى جانب المضامين والأفكار التي يزخر بها كتاب ذ. الصديقي، هناك أيضا اللغة التي ميزت كتابة هذا المؤلف، والتي تجعل قراءته تحقق للمتلقين نوعا من المتعة، إذ اعتمد أسلوبا مبسطا وميسرا وسلسا في التعبير عن أفكاره، ويبرز ذلك بشكل جلي أكثر في نصوص المرافعات الكتابية، الى جانب الحرص على تأصيل المفاهيم وتحديد مدلولها، والدقة والتمحيص في عرض الوقائع وإسنادها بالوثائق والمراجع كلما تيسر له ذلك.
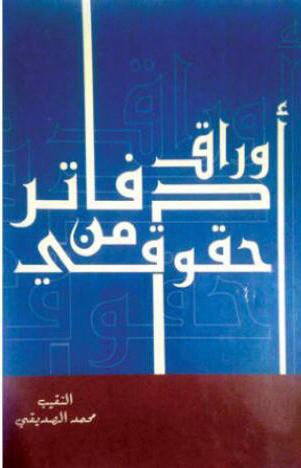
وقد يعود ذلك للتجربة الصحفية للمؤلف، الذي قادته الظروف ونداء الواجب الى تولي مسؤولية إدارة تحرير الجريدة الناطق باسم الحزب الذي انتمى إليه وتحمل فيه مسؤوليات قيادية (الاتحاد الوطني للقوات الشعبية- الاتحاد الاشتراكي) في مرحلتين؛ الأولى عندما نودي عليه لتولي مسؤولية سكرتير تحرير جريدة «التحرير» من يوليوز 1961 إلى يوليوز 1963 وهو شاب لم يتجاوز 22 سنة، وذلك خلفا للراحل محمد عابد الجابري الذي التحق بالتدريس.
وعن هذا التكليف يشير ذ. الصديقي إلى أنه عندما طلب منه تولي هذه المسؤولية «فانه لم يكن من السهل علي الاجابة على عجل، ولذلك فإني أخذت بعض الوقت لأفكر في الأمر جيدا، غير أن هذا التفكير لم يدم طويلا، لأنه لم تمضي الا بضعة أيام حتى اتخذت قراري وأنا أقول في نفسي هذه فرصة ستتاح لي لمواصلة السير في الطريق التي اخترت أن أسلكها عندما التحقت بالحركة الوطنية وأنا ابن الخامسة عشر من عمري».
المرحلة الثانية التي تحمل فيها أذ. الصديقي مسؤولية إدارة جريدة «الاتحاد الاشتراكي» امتدت من نونبر 2003 إلى مارس 2006، وهي أيضا مرحلة معقدة بالنظر لقرار الراحل ذ. عبد الرحمان اليوسفي الاستقالة من قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية واعتزال العمل الحزبي بصفة نهائية، وكذا تداعيات هذا القرار، ولا سيما على الحياة الداخلية للحزب وضمنها جريدته.
بصمات في الأحداث التاريخية
وكان للأستاذ محمد الصديقي بصمات واضحة، في العديد من الأحداث التاريخية، منها حملة مقاطعة دستور 1962 والوقائع التي أعقبتها والتي توجد بعض تفاصيلها في الكتاب، والتي كان من تداعياتها توقيف صدور الجريدة وإغلاق مقرها والاعتقالات والمحاكمات التي تمت في تلك الفترة، أما التجربة الثانية ورغم صعوبة الظروف التي تولى فيها أذ. الصديقي مسؤولية إدارة الجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، فإن العديد من الشهادات تجمع على نجاحه في المهمة التي أوكلت إليه، كما أنه أعطى المثال في حسن التدبير والترشيد ونظافة اليد، والزهد لدرجة التنازل عن حقوقه كمدير، بامتناعه عن تلقى أي تعويض أو أجر عن مهمته بما في ذلك المصاريف الأساسية (التنقل- الإقامة- التغذية)، وهي القناعات نفسها التي طبعت المسيرة المهنية للأستاذ محمد الصديقي، والتي كانت محل إجماع في كل الشهادات التي قدمت خلال تلك الأمسية الرمضانية (16 ماي 2019) في ضيافة نقابة هيئة المحامين بالرباط، ولعل أكثر الشهادات وضوحا وعمقا كانت تلك التي أدلى بها كل من الأساتذة: حمادي ماني وعبد الوهاب المريني ومحمد أشركي.
التمسك بتقاليد المهنة وارتباط بالمجتمع
وهكذا توجه أذ. ماني إلى ذ. الصديقي بالقول: «لقد فهمت شيئا أساسيا منكم ومن رموز هيئة الرباط، فهمت أن المحامين لا يتوفرون على أسلحة دمار شامل، وأن قوتهم إنما تكمن في أخلاقهم وثقافتهم وعلمهم، وفيما يتمتعون به من مصداقية، وفي تمسكهم بتقاليد المهنة وأعرافها، وفي ارتباطهم بالمجتمع الذين ينتمون إليه.
أني متأكد من أن هذا ما فهمته وتلقيته عنكم عندما قمت بزيارتكم خلال شهر يناير 1979 في إطار تقاليدنا المهنية وأوضحت لي انه لابد للمحامي أن يتشبع ويتشبث بالأخلاق قبل كل شيء لأنها سلاحه في تعامله مع الآخرين».
أما شهادة ذ. عبد الوهاب المريني فقد عددت مناقب ذ. الصديقي والذي وصفه بالنموذج النادر من الرجال «الذين طبعوا الحياة المهنية بطابع النزاهة، وترسيخ قيم الصدق،والوفاء والاخلاص، والأمانة في ممارسة مهنة المحاماة… مفاوض صبور وحازم ومدافع صلب عن المحاماة… عنيد عن حق في مواقفه، صلب في اختياراته، عادل في قراراته، نزيه في معاملاته، متواضع في سلوكه… لكنه متواضع في حزم، لا يستطيع معه أحد أن يتجرأ عليه أو تخطي حدود الوقار والاحترام في حقه…. قيادي من الطراز الرفيع في كل المجالات المهنية والسياسية، يعرف متى يتكلم نطقا ومتى يتكلم صمتا».
بينما كشف الأستاذ محمد أشركي الرئيس السابق للمجلس الدستوري ما بين سنتي 2008-2017 عن بعض الهواجس والتوجسات التي راودته عندما جرى تنصيب أعضاء المجلس الدستوري ومن ضمنهم كان أذ الصديقي، لكن سرعان ما تبدد كل ذلك ، إذ أشار بالقول: «عندما عين محمد الصديقي من طرف جلالة الملك عضوا في المجلس الدستوري في نفس التاريخ الذي عينت فيه أنا كذلك، طرحت على نفسي سؤالا مفاده أن هذا الرجل له تجربة غنية وواسعة في المحاماة التي كان معروفا جدا في ميدانها، وأيضا كان يتوفر على تجربة سياسية من خلال عضويته في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكذلك تجربة إعلامية، حيث كان مدير لصحيفة «الاتحاد الاشتراكي» بعد مروره بجريدة «التحرير». هذا الرجل بهذا الوزن، هل بمقدوره أن يندمج في القضاء الدستوري الذي له خصوصيته التي تتمثل في القدرة على تأويل أحكام الدستور العامة؟ وهل تكون له القدرة كذلك على الغوص في ملفات المنازعات الانتخابية بما يتطلب من تحقيقات ومتابعات؟
واليوم أقول أمامه، وأيضا أمامكم، أنني فوجئت مفاجئة سعيدة، عندما تبين لي، أنه تمكن في أن يندمج بسرعة في ممارسة العمل القضائي للمجلس الدستوري، وأن يحمل إليه معه كل خبرته القانونية وقدرته على التفكير القضائي»
مدافع شرس ونزيه عن المحاماة
أذ. محمد الصديقي النقيب والمدافع الشرس عن مهنة المحاماة، وبنزاهة فكرية ودون أي نوع من التعصب الأعمى للانتماء المهني، نجده في نفس الآن يقدم رأيه الصريح والنقدي والشفاف في وضعية المهنة في الوقت الراهن بعبارات واضحة ومباشرة: «بكل صدق لا أخفيك، كمحامي ونقيب سابق، أني لست مرتاحا لما توجد عليه المهنة اليوم، نظاما وممارسة، وكذلك أنى لست وحدي من يحمل هذه النظرة لواقع مهنتنا حاليا وما تعانيه من أزمة خانقه تكاد تعصف بالمهنة إن لم يقع تدارك ما تعيشه من أوضاع مقلقة.
إن هذا الواقع هو نتاج عدة عوامل مجتمعة، أولها هو التحولات المجتمعية التي عرفتها وتعرفها البلاد منذ سنوات، والمحامون لا يمكن أن يكونوا بمنأى عن هذه التحولات والآثار السلبية منها على وجه الخصوص، والعامل الثاني هو ما اعتبره تخليا من جانب الدولة عن مسؤوليتها في إعادة تنظيم المهنة تنظيما محكما وجيدا لتطويرها بما يلائم متطلبات المرحلة، ولمعالجة جوانب القصور ومكامن الخلل في ممارستها سواء من حيث تجلياتها الظاهرة أو من حيث أسبابها العميقة.
«أما العامل الثالث - يضيف أذ الصديقي- فهو عدم تمكين المسؤولين في التنظيمات المهنية للهيئات من التحكم في المسارات التي انزلقت إليها ممارسة مهنة المحاماة في الواقع الملموس يوميا. ونتيجة لكل ذلك، فان مهنتنا تعيش اليوم حالة صعبة للغاية من الارتخاء والهزيل، وهي بحاجة أكيدة إلى «رجة قوية تعطيها انبعاثا جديدا يعيد لها وهجها المتوقد».
دور مهنة المحاماة في تأسيس الحركة الحقوقية بالمغرب، والنهوض بأعباء الدفاع عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، بل حتى في الدفاع عن المتابعين في المحاولتين الانقلابيين (يوليوز 1971- غشت 1972) الذين لا يشاركهم في القناعات ولا التوجهات البلانكية، من بين المواضيع التي عالجها ذ. الصديقي في سياقات مختلفة في كتابه الذي يذكرنا فيه بأن مكتب المحاماة الذي بدأ فيه مسيرته المهنية (مكتب الراحل ذ. عبد الرحيم بوعبيد) «كان ملجأ للعديد من المواطنين الذين كانوا يجدون فيه ملاذا لهم مما كانوا يعانون من مظالم وخاصة في ما يتعلق بالاعتقالات التعسفية والانتهاكات التي لم تكن تخلو منها أي جهة من الجهات»6، والأكيد أن هذا الدور الحمائي للحقوق والحريات الذي اضطلع به قطاع المحاماة في الحقبة التي تحدث عنها أذ. الصديقي كان ضمن الانشغالات الأساسية للعديد من المحاميات والمحامين الذين كانوا يتطوعون لمؤازرة المستضعفين قبل أن يتوارى هذا الدور تدريجيا.
الارهاصات الأولى لتنظيم العمل الحقوقي:
يقف أذ. الصديقي أيضا عند أولى محاولات هيكلة وتنظيم العمل الحقوقي، منها، تأسيس «جمعية الحقوقيين المغاربة» سنة 1975 بمبادرة من مجموعة من المحامين والجامعيين والقضاة، ويتوقف عند الدور الريادي للراحل ذ. عبد الرحمن القادري في إشعاع هذه الجمعية وتحقيقها للعديد من المكتسبات، لعل أهمها قبول الملك الراحل الحسن الثاني لملتمسها بالعفو عن عشرات المعتقلين السياسيين سنة 1977، واهتمامها المبكر بأوضاع السجون والسجناء والمساهمة في نشر الوعي بحقوق الإنسان، والانضمام إلى شبكات جهوية ودولية.
كما يذكر أذ. صديقي بانخراطه في تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سنة 1979، ثم مساهمته الوازنة في تأسيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان سنة 1988 ، ويعرفنا أيضا بالدور الرئيسي الذي لعبه ذ. عبد العزيز بناني داخل المنظمة ويشير كذلك للظرفية الصعبة والمعقدة التي تمت فيها عملية التأسيس، كما يستحضر المحاولات التي تمت لتوحيد الحركة الحقوقية بمحاولة إدماج كل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في المشروع التأسيسي لمنظمة حقوقية مستقلة عن الدولة وعن الأحزاب السياسية ، والمقاومات التي لقيتها هذه المبادرة.
في هذا السياق تجدر الاشارة الى إن كتابة تاريخ الحركة الحقوقية بالمغرب، ورغم عدة محاولات، لازال يكتنفه الغموض ولا زالت هناك «بياضات» نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
• نشأة أولى التنظيمات الحقوقية المغربية، حيث دأب العديد من الباحثين والصحفيين على التأكيد أن أولى التنظيمات الحقوقية قد تأسست في 11 ماي 1972 بمبادرة من حزب الاستقلال، ويتعلق الأمر بالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بينما يعتبر ذ . خالد الناصري في ورقة بحثية حول: «منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان المغربية»، صادرة ضمن مؤلف جماعي صدر سنة 1994 باللغة الفرنسية، أن الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 1972، قد شهدت تأسيس «اللجنة الوطنية لمناهضة القمع» بمبادرة من شخصيات وطنية وضمت كلا من الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ،واتحاد كتاب المغرب ،والإتحاد الوطني للمهندسين ،والنقابة الوطنية للتعليم العالي ،واتحاد المحامين الشباب.
• ولمح ذ. الناصري إلى أن إقدام حزب الاستقلال على تأسيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، كان بالأساس جوابا على «عدم رضاه وتحفظه على بعض مكونات»اللجنة الوطنية لمناهضة القمع»، وتوجهات بعض أعضائها المتياسرة»، هذه المعلومة التي وفرها لنا ذ. الناصري باعتباره شاهدا وفاعلا في تلك المرحلة، كما هو الشأن بالنسبة للأستاذ محمد الصديقي لا نجدها ضمن «أوراق من دفاتر حقوقي». ولعل ذلك يعود بالأساس لطبيعة المؤلف وخصوصيته التي حاولنا إبرازها سلفا.
• من جهة أخرى تكتسى شهادة أذ. محمد الصديقي الواردة في كتابه حول الظروف التي أحاطت بإحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في 8 ماي 1990، أهمية بالغة في هذا العمل الجماعي المطلوب في كتابة تاريخ الحركة الحقوقية المغربية، وهذا ما تم التطرق إليه في ورقة بحثية نشرت بالعدد الثالث من مجلة «دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية» في يونيو 2022 حيث تم التأكيد على أن تأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان قد حكمه سياق خاص، من جهة تنامي الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية و من جهة أخرى تواتر التقارير الدولية المنتقدة لتدهور أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب لذلك فإن إحداث مجموعة من المجالس، وبالنظر للظرفية الاجتماعية السياسية لتلك المرحلة، كان محكوما بهواجس «التهدئة»، بعد تصاعد وثيرة الإضرابات العمالية، وبروز حركة الشباب المعطلين وخروجها للتظاهر في الشارع العام، فضلا عن تفاقم الوضع الحقوقي، وعودة المطالب السياسية بإصلاح منظومة الحكم والمراجعة الدستورية، فكلها عوامل ساهمت بهذا القدر أو ذاك في التسريع بإيجاد صيغ لنوع من الحوار والتداول بشأن الحلول الممكنة لبعض المعضلات التي باتت تهدد استقرار منظومة الحكم، لاسيما بعد المخلفات الكارثية لبرنامج التقويم الهيكلي P.A.S (1983-1993) الذي فرضه صندوق النقد الدولي FMI على المغرب، إثر الاختلالات الهيكلية التي عرفها الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي للبلاد في تلك المرحلة واستمرت آثاره المدمرة لعدة سنوات.
• المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان: من الوجود بالقوة الى الوجود بالفعل
وعلى المستوى الحقوقي، شكل تأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 1990 محطة هامة ضمن التحولات اللاحقة التي شهدتها بلادنا في المراحل اللاحقة على الرغم من أن السياق الخاص لإنشائه كان هو «غسل وجه المغرب» حسب تعبير الملك الراحل الحسن الثاني في خطاب تنصيب الأعضاء في 8 ماي 1990، فقد ضاق الملك درعا بتقارير المنظمات الدولية غير الحكومية حول تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب ولاسيما أوضاع المعتقلين السياسيين، سواء في السجون النظامية، أو في المعتقلات السرية (تازمامرت، أكدز، قلعة مكونة).
لقد كانت الدولة آنذاك تنازع في وجود معتقلين سياسيين، كما نفت وجود معتقلات سرية، حيث أُرٍيدَ للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن يلعب دورا لتفنيد تقارير تلك المنظمات ولاسيما منظمة العفو الدولية التي وردت حصرا في خطاب الملك الراحل السالف الذكر.
لكن ينبغي الإشارة بالمقابل إلى أن نفس الخطاب حمل إشارات أخرى لما كان منتظرا من المجلس أن يقوم به من أدوار، ولاسيما منها العمل على استكمال بناء دولة القانون: «التي نريد قبل كل شيء أن نضع حدا للقيل والقال فيما يخص حقوق الإنسان كي ننهي هذه المسألة، ... ولإعطاء المواطنين الوسيلة القانونية والسريعة والجدية وذات الفعالية للدفاع عن حقوقهم كمواطنين إزاء الإدارة أو السلطة أو الدولة نفسها»، كما جاء في خطاب الملك الراحل الحسن الثاني الذي ناشد أعضاء المجلس بأن يكونوا عونا له من أجل «إرجاع الحق لمن اغتصب منه... وأن نرفع جميعا هذا البلد إلى مستوى الدول المتحضرة، دولة القانون. وأناشدكم أخيرا أن تكونوا حقيقة أنتم المدافعون، إيجابيا أو سلبيا. إيجابيا أن تقولوا: نعم في هذا الملف خرقت حقوق الإنسان، أو سلبيا في هذا الملف لا خرق لحقوق الإنسان، وإنما هذا كذب وتلفيق وزور».
آلية للانتصاف
فتأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كرس ما بات يعرف بآلية الانتصاف، شأنه في ذلك شأن ديوان المظالم الذي أحدث في 9 دجنبر 2001، قبل أن يتحول إلى مؤسسة «وسيط المملكة» بمقتضى الظهير الصادر في 17 مارس 2011 وليعوض بالقانون رقم 14.16 الصادر في فاتح يونيو 2019.
وبذلك أسندت وظيفة جديدة للهيئات الاستشارية وهي وظيفة حماية الحقوق والحريات، التي ستجد سندا مرجعيا دوليا لها في مبادئ باريس سنة 1993، بعد أن كان المؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان بالعاصمة النمساوية فيينا في نفس السنة، وتحت إشراف الأمم المتحدة، قد وضع هندسة جديدة لمنظومة حقوق الإنسان وخريطة طريق تحت عنوان: «إعلان وبرنامج عمل فيينا».
لقد سلطت شهادة الأستاذ النقيب محمد الصديقي الضوء على الأجواء التي ميزت أشغال أولى دورات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وسعي بعض الأطراف النافدة إلى حصر دوره في مهمة «الغسل» أو «تبييض» لوجه الدولة في مواجهة الخارج، في المقابل كانت هناك مواقف، حتى وإن كانت تعبر عن رأي أقلية (ويتعلق الأمر بالموقف الذي عبرت عنه المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ممثلة بالأستاذ محمد الصديقي)، فإنها استطاعت تغيير مجرى الأمور.
يُورِد أذ. الصديقي في شهاداته هاته أنه: في «اليوم الموالي أي 29 يونيو 1990 بادرت رئاسة المجلس إلى تلاوة نص مشروع توصية، اعتبرتها كأنها خلاصة لدراسة النقطة المحددة في جدول الأعمال وعلى أساس أن الموضوع استوفى كل عناصر البحث في حين أن الأمر لم يكن كذلك. وما كان مثيرا للاستغراب أكثر – يقول الأستاذ الصديقي- هو: «أن الفقرة الرئيسية في مشروع التوصية تضمنت إعلانا لموقف حاسم في موضوع الاعتقال السياسي، من خلال التأكيد على أنه لا وجود لأي معتقل سياسي في المغرب، وأن سجون البلاد خالية من هذا النوع من المعتقلين، والحال أن هذا الموضوع لم نتناوله بالدراسة، ولم تجرى مناقشته من طرف المجلس طوال اليومين المخصصين للاجتماع». واعتبر أذ. الصديقي أن هذا الأمر كان مجرد «مناورة كادت أن تعصف بالمشروع»، ويقصد بذلك مشروع المرحوم الحسن الثاني بإحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالوظائف التي حددها له في خطابه، ذلك أن تمرير هذه التوصية كان سيؤدي إلى انسحاب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من المجلس مع ما يمكن أن يتبع ذلك من انسحابات أخرى محتملة وفق شهادة أذ. الصديقي، لكن فطنة المستشار الملكي أحمد رضا آكديرة
آنذاك من خلال طلب رفع الجلسة وتأجيل الاجتماع أدت عمليا إلى إفشال تلك المناورة، إذ عند استئناف أشغال الدورة من 6 إلى 12 يوليوز 1990 «لم يتم فقط تجاوز التوصية التي كانت تُنكر وجود المعتقلين السياسيين في البلاد، والاتفاق على تكوين مجموعة عمل.. وإنما تحولت كذلك إلى منبر للتداول في ضرورة معالجة قضايا الاعتقال السياسي في مجملها».
توجه إصلاحي ومكتسبات
إن هذا التوجه الإصلاحي هو الذي مكن من تحقيق مجموعة من المكتسبات من قبيل مجمل الإجراءات والقرارات الهامة اللاحقة والتي شملت بالأساس مراجعة التشريع الجنائي والسجني والشروع في معالجة ملفات المعتقلين السياسيين والمنفيين وضحايا الاختفاء القسري، وصولا إلى عمل هيئة التحكيم المستقلة (غشت 1999- نونبر 2003) وهيئة الانصاف والمصالحة (يناير 2004- دجنبر 2005) ، من خلال ما يستفاد من شهادة الأستاذ الصديقي الذي أضاف أنه بين التوجه الرامي إلى جعل المؤسسات مجرد واجهة» تبيض وجه الدولة»، وبين التوجه الرافض للعمل من داخل المؤسسات، كان هذا التوجه الإصلاحي هو عنصر التوازن الذي حقق للمؤسسة (المجلس الاستشاري لحقوق الانسان) مشروعية الإنجاز .
معركة الاختفاء القسري
إذا شكلت لحظة انعقاد الدورة الأولى للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، امتحانا حقيقيا للأستاذ محمد الصديقي وطبعت مساره الحقوقي، وجعلت رصيده من المصداقية والنزاهة الفكرية والجدية يتعزز، فإن لحظة أخرى ضمن هذا المسار كانت بغير قليل من الصعوبة والتعقيد، ويتعلق الأمر بدورة أبريل 1999 للمجلس استشاري لحقوق الإنسان والتي كان ضمن جدول أعمالها، المصادقة على توصية مرفوعة للملك بشأن الاختفاء القسري» وهي كما وضعها أذ. الصديقي، تتشكل من محورين:
«المحور الأول، هو الإقرار بوجود هذه الحالات، حالات الاختفاء القسري، المحصورة في 112 من جهة، والإقرار من جهة أخرى بأن هذا الاختفاء القسري تعود المسؤولية فيه إلى الدولة المغربية وإلى أجهزتها وإلى أعوانها؛
المحور الثاني، هو طلب المجلس من الملك المصادقة على إحداث هيئة مستقلة بجانب المجلس، يعهد إليها بمهمة التعويض لضحايا الاختفاء القسري، سواء من كان منهم على قيد الحياة أو لذوي حقوقهم بالنسبة للذين توفوا منهم».
لم يكن قرار موافقة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ممثلة بالأستاذ محمد الصديقي، قرارا سهلا، حيث كان كل أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قد حسموا أمرهم بتأييد التوصية، في المقابل كانت الأصوات المناهضة لها تتعالى وتتزايد لاسيما من قبل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الذين انتظموا في إطار المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف والذي سطر ضمن أهدافه خلال مؤتمره التأسيسي في نونبر 1999، المطالبة بإحداث «هيأة وطنية لإجلاء الحقيقة بشأن كل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ورفض المقاربة المعتمدة فقط على «التعويض المادي» للضحايا وذوي حقوقهم. وبين الموقفين المؤيد والرافض للتوصية.
وكان أذ. الصديقي في وضع حرج وجاء في شهادته: «... لا أخفي عنكم أني كنت في وضعية صعبة، جد صعبة، كان الوقت مساءا من يوم ثاني أبريل سنة 1999 وكنت أقدر جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقي، كنت أوازن بين ما أراه أمامي من استعداد جميع أعضاء المجلس للإمضاء وما يخالجني من مساءلة: هل من حقي أن أوقع كذلك على هذه التوصية أم من واجبي ومن مسؤولياتي أن أرفض؟ وعشت ساعتين ممزقا بين شطري هذا السؤال.
ولكن الموازنة التي قمت بها، من جهة، بين شخصي كإنسان في مواجهة بقية الأعضاء المستعدين جميعهم للتوقيع، ثم، من جهة أخرى، مع المرحلة التي يعيشها المغرب «ونحن في قلب مرحلة التناوب» وإمكانية أن تخلق هذه التوصية ديناميكية فعالة لمعالجة إشكالية الاختفاء القسري، ومن خلالها معالجة باقي القضايا المتعلقة بالانتهاكات... كما تراءت لي النتائج المحتملة التي قد تترتب من رفض التوقيع عليها... كنت على يقين تام بأن رفض عضو واحد التوقيع سيؤدي إلى إيقاف العملية... عملية معالجة الملف برمته ثم حفظه على الرف بدلا من الدخول إلى مرحلة جديدة تستمر فيها المطالب وتتعزز فيها مكتسبات القوى الحقوقية، وقررت في الساعة الأخيرة من مساء ذلك اليوم أن أوقع على التوصية...
من هيئة التحكيم الى الإنصاف والمصالحة
مساهمة أذ. الصديقي في تجربة «هيئة التحكيم المستقلة للتعويض» والتي امتد عملها من 1999 الى 2003، عززت قناعته بأهمية وجدوى وصواب قراره بالموافقة على توصية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (توصيه 2 أبريل 1999)، على الرغم من المجهود الذي بذله المؤلف في توثيق العديد من الأحداث والوقائع، لا يشير الى السياق الذي واكب عمل هذه الهيئة ولا سيما بروز «فاعلين جدد»، واخص بالذكر المرحوم إدريس بنزكري والأدوار الطلائعية التي اطلع بها في قيادة المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، وكذا دوره المحوري في تنظيم المناظرة الوطنية الأولى حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب في إطار عمل مشترك ما بين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف (نونبر 2001)، والتي كانت إحدى توصياتها الأساسية «تشكيل هيئة وطنية للحقيقة» يغطى عملها العقود الأربعة التي تلت الاستقلال (1956-1999) وحددت لها أربعة أهداف:
1. البحث عن الوقائع والأحداث وملابسات ارتكاب تلك الانتهاكات الجسيمة،
2. التحقيق والتثبيت من مصادر هذه الانتهاكات وتحديد المسؤوليات وإصدار التوصيات بشأنها،
3. إعداد تقرير بشأن أشغال ونتائج الهيئة ونشره.
4. إعداد توصيات بشأن التدابير والإجراءات المتعين اتخاذها لجبر الأضرار ورد الاعتبار للمجتمع وحفظ ذاكرته، وكذا بشأن الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية والتربوية والثقافية والإعلامية والحمائية لتفادي تكرار ما حدث في الماضي.
هذه الأهداف هي التي ستشكل أرضية الحوار الذي تم بين المرحوم بنزكري ورفاقه من جهة وممثلي الدولة وسينتهي صدور توصية من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في 14 أكتوبر 2003 بشأن «إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة»، وتتضمن تلك التوصية نفس الأهداف الواردة في توصية المناظرة الوطنية السالفة الذكر وبعدها في يناير 2004 سيعين المرحوم ادريس بن زكري رئيسا لهيئة الإنصاف والمصالحة، التي سينتهي عملها في مطلع 2006 بتقديم تقريرها النهائي الى الملك.
بالعودة إلى كتاب أذ. الصديقي، وعلى الرغم من الاختلاف الواضح بين تجربة «هيئة التحكيم المستقلة» وتجربة «هيئة الإنصاف والمصالحة»، والتي أبرزت أحد جوانبها الأساسية. نجد أن أذ. الصديقي يعتبر أن «هيئة الإنصاف والمصالحة»...، «إنما هي استمرار لهيئة التحكيم في منطلقها وفي هدفها كذلك.
المنطلق هو العمل على طي صفحة الماضي ومعالجة ملف الانتهاكات الجسيمة التي عرفها هذا الماضي في مجال حقوق الإنسان، والهدف هو الكشف عن الحقيقة في ما جرى بإجراء التحريات وتلقي الإفادات والاطلاع على الأرشيفات الرسمية واستقصاء المعطيات التي توفرها أي جهة… واضافة الى ذلك فإن هيئة الإنصاف والمصالحة، كان مطلوبا منها أن تعد في نهاية أشغالها تقريرا عن أشغالها رسميا يتضمن تحليل الانتهاكات والظروف التي جرت فيها وآثارها بدون أي ذكر أو تعويض للأفراد المسؤولين عنها.
وهنا تلتقي التوصية المتعلقة بإحداث «هيئة الإنصاف والمصالحة» مع التوصية الصادرة في 2 أبريل 1999، فلا فرق إذا في العمق بين هذه التوصية ومثيلتها التي على أساسها جرى إنشاء «هيئة الإنصاف والمصالحة» مادام قد تم التنصيص ضمن الاهداف المحددة لهذه الأخيرة كذلك على انه لا يمكن لها مسائلة أو إجراء أي متابعة ضد الأشخاص المسؤولين، هناك فقط مسؤولية الدولة والاكتفاء فقط بالإشارة إلى مسؤولية الدولة.
ما بين التراكم والترصيد والقطيعة
في مقابل رؤية أذ. الصديقي لعمل هيئتي «التحكيم» و»الإنصاف والمصالحة» من زاوية التراكم والترصيد وليس من زاوية القطيعة، يطلعنا أذ. الصديقي عن موقفه من أحد أهم انشغالات هيأة الإنصاف والمصالحة. والأمر يتعلق باستكشاف الحقيقة وذلك في العرض الذي قدمه أمام ندوة نظمت بطنجة في 17- 18 شتنبر 2004 حول مفهوم الحقيقة والتي يؤكد فيها على فكرتين أساسيتين:
الأولى؛ أن حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في العقود الأربعة التي تلت الاستقلال ليست من الأمور المجهولة أو غير المعروفة بل الأمر يتعلق بالأساس بالاهتداء إلى الصيغة الملائمة، أو الاكثر ملائمة، إعلان الحقيقة، والجهر بها رسميا، حول كل ما جرى وكيف جرى… المهم اليوم بالدرجة الاولى، وبالنسبة للغد والمستقبل كذلك، وبعد معالجته تجاوزات الماضي، هو ضمان عدم تكرار ما جرى».
والثانية تأكيده أن نجاح تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة باعتبارها صيغة من صيغ العدالة الانتقالية تمت في إطار ما عرف بالتغيير داخل الاستمرارية تستوجب توفر «توافق واضح بين كل القوى المعنية، ولكن ليس أي توافق، بل توافق جدي مبني على أسس صلبة وغير قابلة للانزلاق أو النقد في أي لحظة من اللحظات، خاصة وأن المجتمع مقتنع اليوم بأن ما عاشته بلادنا وما عانت منه لا يمكن القبول بتكراره بأي حال من الأحوال».
تعاطى استشرافي مع القضايا الحقوقية
هذا البعد الاستشرافي في منهجية تعاطي أذ. محمد الصديقي بعض القضايا الحقوقية ذات الأهمية الكبرى نجده حاضرا في المواضيع التي وردت في الكتاب لاسيما في الحوارات الصحفية والمحاضرات والمذكرات الترافعية، كما نقف عند تأصيل نظري عميق لمجموعة من المفاهيم الحقوقية والنبش في حفريات بناء هذه المفاهيم كالقراءة التي قدمتها للمادة 11 إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتعلقة بمبدأ «البراءة هي الأصل» (ص 305-306)، أو كيف أصل لمفاهيم الحريات العامة والحريات الفردية والانتقال الديمقراطي (ص 319-329) ... إلخ.
لكن الملاحظة التي يمكن الوقوف عندها بشأن التطور التاريخي لمؤسسة حماية حقوق الإنسان عبر إحداث ما أصبح يعرف بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي أورد ذ. الصديقي أهم تفاصيلها في حواره المنشور في الصفحات (207-317)، أغفل حدثين هامين في هذا المسار الأول يتعلق بأول مؤتمر دولي من نوعه تنظمه الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان بالعاصمة النمساوية فيينا سنة 1993، الذي تمخضت عنه ما بات يعرف في الأدبيات الحقوقية الدولية بـ «إعلان وبرنامج عمل فيينا» وهو عبارة عن خطة عمل مشتركة لتعزيز العمل في مجال حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وجاء هذا المؤتمر في ظرفية متميزة بتداعيات انهيار جدار برلين، ورسخ المفاهيم الأساسية حول كونية حقوق الانسان وعدم قابليتها للتجزيء وكذا وضع نظام حكامة جديدة لمنظومة تدبير حقوق الإنسان بإحداث آليات جديدة أكثر نجاعة وأكثر فعالية في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها دوليا وقطريا، منها آلية الاستعراض الدوري الشامل وخلق مجلس حقوق الانسان .
الحدث الثاني هو صدور ما بات يعرف بمبادئ باريس، التي تبلورت سنة 1991 وتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993 وهي الإطار المرجعي الدولي المعتمد لإحداث المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتحديد المعايير الواجب توفرها في هذه المؤسسات، من حيث وضعها القانوني وتكوينها وولايتها.
ملائمة التشريع مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان
أما عن النظرة الاستباقية للأستاذ محمد الصديقي تكفي الإشارة في جانب منها إلى المقترحات العملية التي قدمها في 10 يونيو 1994 بشأن ملائمة التشريع الجنائي المغربي مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكذا ترافعه عن فكرة إعداد ميثاق وطني حول العدالة يكون نتاج لحوار وطني، وذلك 14 سنة قبل أن تجد هذه الفكرة طريقها إلى التنفيذ»، وأيضا ترافعه على مبدأ استقلالية النيابة العامة الذي استغرق تنفيذه 16 سنة بين المطلب (2001) والإعمال (2017)، وهذا الأمر يحيلنا على مقولة «الفرص الضائعة»، وهي «ظاهرة» لا ترتبط بهذا المجال فقط (العدالة والقضاء...) بل تشمل مجالات عديدة حيث يتم بلورة المقترحات والأفكار لمعالجة الاختلالات وإصلاح أوضاع بعض المرافق أو المؤسسات، لكن الزمن الفاصل بين تبلور الفكرة وإنضاجها وتبنيها من قبل صناع القرار، تم الشروع في تنفيذها، زمن لا يخضع دائما لاعتبارات موضوعية وعقلانية.
خلاصة القول، كتاب «أوراق من دفاتر حقوقي» للأستاذ محمد الصديقي، وإن كان قد حقق الأهداف المتوخاة من منفعة وإفادة وفتح لأفق استمرار البحث والتأمل في العديد من القضايا الحقوقية والقانونية والسياسية ..إلخ فإنه مع ذلك يجعل شهية القارئ، منفتحة، لطلب المزيد، لذلك يمكن اعتبار هذا الكتاب مجرد مقدمة لمشروع أوسع.
ولي اليقين التام أن أذ. الصديقي له ما يكفي من الزاد العلمي والنزاهة الفكرية والموارد ليضطلع بذلك من أجل إعداد مشروع يرصد كل محتويات هذا الكتاب ويتوسع في مناقشة ما لم يستطع إثارته أو ما تناوله باقتضاب فرضته حيثيات وظروف إصداره الأول.