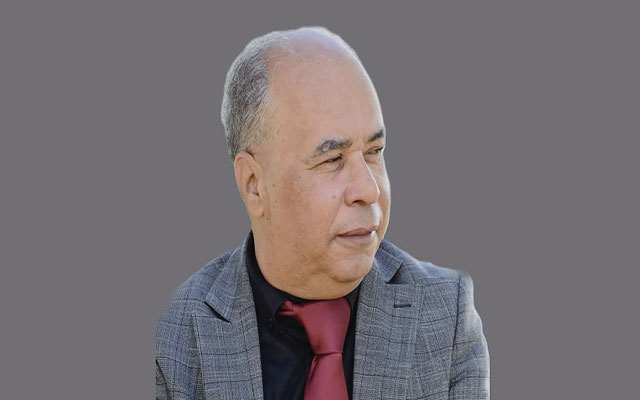إن موضوع مكانة مدونة الأسرة بين المبادئ الكونية والخصوصيات الوطنية، ينبغي أن يأخذ كل أبعاده في أي نقاش مجتمعي فيما يتعلق بحقوق الإنسان بصفة عامة، والحقوق النسائية بصفة خاصة. وسأركز أساسا على وضعية الأسرة التي تحتل مكانة متميزة في التنظيم الاجتماعي، بل أن جل الباحثين والباحثات يعتبرون أنها أصل المجتمع. ولهذا السبب حظيت بحماية خاصة تطورت مع مرور الزمن لتُشكل اليوم صرحا من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والنصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية، كما أنه يتم وضعها في صلب السياسة العامة للدولة والسياسات العمومية في مختلف القطاعات.
والملاحظ، هو أن اهتمام المنظمات الدولية والإقليمية بالموضوع، والمصادقة المتزايدة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أعطيا لمجال الأسرة مكانة متميزة. وهكذا تم الربط ما بين وضعية النساء ووضعية الأطفال والفتيات ووضعية الأسرة ككل. ويُضاف لذلك، أن المد الحقوقي المعاصر، زاد من ترسيخ مكانة الأسرة، أحيانا ككيان، وأحيانا أخرى كمجموعة أفراد مستقلين خاصة من خلال الاهتمام بوضعية المرأة أو الطفل. وهكذا، أصبح الحديث عن الحرية والمساواة وتكافؤ الفُرَص وعدم التمييز مسألة مألوفة في كل المجتمعات، لكن كثيرا ما تصطدم بالخصوصيات المحلية في بعض المجتمعات، والتي قد تحد من اعتمادها بالشكل المطلوب.
ففيما يتعلق بوضعية الأسرة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية؛ نُسجل في البداية أن الإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948، قد أشار في المادة 16 إلى حق التزوج وتأسيس أسرة، للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، واعتبرهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله، كما اعتبر أن الزواج لا ينعقد الا برضا الطرفين المزمع زواجهما زواجا كاملا لا إكراه فيه، ليخلص إلى أن "الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة".
وقد تم تأكيد هذه المقتضيات في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966، سواء في المادة الثالثة (3) حيث تم التنصيص على "تعهد الدول الأطراف بضمان مساواة الذكور والاناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد، أو من خلال المادة العاشرة (10) حيث تم التأكيد من جديد على "وجوب منح الأسرة، التي تشكل الخلية الطبيعية والسياسية في المجتمع، أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، وخصوصا لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعولهم...".
كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 نص على نفس المبادئ السابقة في المادة الثالثة (3) بخصوص التعهد "بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق السياسية والمدنية المنصوص عليها في العهد"، والمادة 23 بخصوص حق الأسرة في التمتع "بحماية المجتمع والدولة"، وضمان حق التزوج وتأسيس أسرة، وضرورة توفر عنصر الرضا الكامل...".
إن هذه المقتضيات لوحدها تدفعنا إلى التساؤل عن مدى انسجام التشريع الوطني مع الالتزام باتخاذ "التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله".
وإضافة لكل هذه المقتضيات، ينبغي استحضار مصادقة المغرب على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979، واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، ...
ورغم أن هذه الالتزامات الدولية لا يُمكن البحث عنها في مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957 لأنها أسبق من تاريخ المعاهدتين أعلاه، فإن تحليل مدونة الأسرة لسنة 2004 سيُمكننا من الوقوف على كيف تمت الملائمة بين الالتزامات الدولية والخصوصيات الوطنية.
أما فيما يتعلق بالخصوصيات الوطنية؛ نُشير إلى أنها تستند على مجموعة مبادئ تختلف درجات تناقضها مع الالتزامات الدولية حسب المواضيع التي يتم معالجتها. فإذا كان من غير الممكن هنا معالجة مختلف مظاهر المساواة في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإنني سأركز على مجال مدونة الأسرة المغربية، للوقوف على مظاهر المساواة التي تتلاءم مع التشريع الدولي، ومظاهر اللامساواة التي إما أنها لا تزال محل نقاش ويصعُبُ البت في الاختلاف حولها، أو أنه من غير الممكن معالجتها لتناقضها مع الخصوصيات الوطنية، وخاصة من ذلك مبادئ الشريعة الإسلامية.
إن الأمر يتعلق في البداية بمختلف التقاليد والعادات والأعراف التي تجد أصلها في الدين الإسلامي المتجذر في المجتمع المغربي. وقد دأبت مختلف الدساتير الوطنية تأكيد على كون "المملكة المغربية دولة إسلامية"، لذا، فإن أهم خصوصية ينبغي التركيز عليها بخصوص مدى قابلية المبادئ "الكونية" للتطبيق في مجال مدونة الأسرة، تتمثل وفق الفصل الأول من دستور 2011، في "الدين الإسلامي السمح" باعتباره أحد الثوابت الجامعة للأمة في حياتها العامة، والتي يسهر الملك بصفته أميرَ المؤمنين على تطبيقها، بل إن الدستور في الفصل 175 جعل "الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي" ضمن المجالات التي لا يجوز أن تتناولها المراجعة الدستورية إلى جانب كل من النظام الملكي للدولة، والاختيار الديمقراطي للأمة، والمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.
وقد أكد صاحب الجلالة، بصفته أميرا للمؤمنين هذا التوجه في خطابه التاريخي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية السابعة، والذي تم تضمينه في ديباجة مدونة الأسرة، حيث أكد حرصه على أن تستجيب الإصلاحات لمجموعة من المبادئ والمرجعيات، صرح بخصوصها على أنه (لا يمكنه بصفته أميرا للمؤمنين، أن يُحِل ما حرم الله ويُحَرم ما أحله". ولذلك لخ الخطوط العريضة لإصلاح المدونة في ما يلي؛
أولا؛ الأخذ بمقاصد الإسلام السمحة، في تكريم الإنسان والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف، وبوحدة المذهب المالكي والاجتهاد، الذي يجعل الإسلام صالحا لكل زمان ومكان، لوضع مدونة عصرية للأسرة، منسجمة مع روح ديننا الحنيف؛
ثانيا؛ عدم اعتبار المدونة قانونا للمرأة وحدها، بل مدونة للأسرة، أبا وأما وأطفالا، والحرص على أن تجمع بين رفع الحيف عن النساء، وحماية حقوق الأطفال، وصيانة كرامة الرجل".
وقد ترتب عن هذه التوجيهات الملكية، تضمين مدونة الأسرة للعديد من مظاهر المساواة.
وسنعالج في الجزء الثاني مظاهر المساواة واللامساواة في مدونة الأسرة وطرق معالجتها.
أصل المقالة: مداخلتي بعيون الساقية الحمراء بتاريخ 11 مارس 2023، في إطار ندوة للمعهد الدولي للدراسات الصحراوية
نزهة مزيان، دكتورة في الحقوق (وزارة العدل)